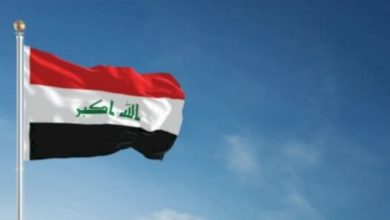مقدمة:
في 24 فبراير 2022، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “إطلاق عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا قال: “أنها تستهدف حماية الأمن القومي الروسي والدفاع عن الروس في شرق أوكرانيا، ووقف المزيد من توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) شرقًا”.
وقد دخلت الحرب مرحلة جديدة منذ إعلان موسكو بدء معركة دونباس في 19 إبريل 2022، وتركيز الجهد العسكري في مناطق الشرق والجنوب الأوكراني، وهو ما فُسر من قبل المراقبين على أنه محاولة من موسكو لإحراز نصر سريع يعوض حالة التعثر التي واجهتها خلال شهرين من المعارك على كل الأراضي الأوكرانية تقريبًا، وكانت نتائجها متواضعة على الصعيد الميداني. ومع استمرار الحرب، واقترابها من الثلاثة أشهر، بدأ بعض المحللين في طرح تساؤلات حول ما يمكن أن يحدث إذا لم يحقق أي من الطرفين ما يرغب في تحقيقه، بمعنى ألا تتمكن أوكرانيا – المدعومة سياسيًّا وعسكريًّا من الولايات المتحدة والحلفاء – من طرد القوات الروسية بالكامل من الأراضي التي استولت عليها منذ بدء العملية العسكرية، أو في المقابل، ألا تنجح روسيا في تحقيق هدفها الجيوسياسي الرئيس من تلك العملية.
في هذا السياق تشير تقديرات غربية أخيرة إلى أنه – آخذًا في الاعتبار الجوانب الجيوسياسية للصراع، وحقيقة هُوة عدم الثقة بين الجانبين، وصعوبة- بل واستحالة- قبول أي طرف بمطالب الآخر قبل تحقيق نصر واضح في المعركة- من غير المرجح أن تُحدث نتيجة سريعة حاسمة؛ فمن ناحية يجري تمكين أوكرانيا بدعم عسكري غير مسبوق، وبالتالي ليس لديها حافز لقبول وقف إطلاق النار، ومن ناحية أخرى من غير المرجح أن يرضى الرئيس بوتين بمعركة محصلتها سيطرة محدودة خارج المناطق المتنازع عليها بالفعل في شرق أوكرانيا، وهي حرب كلفت الجيش الروسي بالفعل ثمنًا باهظًا. وفي هذا الصدد تشير تقييمات إلى أن روسيا ربما تستعد دبلوماسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا لصراع طويل الأمد، لذلك من المرجح أن يكون القتال في دونباس وحشيًّا، لكنه لن يكون سريعًا، وقد لا يكون حاسمًا.
والواقع أنه لا توجد أي شواهد على إمكانية وقف الأعمال العدائية في المستقبل القريب، مع غياب أي خطط أو مبادرات لتحقيق ذلك، بالرغم من التداعيات الكارثية للحرب، ليس فقط في أوروبا بل وفي العالم أجمع إلى حد حديث رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، عن “كارثة إنسانية تلوح في الأفق” مع زيادة غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية تقدر بنحو 37% من أسعار المواد الغذائية، بعدما قطعت الحرب الإمدادات، لتدفع الملايين نحو الفقر مع زيادة سوء التغذية وانخفاض الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية للبلدان الأقل ثراءً.
ويمتد التأثير السياسي الأوسع والسلبي للحرب، مع استمرارها، ليشمل الدبلوماسية المتعددة الأطراف؛ فقد حذر أكثر من 200 مسؤول سابق “أنطونيو جوتيرش” أمين عام الأمم المتحدة من أن مستقبل المنظمة الدولية -كمنتدى عالمي معنيٍ بحفظ السلم والأمن الدوليين- في خطر، وأن مصداقية المؤسسات الدولية تتآكل، خاصة مع الفشل في وقف الحرب ودخول العالم على أبواب حرب باردة طويلة مع وجود قوات وقواعد دائمة للناتو على حدود روسيا، وزيادة الإنفاق الدفاعي بشكلٍ كبير وتسارع السباق النووي والحرب الإلكترونية والمعلوماتية التي لا تتوقف.
وفي خضم حال التوتر وعدم الاستقرار والاستقطاب التي خلقتها الحرب في أوروبا وحول العالم، يمكن رصد العديد من التغيرات والظواهر غير المسبوقة التي لم تألفها قواعد الاشتباك المتعارف عليها في المواجهات العسكرية بين الدول وما جرى عليه العمل في إطار الممارسات الدبلوماسية والعلاقات الدولية، بل وحتى قواعد الاشتباك المتعارف عليها في المواجهات العسكرية بين الدول.
أولًا: الحرب وقواعد الاشتباك:
تشير تقديرات غربية عديدة إلى أن الحرب في أوكرانيا تمثل ذروة جديدة في الاستخدام العلني للمعلومات الاستخباراتية من قبل الدول كأداة للسياسة الخارجية؛ من أجل التأثير على جدول الأعمال وتشكيل الرأي العام المحلي والأجنبي، وذلك من خلال الكشف عن نوايا الخصم وخططه الهجومية مما ساعد في خلق رواية متعاطفة، وحشد الدعم، والمشروعية لاتخاذ تدابير مؤلمة.
فقد كشفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وحتى حكومة أوكرانيا، عن معلومات استخباراتية وتقييمات حول نوايا روسيا وخططها قبل وفي أثناء الغزو، وتعتقد هذه التقديرات أن هذا الكشف والاستخدام العلني للمعلومات بلورت رواية تميز روسيا بوضوح على أنها الطرف المعتدي وأن أوكرانيا هي الضحية، وبالتالي ساهمت في تعزيز جبهة قوية وموحدة ضد روسيا. وعلى المستوي الإستراتيجي، لم يردع هذا الكشف المبكر النوايا الروسية للكرملين، وقد وصف كبار المسؤولين الأمريكيين، وفقًا للإعلام الأمريكي، حملة الكشف عن المعلومات الاستخباراتية التي شنتها الإدارة – ولاتزال – بأنها الأكثر عدوانية منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.
ووفقًا للخبراء بدأت الحملة منذ نوفمبر 2021 بتحذيرات أمريكية وأوكرانية بشأن نشر قوات الجيش الروسي خارج الحدود الشرقية لأوكرانيا، والاتجاهات المحتملة التي سينطلق منها الهجوم. وعلى المستوى التكتيكي، أشارت التقديرات إلى أن الكشف عن المعلومات الاستخباراتية ساعد على تقويض الثقة الروسية وتعطيل العمليات العسكرية والإعلامية الروسية، وفي الوقت نفسه وفّر الوقت لأوكرانيا.
على صعيد آخر، ومع بدء العملية العسكرية، لم تخف الولايات المتحدة والحلفاء في الناتو إعلان مضيها قدمًا في دعم حكومة كييف بكميات ضخمة من الأسلحة والمعدات العسكرية “الفتاكة” المتطورة، ذكرت أن أفراد القوات المسلحة الأوكرانية سبق وتدربت عليها في بعض دول الحلف منذ عام 2014، وواكب هذه التأكيدات، تأكيدات بأن قوات الحلف أو أي من دوله الأعضاء لن تحارب روسيا في أوكرانيا، باعتبار أن هذه الأخيرة ليست عضوًا في الحلف، وبالتالي لا تنطبق عليها أحكام المادة الخامسة من معاهدة واشنطن المنشئة للحلف، كما تبنى الجيش الأوكراني من ناحيته نظامًا أكثر تطورًا للقيادة والسيطرة وأنشأ فيلقًا محترفًا لضباط الصف على غرار الولايات المتحدة. وأخيرًا، وعلى الرغم من أن المدى الكامل لهذا التعاون غير معروف، إلا أن الأوكرانيين يتلقون معلومات استخباراتية واسعة النطاق وجاهزة للعمل من الولايات المتحدة وحلفاء الناتو لدعم دفاعهم ضد الروس.
أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فقد تجاهل العديد من السياسات طويلة الأمد تمامًا، حسبما أشار تقييم أعدته مجموعة الأزمات الدولية في إبريل 2022 حول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ارتباطًا بالحرب، ويشير التقييم إلى أن الاتحاد اتخذ خطوات كانت ستواجه معارضة قوية من مختلف الزوايا في الظروف العادية، وتشمل هذه القرارات: قيام الاتحاد الأوروبي بتمويل تسليم الأسلحة الفتاكة إلى بلد ثالثة لأول مرة، وتعزيز تعاونها الدفاعي في مواجهة تصورات التهديدات الجديدة، وإرسال إشارات – مختلطة إلى حد ما – للانفتاح على عضوية الاتحاد الأوروبي للجيران الشرقيين للتكتل بعد سنوات من إغلاق هذا الباب، وإطلاق التوجيه الخاص بالحماية المؤقتة لعام 2001، الذي يمنح الإقامة المؤقتة للاجئين الأوكرانيين.
ويوضح التقييم أن قرار الاتحاد الأوروبي باستخدام أموال صندوق الشراكة الأوربي (EPF)، والذي أُنشئ قبل عامٍ واحد فقط، لتمويل تسليم أسلحة ومعدات فتاكة إلى أوكرانيا يشكل واحدًا من التحولات الرئيسة في السياسة الخارجية التي أثارتها الحرب. ففي الأصل، لم يكن من المتوخى أن يكون الصندوق أداة للتدخل في الحروب واسعة النطاق، بل كوسيلة لمساعدة البلدان الشريكة على محاربة المتمردين أو الجماعات المسلحة الأخرى، وبالتالي فإن استخدامه في أوكرانيا يمثل المرة الأولى على الإطلاق التي يمول فيها الاتحاد الأوروبي إمدادات أسلحة إلى بلد ثالثة، ناهيك عن بلدٍ في حالة حرب.
ويعتقد تقييم مجموعة الأزمات أنه “ربما لو كانت الحكومات الأوروبية قد وافقت على حجم ردها وتمكنت من الإبلاغ عنه مسبقًا، لكان ذلك قد لعب على الأقل دورًا في حسابات الكرملين، على الرغم من أن مسألة ما إذا كان من الممكن أن يردع ذلك موسكو بالفعل، ليس بالأمر الواضح على الإطلاق، ولكن بعد الغزو، جاء رد الفعل على نطاق وسرعة نادرًا ما حدثت من قبل”.
والواقع أن الرئيس بوتين، في خطابه بمناسبة عيد النصر في 9 مايو 2022 حرص على التأكيد على ما كان قد أشار إليه في خطابه في 21 فبراير الماضي من أن هناك عملية بناء عسكري في أوكرانيا منذ عام 2014 وتواصل مباشر بين أوكرانيا والناتو، حيث قال “أكرر، لقد رأينا كيف يتم تطوير البنية التحية العسكرية؟ وكيف بدأ المئات من المستشارين الأجانب في العمل؟ وكانت هناك عمليات تسليم منتظمة لأحدث الأسلحة من دول الناتو، الخطر يتزايد يومًا بعد يوم”. وأضاف: “الناتو بدأ يزحف نحو أراضي جوار روسيا عسكريًّا، مقتربًا من حدودها، وكل الدلائل كانت توحي بأن الصدام مع النازيين الجدد أمر لا مفر منه، خاصة وأن روسيا سعت دائمًا إلى حوار نزيه وإلى أمن متساوٍ وغير قابل للتجزئة للجميع، لكن عبثًا فإن دول الناتو لم ترغب في سماعنا”.
وقد قدر خبراء غربيون أن هذه التعزيزات العسكرية الأمريكية المتزايدة ترسم صورة لحرب متصوَّرة مسبقًا، تُوفر فيها لأوكرانيا كل أنواع الأسلحة الضرورية لمواجهة سيناريوهات الهجمات المحتملة من روسيا، بما فيها المعركة الدائرة حاليًّا من أجل السيطرة على منطقة دونباس الشرقية، وهو ما يجري بالفعل من أواخر إبريل وبدايات مايو 2022 وحتى الآن.
ثانياً: الحرب الاقتصادية كأداة من أدوات السياسة الخارجية:
في تقدير العديد من الخبراء الغربيين – ومنهم “نيكولاس مولدر” الأستاذ بجامعة كورنيل ومؤلف كتاب “السلاح الاقتصادي: صعود العقوبات كأداة للحرب الحديثة” – فإن الحرب الروسية الأوكرانية هذا العام ليست مجرد حدث جيوسياسي كبير، ولكنها أيضًا نقطة تحول جيواقتصادية؛ فالعقوبات التي فرضت على روسيا خلال الأسابيع التي تلت إطلاق العملية العسكرية في 24 فبراير 2022 هي أقسى تدابير فرضت على الإطلاق ضد دولة بحجم روسيا وقوتها، فقد فصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها البنوك الروسية عن النظام المالي العالمي، وحظرت تصدير مكونات التكنولوجيا الفائقة بالتنسيق مع الحلفاء الآسيويين، واستولت على الأصول الخارجية للمئات من الأثرياء الروس، وألغت من جانبٍ واحد معاهدات تجارية مع موسكو، وقامت بحظر شركات الطيران الروسية من المجال الجوي لدول حلف الناتو، وقيدّت مبيعات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومنعت جميع الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الروسي من ولايتها القضائية، وجمدت نحو 403 مليار دولار من أصل 630 مليار دولار من الأصول الأجنبية للبنك المركزي الروسي.
وفي تقدير الخبراء، فإن “الاحتواء الاقتصادي الغربي لروسيا” مختلف، حيث يتعلق الأمر بحملة غير مسبوقة لعزل اقتصاد إحدى دول مجموعة العشرين، تمتلك قطاع هيدروكربون كبير، ومجمعًا صناعيًّا عسكريًّا متطورًا، وسلة متنوعة من صادرات السلع الأساسية. ونتيجة لذلك، تواجه العقوبات الغربية نوعًا مختلفًا من المشاكل، ويمكن أن تفشل الجزاءات ليس بسبب ضعفها، ولكن بسبب قوتها الكبيرة التي لا يمكن التنبؤ بها. ويضيف الخبراء في هذا الشأن أن صناع السياسات الغربيين ليس لديهم سوى خبرة وفهم محدودين لآثار العقوبات الهائلة التي فرضت على اقتصاد رئيسي مندمج عالميًّا، وأن أوجه الهشاشة القائمة في الهيكل الاقتصادي والمالي العالمي سوف يترتب عليها تداعيات سياسية ومادية خطيرة تتجاوز روسيا بكثير، وإن كانت هي البلد الأكثر معاناة منها؛ إذ تشير توقعات الاقتصاديين إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة (9-15%) على الأقل هذا العام، كما انخفض الروبل أكثر من الثلث منذ بداية يناير 2022 قبل أن يسترد خسائره بعد إعلان الرئيس بوتين عن تمسكه بأن تكون مدفوعات النفط والغاز الروسي بالروبل، اعتبارًا من أول إبريل 2022 وفقًا لآلية روسية صدرها البنك المركزي. ووفقًا لتقارير متعددة هناك نزوح جماعي للمهنيين الروس المهرة وانخفاض في القدرة على استيراد السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا القيمة بشكلٍ كبير، وكما قال المفكر السياسي الروسي “إيليا ما تفييف” فإن: “30 عامًا من التنمية الاقتصادية ألقيت في سلة المهملات”.
وتشير تقارير غربية عديدة إلى أن هذه الأرصدة الروسية الضخمة، سيتم الاستفادة منها في دفع تعويضات للضحايا وإعادة إعمار أوكرانيا.
ويشير الخبراء إلى أن هناك ما لا يقل عن أربعة أنواع مختلفة من الآثار الأوسع نطاقًا، والتي تتجاوز روسيا، وتشمل: الآثار غير المباشرة على البلدان والأسواق المجاورة، لا سيما اقتصادات آسيا الوسطى التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الروسي من خلال التجارة العمالة المهاجرة في روسيا، والآثار غير المباشرة المضاعفة من خلال سحب الاستثمارات من القطاع الخاص، وآثار التصعيد في شكل ردود روسية، والآثار النظامية على الاقتصاد العالمي.
وقد تسببت الآثار غير المباشرة بالفعل في اضطرابات في أسواق السلع الأساسية الدولية، ومع توالي حِزم العقوبات الغربية -بما في ذلك إخراجها من نظام “سويفت” وتجميد احتياطيات البنك المركزي – ارتفعت أسعار (النفط الخام، والغاز الطبيعي، والقمح، والنحاس، والنيكل، والألومنيوم، والأسمدة، والذهب)، وأيضًا لأن الحرب أغلقت الموانئ الأوكرانية.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد الدولي أن ما أحدثته العقوبات الاقتصادية ضد روسيا من اضطراب كبير في الاقتصاد العالمي، لم يكن متوقعًا، وأن أحد أسباب ذلك هو أن صانعي السياسات في الولايات المتحدة الأمريكية عادة ما يفرضون عقوبات ضد الاقتصادات المتواضعة والتي تتسم درجة اندماجها في الاقتصاد العالمي بالتواضع الشديد مثل: (كوريا الشمالية، وسوريا، وفنزويلّا، وميانمار، وبيلاروس)، وذلك على خلاف الاقتصاد الروسي. ويخلص خبراء من كل ذلك إلى القول بأن العالم ليس بعيدًا من فترة الكساد الأعظم التي نتجت عن استخدام العقوبات في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما فرضت عقوبات على (إيطاليا الفاشية، واليابان الإمبراطورية، وألمانيا النازية)، والتي طبقت من قبل عصبة الأمم بمشاركة 52 دولة.
ثالثاً: الحرب والقواعد الحاكمة للعلاقات الدبلوماسية:
بجانب الحرب الاقتصادية غير المسبوقة ضد روسيا كما سبقت الإشارة، انتقلت المواجهة مع الغرب إلى ما يمكن تسميته بـ(حرب دبلوماسية شرسة) شنتها الولايات المتحدة وحلفائها ليس فقط على الصعيد الثنائي ضد الدبلوماسيين الروس، حيث أصدرت سلسلة من القرارات بطرد الدبلوماسيين الروس، تجاوز عددهم في غضون أسابيع قليلة حوالي 350 دبلوماسي، من العاملين في بعثات روسيا المعتمدة لدى الولايات المتحدة ودول الحلفاء_ بل وأيضًا على الصعيد المتعدد الأطراف من خلال العمل على تعليق عضوية روسيا من منظمات ووكالات متخصصة.
- على صعيد الدبلوماسية الثنائية، تباينت المبررات التي أعلنتها كل دولة لطرد دبلوماسيين روس لديها، تجاوزت ظاهر النصوص ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتحدة للعلاقات الدبلوماسية المعتمدة في 18 إبريل / نيسان عام 1961، واتفاقية الأمم المتحدة للعلاقات القنصلية المعتمدة في 24 إبريل 1963، وكلاهما تضم تقريبًا جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وإذا كان المعروف أن قرار الإعلان عن المبعوث الدبلوماسي أو القنصلي “شخصًا غير مرغوب فيه” هو قرار سيادي للدول، لها كل الحق في عدم الإفصاح عن أسبابه، وفقًا لقواعد القانون الدولي العرفي كما قنَّنتها اتفاقيتا فيينا للعلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية_ إلا أن الأسباب التي أعلنت عنها بعض الدول كمبررات لطرد الدبلوماسيين الروس تعكس حالة من الهستيريا والرغبة في الإهانة والإذلال، كما تكشف عن عمل سياسي جماعي منسق، فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، غير مسبوق في العلاقات الدبلوماسية فيما بين الدول. وقد قصدت الدول الحليفة استخدام ما تردد حول وجود عمليات إبادة جماعية في بلدة بوتشا (قرب كييف)، والحملة الإعلامية الغربية المكثفة بتحميل روسيا المسؤولية عنها، حتى قبل إجراء تحقيقات بشأنها كذريعة لطرد الدبلوماسيين الروس، وهو أمر نفت موسكو صحته.
والملاحَظ أن الولايات المتحدة، وكل الحلفاء، وكذلك روسيا، وبالرغم من العمليات المتبادلة لطرد الدبلوماسيين لم تذهب أي دولة إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية.
- على الصعيد المتعدد الأطراف، سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تجميد عضوية أو طرد روسيا من المنظمات الدولية، وهو ما نجحت فيه فيما يتعلق بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة السياحة العالمية؛ حيث قامت روسيا بالانسحاب من الهيئتين الدوليتين، وجاء تعليق عضوية روسيا في المجلس بمسعى أمريكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانسحبت روسيا من المجلس في ذات التاريخ، معتبرة الخطوة “غير شرعية ومسيسة”.
واللافت أن مجموعة دول أوربا الشرقية في الأمم المتحدة تقدمت بترشيح أوكرانيا لشغل المقعد الشاغر بانسحاب روسيا، إلا أنه بعد مشاورات رؤى الدفع بجمهورية التشيك لشغل المنصب تجنبًا لصب المزيد من الزيت على النار.
وهناك تقارير موثقة عن حملة ضغوط مكثفة تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها لتجميد عضوية روسيا في بعض الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، مثل: (منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الغذاء العالمي)، بدعوى مسؤوليتها عن التداعيات الكارثية للحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي.
كذلك تمارس ضغوط غربية لتجميد عضوية روسيا في بعض التجمعات الدولية غير الرسمية مثل مجموعة العشرين.
وكان قد سبق ذلك، وبمجرد بدء الحرب، تجميد مشاركة روسيا في منظمة مجلس أوروبا والجمعية البرلمانية التابعة لها، وفي كافة الهيئات الرياضية الإقليمية والدولية مثل: الاتحاد الأوربي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بجانب حرمانها من المشاركة في كافة البطولات التي ينظمها الاتحادان. وامتدت الأعمال الانتقامية لتشمل المواطنين الروس الذين يشاركون في الألعاب الفردية مثل كرة المضرب(التنس) والفنانين والمبدعين الذين يعملون في الغرب.
رابعاً: الخروج على الأصول المتعارف عليها في العلاقات الدولية:
في تقدير بعض المراقبين، بما فيهم غربيون، كشف النزاع الأوكراني عن نمط التفكير السائد ليس فحسب في عددٍ كبير من المجتمعات الغربية بل وأيضًا في فكر بعض القادة في الغرب، وبعيدًا عن موجات الغضب والاستنكار من عملية التدخل الروسي في أوكرانيا، يُلاحظ الآتي بصفة خاصة:
- استهدف الغرب التأكيد على رسالة مفادها أن الدفاع عن أوكرانيا هو دفاع عن الديمقراطية الليبرالية في حد ذاتها، وهو ما يَعني أن دعم الطرف الآخر، أو حتى عدم إظهار الدعم لأوكرانيا، هو انحياز للاستبداد والسلطوية. وقد أتاحت الولايات المتحدة وحلفاؤها للنظام الأوكراني مساحة واسعة لدعم وإبراز هذه الرسالة، بوسائل متعددة لعل أبرزها إتاحة الفرصة للرئيس زيلينسكي لمخاطبة برلمانات الدول الغربية الحليفة، بما فيها البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، والتأكيد في كل مرة على أن منظومة القيم- التي يعتز بها الغرب كثيرًا- يجري الدفاع عنها والتضحية من أجلها بشجاعة في أوكرانيا. وفي هذا السياق يطالب الرئيس الأوكراني، باستمرار، بالمزيد من المعدات العسكرية وحث الدول المعنية على مضاعفة العقوبات وفرضها بصرامة وقطع جميع الروابط الاقتصادية والتجارية مع روسيا، وضمان عدم قدرتها على تجاوز العقوبات الحالية.
- في نفس هذا السياق، تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا هائلة على العديد من الدول في المناطق المختلفة لحملها على الإعلان على إدانة واضحة للعملية العسكرية الروسية والانضمام إلى الحرب الاقتصادية الغربية ضد روسيا، دون أي اعتبار للمبادئ الحاكمة للعلاقات بين الدول، لاسيما مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي، وحق كل دولة في التفاعل مع غيرها من الدول وفقًا لما تمليه عليه مصالحها وأمنها القومي. ويلاحظ في هذا السياق أن الولايات المتحدة كسرت العزلة الدبلوماسية التي فرضتها على بعض الدول لسنوات بدعوى انتهاكات حقوق الإنسان والفساد والاستبداد، مثل (فنزويلا)، وذلك بهدف تأمين إمدادات الطاقة لحلفائها وشركائها نتيجة للعقوبات المحتملة على قطاع النفط والغاز في روسيا.
- امتدت الضغوط الغربية والتصريحات الشاذة لتشمل قادة المعسكر الغربي، بعضهم ضد البعض الآخر، مثل التجادل الذي تم بين رئيس الوزراء البولندي والرئيس الفرنسي.
- إضافة إلى ما تقدم، لا تقتصر هذه الازدواجية والانتقائية من قبل الغرب على صناع السياسات في تلك الدول، وإنما امتد الأمر للتناول الإعلامي والتحليلي للحرب في أوكرانيا، في مناخ هيستيري سعى إلى الحشد والتعبئة ضد روسيا، حيث لمحّ بعض المراقبين والمراسلين الأوروبيين، في شرحهم لتطورات الحرب وبقدرٍ كبير من الاستعلاء والصفاقة، بأن النزاع في أوكرانيا صادم جدًا؛ لأنه يدور في أوروبا “المتحضرة”، وليس في دول “غير متحضرة” مثل: العراق وأفغانستان حيث “يحتدم القتال منذ عقود”.
والحال على ما تقدم، كان طبيعيًّا أن يبدي الرئيس الأوكراني إعجابه الواضح، بدولة إسرائيل، الذي تمنى أن تكون بلاده “إسرائيل كبيرة في أوروبا” شريطة أن يحصل على ما يكفي من الدعم العسكري الغربي لتحرير بلاده. وبطبيعة الحال، يعتقد زيلينسكى – كما الكثيرين في الغرب – أن إسرائيل دولة ديمقراطية تدافع عن “قيم العالم الحر”، مؤكدًا: “الديمقراطية شرط أساسي: دولة استبدادية في أوكرانيا أمر مستحيل”.
- في الإطار عاليه، رفض الرئيس زيلينسكي دخول نظيره الألماني كييف ضمن وفد من بعض رؤساء بلدان أوروبا الوسطى والشرقية لإظهار تضامنهم مع أوكرانيا، معلنًا عنه “شخصًا غير مرغوب فيه” على أساس أن ألمانيا لم تقدم ما يكفي من الدعم لبلاده وليست حازمة تجاه روسيا، وقد أدى ذلك إلى إعلان المستشار الألماني “أولاف شولتز” رفض زيارة كييف في الوقت الحالي.
وقد اضطر زيلينسكي إلى الإعلان مؤخرًا عن ترحيبه بالرئيس والمستشار الألمانيين بزيارة أوكرانيا.
- كشفت الحرب عورات أوروبا ارتباطًا بموضوع تعامل الاتحاد الأوروبي مع طالبي اللجوء، ووفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها في إطار الاتحاد، أو ما يسمى بـ(نظام دبلن)، تقع المسؤولية الأساسية عن اللاجئين على عاتق أول بلد يصلون إليه. وفي حالة اللاجئين من أوكرانيا، كانت (جمهورية التشيك، والمجر، وبولندا، وسلوفاكيا) هي الدول الرئيسة المسؤولة عن عرقلة إصلاح نظام دبلن في عام 2016، وبما يوزع المسؤولية بالتناسب بين أول بلد يصل إليه اللاجئ والدول الأخرى، والآن، وبعد أن أصبحت هذه الدول في عين العاصفة، أظهرت شعوبها تضامنًا استثنائيًّا مع اللاجئين الأوكرانيين، وحتى في المملكة المتحدة- التي تبنت دائمًا سياسات لجوء أكثر قسوة وتشدد من أي وقت مضى في أعقاب مغادرتها الاتحاد الأوروبي- عرض عشرات الآلاف من الأشخاص منازلهم على اللاجئين الأوكرانيين، ودفعوا الحكومة إلى تخفيف القيود المتشددة التي فرضتها عليهم، لا سيما التأشيرات في البداية.
غير أن هذه المشاهد تتناقض وبشكلٍ صارخ مع الطريقة التي استجاب بها الأوروبيون للاجئين من إفريقيا والشرق الأوسط في السنوات الأخيرة؛ إذ يواجه هؤلاء تحدي خطر الغرق، وفي حالة النجاة منه ينتظرهم الاحتجاز في معسكرات غير آدمية توطئة لترحليهم. وللتذكرة فقط كان الاتحاد الأوروبي قد وافق، في سبتمبر 2016، عبر خطة لإعادة توطين 160,000 لاجئ سوري سيتم نقلهم في جميع دول القارة من (إيطاليا، واليونان) اللتين رفضتا منحهم حق اللجوء، ومع ذلك رفضت (جمهورية التشيك، والمجر، وبولندا، وسلوفاكيا)، من بين دول أخرى، تنفيذ هذه الخطة، مصرة على أنها تنتهك سيادتها الوطنية.
والمخجل بالنسبة لبلد مثل بولندا التي يحكمها نظام يميني متطرف، استقبلت الأوكرانيين بأذرع مفتوحة، بينما هاجم حرسُ حدودها وبوحشية لاجئين من الشرق الأوسط عندما حاولوا العبور من بيلاروس العام الماضي.
والخلاصة: هي أن الحرب في أوكرانيا قد غيرت بالفعل وجه العالم على أصعدة مختلفة، حيث امتدت آثارها لتشمل جميع الدول، ومع تمسك كل طرف بمواقفه ورؤيته الخاصة لنفسه وللعالم ومكانته فيه، انقلبت المواجهة من عملية قصيرة إلى صراع طويل الأمد، خاصة نتيجة للمقاومة الأوكرانية المدعومة عسكريًّا من الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين الذين قاموا بتدريب الجيش الأوكراني منذ سنوات وتبادلوا معه المعلومات الاستخباراتية والحرب التكنولوجية.
في هذا السياق، باتت الحرب صراعًا روسيًّا غربيًّا على الأراضي الأوكرانية، وهو صراع يستدعي فيه الرئيس بوتين التاريخ، عندما أنشأت الولايات المتحدة وحلفاؤها في فترة ما بعد انتهاء الحرب الباردة نظامًا أمنيًّا في أوروبا يقوم على الدور المهيمن لواشنطن والموقع المركزي للناتو كأداة عسكرية وسياسية؛ لضمان الأمن الغربي ونظام ما بعد الحرب بقيادة الولايات المتحدة، ورغم إدراك هذه الأخيرة لحالة عدم رضا روسيا عن الوضع الذي وجدت نفسها فيه، إلا أنها فضلت تجاهلها تمامًا معتبرة روسيا قوة متراجعة أو مهزومة. وفي هذا السياق، عادة ما يُشار إلى بعض دروس التاريخ ومنها أنه إذا لم تدمج قوة كبيرة مهزومة في نظام ما بعد الحرب، فإنها ستبدأ – مع الوقت – في اتخاذ تدابير تهدف إلى تدمير ذلك النظام، أو على أقل تقدير محاولة تغييره.
ومن الواضح الآن أن الرئيس بوتين يقدر أنه يملك بعض الأدوات التي تمكنه من تغيير النظام الدولي الحالي، بالرغم من المخاطر الإستراتيجية لذلك، الذي يريده نظامًا متعدد الأقطاب.
في المقابل، يمارس حلف شمال الأطلسي ضغوطًا هائلة على روسيا في مختلف المجالات (السياسية، والاقتصادية، والمعرفية)، إلى جانب الحملة العسكرية، وبما يتجاوز ما جرى عليه العمل الدولي، بل والتصرف خارج الأطر والمعايير الحاكمة لبعض الآليات التي وفرها النظام الدولي ما بعد الحرب العالمية الثانية لتسوية المنازعات الدولية وإدارة الصراعات.
وحتى الآن، فشل الجانبان في تحقيق أهدافهما ومازالت الحرب مستمرة والضغوط الغربية مستمرة أيضًا، وتشير جميع التقديرات إلى أنه لا توجد مفاوضات جدية بين الجانبين لوقف الحرب مع تحديد أهداف واقعية جديدة، وآخذًا في الاعتبار ما يراه العديد من المراقبين الغربيين من إنجازات أوكرانية كبيرة في قتال الروس، يعتقد هؤلاء أن الناتو عمل، وما يزال يعمل على تشجيع أوكرانيا على مواصلة الحرب، رغم الخسائر الأوكرانية الفادحة، وما تزال الولايات المتحدة تضاعف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا، وهو ما يُبقي كل الاحتمالات مفتوحة فيما يتعلق بانتهاء الحرب وسيناريوهات المستقبل.