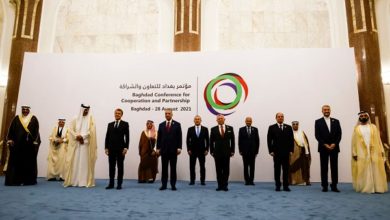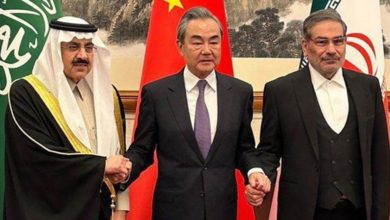تمهيد
تكشف متابعة الفكر الإيراني، خصوصا في القرنين التاسع عشر والعشرين أن تياراته تكاد تتماهى مع تيارات الفكر العربي، وأن القضايا المثارة نفسها كالنهضة والحداثة والعلمنة منثورة على الضفتين يتداولها من هنا وهناك مفكرون معروفون لدى الأمتين: فهل يمكن لمثقف عربي أن يجهل جمال الدين الأفغاني، أو لمثقف إيراني أن يجهل رفاعة الطهطاوي، أو لأي منهما أن يتجاهل محمد إقبال أو لا يتوقف عند المودودي وسيد قطب أو يتجاهل التناسب بين نواب صفوي وحسن البنا؟. بل يمكن ملاحظة التشابه الكبير بين رواد الفكر الحداثي الإيراني مثل (مالكولم خان) وبين رواد الفكر النهضوي العربي مثل (محمد عبده)، فالاثنان يبديان ترددا كبيرا إزاء قضايا الاستنارة والعلمنة. بل إن فهم مالكولم خان يكاد لا يفترق عن مفهوم محمد عبده للمستبد العادل، فكلاهما كان يطمح إلى تحقيق النهضة، وبلوغ التقدم لمجتمعه ولكن ثقل الموروث أعجزهما عن تبني المفاهيم الحديثة بوضوح من قبيل التنوير والعلمنة، فكانا يكتفيان بتوسيع أفق النص الإسلامي ليستوعب نوعا من العقلانية الكلية، من دون استعداد للحركة خارجه، أو ممارسة النقد التاريخي له.
وثمة أيضا تشابه في ظاهرة المفكرين الدينيين المنفتحين على الجانبين، بين مرتضى مطهري، تلميذ الخميني في الحوزة الشيعية، الأكثر اعتدالا منه، الذي سعى إلى التجديد في الفقه والكلام، داعيا إلى الاعتزال. وبين الشيخ علي عبد الرازق الذي دافع من تحت عباءة الأزهر عن الدولة المدنية بحرارة، نازعا عباءة الدين عن جسد الخلافة، معتبرا إياها مجرد شكل تاريخي للحكم لم ينبع من القرآن الكريم ولا تزكيه السنة النبوية، بل صاغته الحوادث، وتوارثته العصور. كما أستطيع رؤية وجه الفيلسوف الإيراني علي شريعتي وكتابه الأيقونة (العودة على الذات) وهو ينقب عن الشخصية الإيرانية في العصور الأكمينية، والساسانية، والصفوية، والقاجارية، مؤكدا على مركزية الهوية الإسلامية المتفتحة، وداعيا إلى التلاحم مع الثقافة العربية، في مرآة العبقري جمال حمدان، وكتابه الأثير “شخصية مصر” وهو يتجول في طبقات الحضارة: الفرعونية والقبطية، والعربية الإسلامية. بل إنني أكاد ألمح حتى ظاهرة المراجعات الفكرية التي قادت إلى تحول بعض مفكرينا عن مواقفهم الحداثية الراديكالية إلى مواقف أكثر اعتدالا في وجوه مثقفين إيرانيين. فالمفكر القومي العلماني، جلال آل أحمد الذي تحول إلى الموقف النقدي عبورا من الموقف التغريبي الذي هيمن عليه في مطلع حياته، إنما يستدعي بامتياز تجربة المفكر العربي زكي نجيب محمود الذي بدأ حياته الفكرية كداعية للوضعية المنطقية، باعتبارها مدخلا وحيدا للنهضة والحداثة، قبل أن ينتقل الرجل إلى الموقف التوفيقي متخليا عن التغريب الثقافي.
وهل الخميني أكثر من تكرار ناجح لسيد قطب؟. لقد حاول الأخير أن يبني دولة الحاكمية الإلهية، واصفا كل دولة مدنية بالجاهلية التي تعني لديه حاكمية الإنسان، داعيا المسلمين المعاصرين إلى الخروج على تلك المدن الجاهلية كما خرج المسلمون الأوائل على الوثنية العربية، محرضا الطليعة الأكثر طهرانية على قيادة هذا الخروج مثلما خرج الصحابة الكبار على الجاهلية المكية، وذلك قبل أن تتمكن منه الدولة الناصرية. أما الخميني فبدأ حياته (1902 ـ 1989) معتدلا ولم يتخذ المنحى الثوري في معارضة الشاه إلا منتصف الستينيات، متأثرا بقطب. وقد نجح الرجل في إقامة حكم ثيوقراطي، نيابة عن الإمام الثاني عشر (محمد الحسن العسكري)، مالك الحقيقتين الروحية والسياسية، واللتين آلتا إلى الولي الفقيه خروجا من حالة الانتظار التاريخي الطويل التي قننها مفهوم (الغيبة)، وهو الانتقال الذي نظَّر له الخميني نفسه في كتابه (في الحكومة الإسلامية) 1971م، قبل أن يشرع في تطبيقه بنجاح الثورة في فبراير 1979م.
أما محمد باقر الصدر، الشيعي العراقي، فيبدو نظيرا للسني أبي الأعلى المودودي خصوصا في المراوحة بين النص والتاريخ لتمجيد حال وتراث المسلمين. فعندما يتحدث الصدر، كمفكر ديني، يستدعي النص القرآني الذي يؤكد على العلاقة الحرة التي تربط الإنسان بالله، وهي حرية لا شك فيها، ولكنها تبقى محض تصور أنطولوجي لم يهبط يوما إلى عالم السياسة والواقع، فالحرية ممكنة في مواجهة الله نعم، كفرا وإيمانا، بنص القرآن الشاهق، لكنها غير متصورة في مواجهة أي حاكم مسلم، سني أو شيعي. وفي المقابل فهو يهدر التاريخ الذي يتحدث هو نفسه عن وقائعه ومآسيه، والذي شهد نكبات علي والحسين وتفجرت فيه الكربلائيات ونبتت مؤسسة التعزية وغير ذلك من قيم وأفكار تقليدية، لا نظنها أبدا انتصرت لحرية الإنسان بالمعنى السياسي، الذي اجتهدت الحداثة الغربية في تقنينه، من دون أن تنسب نفسها إلى المسيحية أو تدعي دورها في الدفاع عن الأخلاق، فيما ينسب هو إهدار الأخلاق إلى المسيحية وإقامة الحرية للحداثة الغربية. إنه عين ما قام به أبو الأعلى المودودي، فهو الآخر يستدعي الإسلام من النص مثبتا سموه، وهو في هذا محق، ولكنه يحاكم المسيحية أخلاقيا ليس بمعايير النص الإنجيلي ولكن بظواهر وممارسات الحداثة كتجربة تاريخية، وبالذات التيارات المادية فيها، وهو نزوع تلفيقي يجافي موضوعية المعرفة وحس النقد التاريخي، يصم تيارا واسعا في الفكر الإسلامي: العربي والإيراني.
منطق التجانس العربي ـ الإيراني
تمثل إيران، بحسب العلامة جمال حمدان، ظلا للعرب، أي الدائرة الملاصقة لهم والمحيطة بهم، من بين الشعوب والأعراق الإسلامية المختلفة، وذلك بفعل كثافة التداخل الثقافي (الديني والتاريخي) الذي انعكس على اللغة، حيث تركت اللغة العربية في نظيرتها الفارسية نحو 60% من مفردات الدراسات الإسلامية المستخدمة حتى اليوم، وحوالي 30% من مفردات اللغة بعامة، ناهيك عن استعارة الكتابة الفارسية للشكل العربي منذ بداية التفاعل بين اللغتين. يعني ذلك وجود شراكة حضارية بين الأمتين تجعل العلاقة بينهما أقرب إلى علاقة حبل سري تتجلى في أحد وجهين أساسيين:
أولهما ثقافي يربط أمة الدعوة الإسلامية (العرب) بأمة الإجابة (إيران). إنها العلاقة نفسها التي قامت تاريخيا بين اليونان (أمة الفلسفة والنظرية) وبين الرومان (أمة القانون والجمهورية). نعم فاق الرومان اليونان في القوة العسكرية والتمدد الجغرافي فتمكنوا من بناء الإمبراطورية وفرض السلام الروماني، ولكن بقي العالم اليوناني مركز احترام والفلسفة اليونانية مصدر إلهام، وقد صار الطرفان معا أحد جذرين أساسيين، مع الآخر (اليهو ـ مسيحى)، في تكوين الغرب الحديث.
وثانيهما استراتيجي يربط بين مركز غاز وإن تراجعت قوته نسبيا (العرب) وبين طرف مغزو ازداد ثقله تدريجيا (إيران)، وهي ذاتها علاقة أوروبا بالأميركتين تقريبا. فأوروبا اكتشفت العالم الجديد ولكن العالم الجديد صار أكبر ثقلا من أوروبا، خصوصا في حالة بريطانيا والولايات المتحدة. فالأولى تبقى الدولة الأم، أما الثانية فصارت هي الدولة القطب. الأولى مصدر إلهام والثانية مركز سيطرة. الأولى قوة ثقافية والثانية قوة إمبراطورية. وفي كلتا الحالتين، مرت العلاقة بين الطرفين بحالة صراع عسكري (حرب الاستقلال) قبل أن تستقر على قاعدة فهم عقلاني لحدود القوة وممكنات التجانس، وهذا ما يفترض أن يحدث بين العرب وإيران ولكن يقف حائلا دونه أمران أساسيان:
الأمر الأول هو غياب الرشد العقلاني الكامن في الحداثة، حيث تغيب الكفاءة في إدارة التناقضات وتعظيم التوافقات، سواء بحكم الاستبداد السياسي المهيمن على العالم العربي السني، والاستبداد الديني المهيمن على المجتمع الإيراني، المحكوم بحاصل جمع مفهومي: الولي الفقيه، وأم القرى. يستدعي مفهوم الولي الفقيه من الذاكرة التاريخية صورة البابا المعصوم (إنوسنت الثالث) في القرن الحادي عشر الميلادي، عندما أصدر في أكتوبر 1066م، وثيقة تنص على المبادئ الستة لعصمة البابا على النحو التالي: البابا هو الذي يضع القوانين الجديدة ـ كل أمراء الأرض يقبلون قدميه ـ البابا مقدس، لا يذنب ولا يأثم ـ ليس لأحد أن يحاكم البابا ـ إن كل فرد يحتمي بالبابا لا يمكن الحكم عليه ـ البابا لا يخطئ ولا يمكن أن يخطئ. فالولي الفقيه، باعتباره نائبا للإمام الغائب، مالك الحقيقتين الروحية والسياسية، يتمتع تقريبا بسلطات البابا، فالأخير معصوم غير قابل للخطأ، والأول مهيمن، غير قابل للمساءلة. أما مفهوم أم القرى فيستدعي من الواقع المشهود دولة الفاتيكان، كدولة دينية وقبلة روحية للعالم الكاثوليكي كله، ولكن ميزة الفاتيكان أنه دولة صغيرة، ليست لها مصالح سياسية ولا تناقضات استراتيجية مع أي طرف، بل فقط مجرد حدود جغرافية لفكرة روحية تصالحت مع العصر عندما اعترفت بالعلمانية في المجمع الفاتيكاني الثاني (1962 ـ 1965). أما إيران التي تعتبر نفسها (أم القرى) فلا يتوفر لها معالم القبلة الروحية الدينية، الموجودة أصلا في الحجاز لكافة المسلمين، بل وفي النجف وكربلاء لعموم الشيعة. وفي المقابل، تتوفر لها كل متطلبات الدولة القومية ذات المصالح الدنيوية السياسية والاستراتيجية، ومن ثم ينبع خطر اختلاط المصلحة القومية بدعاوى القبلة الروحية. ورغم أن التناقض المذهبي السني ـ الشيعي لم يبلغ من الحدة أبدا مستوى المسيحي: نظيره الكاثوليكي ـ البروتستانتي، إلا أنه استمر صراعا مزمنا، لا يزال حتى اللحظة الراهنة يدار بروح بدائية تفاقم من أعبائه.
والأمر الثاني هو فقدان الشعور بالجدارة التاريخية؛ ذلك أن الأمم في لحظات عجزها إزاء الآخر الحضاري (الغرب المسيحي) إنما تفقد ثقتها في ذاتها، وتصبح أكثر هشاشة نفسيا، وأقل استقلالية سلوكيا، ربما تتحدث عن أعدائها كثيرا ولكنها تتصرف عمليا كتابع، تنظر في عين الآخر النقيض قبل أن تتصرف إزاء الشريك والقريب. والحق أن العرب والإيرانيين يتعاملون بنفس المنطق مع بعضهما، إذ يتفاعلون من خلال الوسيط الغربي، وينظران إلى بعضهما عبر مرآته، ومن ثم يعجزان عن التعامل معا بثقة واستقلالية، يصبران على كل تناقض معه وكل ظلم يقع منه ولو كان كبيرا، فيما يبديان ضيق صدر ورغبة في الانتقام من بعضهما البعض على إثر كل تناقض ولو كان بسيطا، فكلاهما يحتقر الآخر في أعماقه، ولا يثق بنفسه، ويُعظِّم الغرب ويتنازل له ويتراجع أمامه، حيث يتعاضد هنا أثر ابن خلدون عن عقدة تقليد المنتصر والذوبان فيه، مع عقدة البراء من الحرج أمام المكافئ والنظير، فأمريكا قطب عالمي لا يثير التنازل أمامه حرجا سواء للعرب أو إيران، أما تنازل العربي لإيران أو العكس، فينال من الكرامة ويحرج الأنفس في ظل حالة التكافؤ المفترضة، وهي سمة نفسية خطيرة تفعل فعلها في الدول والأمم كما في الأفراد، على نحو يجعل من الإرث الحضاري المشترك عبئا على الواقع وليس حاملا له، يثير الحساسيات أكثر مما يوفر التلاحمات ويذكي التضامنات.
واقع التناقض العربي ـ الإيراني
يتنازع المنطقة العربية اليوم مشروعان إقليميان: أولهما يتمركز حول إسرائيل، والآخر حول إيران، يستند كلاهما إلى حالة الركود التي دخلها العالم العربي منذ تخلت مصر عن قيادته حضاريا نهاية السبعينيات، وحالة التيه الاستراتيجي الذي دخلها منذ الاحتلال العراقي للكويت بداية التسعينيات، قبل أن يتحول إلى منطقة فراغ مع احتلال بغداد قبل خمسة عشر عاما.
تستند إسرائيل في سعيها لتكريس مشروعها إلى الغرب كرصيد حضاري, وإلى استراتيجيات الهيمنة الأمريكية التي تندرج في سياقها بشكل كامل تقريبا، تستفيد منها بل تسعى على التأثير والتحكم أحيانا في مساراتها، مستفيدة من آصرة القربى المتمثلة في المسيحية الصهيونية، التي تتداخل في تشكيلها عوامل دينية وثقافية، تسمو بعلاقة البلدين على المصالح السياسية المتغيرة، لذلك لا نجد أبدا إدارة أمريكية اتخذت موقفا جذريا ضد إسرائيل، وأقصى ما تمكن رئيس أمريكي أن يذهب إليه هو تأييد تيار يساري معتدل (ما بعد صهيوني) ضد اليمين المتشدد (الصهيوني الجديد) داخل إسرائيل نفسها، بغية تحقيق مصلحتها الاستراتيجية العليا بعيدا عن شطحات المتطرفين وضيق أفقهم. أما إيران فلا ترتبط بمشاريع هيمنة عالمية، وحتى حليفيها الكبيرين روسيا والصين، فإن العلاقة معهما أساسها المصالح السياسية والاقتصادية، وليس لها جذور دينية أو ثقافية، بل إن روسيا كانت بمثابة العدو القومي لإيران معظم عقود القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين. نعم تبقى لإيران طموحات هيمنة إقليمية ولكنها طموحات غير مسندة دوليا، ومن ثم يمكن التحاور معها كدولة كبرى، لها حق المشاركة في قيادة الإقليم، بالطبع إذا ما تخلت عن مفهوم تصدير الثورة ولعبة شد الأطراف الشيعية الموالية لها.
تمتلك إسرائيل سلاحا نوويا بالفعل يدفعها إلى العربدة الإقليمية، لم يبذل العرب جهدا يذكر لنزعه منها بغض النظر عن إمكانية ذلك واقعيا, أما إيران فلا تملك سوى برنامج نووي سلمي، حتى الآن على الأقل، يبدي العرب معارضة شديدة له، خفية وظاهرة، رغم أن المنطق السياسي الحضاري، وكذلك الضوابط التقنية والملابسات الاستراتيجية لاستخدام السلاح النووي تفرض على العرب اتخاذ موقف عكسي، يعطي الأولوية لنووي إسرائيل وليس إيران.
تملك إسرائيل ميزة أساسية تتمثل في وجود إطار يُسمى بعملية التسوية، صار مُستهلكا وباليا وربما مذلا, لم يسفر عبر ربع القرن من المفاوضات والحوارات تلت أوسلو 1993م إلا عن مذبحتي “قانا 1″, و”قانا 2”, وأخيرا ضم القدس والجولان. إلا أنه يبقى قابلاً لأن يُحال إليه سلوكيات تبدو في الظاهر سياسية تنزع إلى تحقيق “السلام” وهي في الحقيقة لا تعبر إلا عن “غياب السياسة” ومحاولة تبرير الاستسلام الذي تجسده “صفقة القرن”. ويضاف إلى تلك الميزة أن هذا الإطار مشمول بالرعاية الأمريكية بل أصبح أقرب إلى محطة لـ “غسيل السياسات الداخلية” لدى دول المنطقة, فكل ما تختلف عليه مع الولايات المتحدة يمكن مبادلته بقبول أوسع للتصور الإسرائيلي, وكلما زادت التهديدات الإسرائيلية لدول المنطقة كلما زادت التنازلات للولايات المتحدة، على نحو شكل نزيفا أخلاقيا مستمرا للكتلة العربية أدى إلى ذبولها ثم تشققها أمام تيارات الإرهاب العدمي التي تجد في ذلك الخنوع أفضل دعاية لأطروحاتها. وفي المقابل لا تمتلك إيران مثل هذا الإطار، كما لا يحظى التفاعل معها بضمانة أمريكية، بل إنه محاط بصاعق سياسي لا يكاد أحد يقربه إلا وأصابه من الكوارث قدر جرأته أو غفلته.
وتكشف الوقائع الجارية عن مدى العجز العربي عن المناورة الخلاقة بين المشروعين، إذ يميل عموم العرب إلى التعامل بشدة مع إيران، وإلى التعاطي بمرونة مع إسرائيل. هذا الميل لا ينبع من مساحة أو عمق التناقض الحقيقي مع كلتيهما, وإلا لكان الأمر معكوسا، ففي ظل صعوبة مواجهة المشروعين معا، ولاختلاف عمق كل منهما وأهدافه، فإن البداية الصحيحة تقتضي تحييد المشروع الإيراني، والضرب على يد المشروع الإسرائيلي. تنبع مشروعية هذا الفهم من دواعي عدة أهمها: كثافة الأعراض الجانبية للصدام مع المشروع الإيراني، لأنه ينبع من المنطقة نفسها، يحوز وسائلها ويتحدث لغتها، ولذا فقد أثار حالة استقطاب داخل الساحة العربية بين تيار عام يبقى “محافظا”، وتيار ممانعة يصير أكثر فأكثر، “راديكاليا”، وهو الأمر الذي أجَّل ولا يزال يعطل كل محاولات الصياغة الاستراتيجية للفراغ السياسي متزايد الاتساع.
ومن ثم يقتضي الخروج من حالة الانقسام العربي ـ العربي، وواقع التناقض العربي ـ الإيراني، الدخول في حوار عربي ـ إيراني بنَّاء، نراه ضروريا جدا خروجا من محرقة الصراع المذهبي التي تجري وقائعها على الأرض العربية، حيث تتهدم فيه مدننا، ويُستنزف عمراننا، فالمؤسف أن إيران تحاربنا بالوكالة، وتقتلنا بأيدينا، وذلك عجز في السياسة العربية، لا يعوضه أعتى أنواع السلاح. لقد فقد العرب تقريبا دمشق وبغداد، عاصمتا الحضارة العربية لأكثر من سبعة قرون مجيدة، أعني دمشق وبغداد التاريخيتين، كمستودع للأثر والعراقة والحضارة السابقة على الإسلام واللاحقة له. قد نستطيع إعادة بنائهما من جديد، لكن شيئا ما سوف يغيب، رحل في الذاكرة والخيال وأظنه لن يعود، ولا نود أن نفقد أيضا صنعاء وبيروت، ولذا فالصمت إزاء ذلك الصراع يبقى خطأ كبيرا على الصعيد الاستراتيجي.
كما نراه ممكنا جدا، قابلا للنجاح تماما في ظل حالة التكافؤ بين الطرفين، ثقافيا واستراتيجيا، والتي لا مجال معها لعقدة نقص عربي. فمن منظور ثقافي يبقى العرب مصدر إلهام لإيران دينيا ولغويا، بل إن المذهب الإمامي، الاثني عشري إنما يرجع بكل رموزه إلى العنصر العربي من البيت الهاشمي القرشي. وحتى أغلب مزاراتهم المقدسة، الخاصة بهم، تقع في العراق حيث مراقد سبعة أئمة من الاثني عشر تقع بمدينتي النجف وكربلاء. ومن ثم فإيران التي يُنظر إليها على أنها مركز الثقل السياسي الشيعي كدولة، ليست هي القبلة الروحية للشيعة كمذهب، فهذه القبلة تبقى في العراق، والجغرافيا العربية. ومن منظور استراتيجي لا تملك إيران نصيبا وافرا من التفوق على جيرانها، فالسعودية ودول الخليج مجتمعة تكاد تملك ما يعادلها من قوة عسكرية، وتتفوق عليها في بعض مجالات التسليح، الجوي بالذات، خصوصا وهي بلد محاصر تماما منذ أكثر من عقدين، يعاني إنهاكا ماديا كبيرا، ويقتصر تسليحها على التكنولوجيا الروسية. أما مصر وحدها، ككتلة حيوية، وقدرة عسكرية، وخبرات قتالية فتعادل إيران وتزيد عنها، ما يعني أن محور الاعتدال العربي الممتد من مصر إلى الخليج يمثل وحده ضعف القوة الاستراتيجية الإيرانية، إذا ما أهملنا مؤقتا قدرة العرب المغاربة، وأسقطنا قدرات الهلال الخصيب المعطلة.
ولا يعني مبدأ الحوار التسليم بهيمنة إيران بل خوض مباراة سياسية معها، تستلزم وضع استراتيجيات طويلة وتتبنى تكتيكات عملية، وتتطلب إحياء مفاهيم الأمن الجماعي العربي، التي يفضي استعادتها إلى تغير أساسي في مسارات الصراع لصالح العرب، شرط أن يجري الحوار على أرضية السيادة الوطنية، ويفرض على إيران دعم الخيارات الإقليمية التي يتوافق العرب حولها، وأن تقدم لمحيطها الخليجي بالذات من الضمانات ما يكفي لطمأنته على أمنه واستقراره، ناهيك عن احترام الرؤية العربية لمستقبل العراق الموحد وللدور السني فيه. وفي المقابل يتعين على العرب أن يدعموا حقوقها العادلة في امتلاك التكنولوجية النووية أو، على الأقل، اتخاذ موقف الحياد الإيجابي إذا ما اختارت هي المواجهة مع الغرب فلا يسمحوا للولايات المتحدة بالهجوم عليها من الأرض العربية أو الزج بهم دعائيا وسياسيا في مخطط لحصارها.
استراتيجية عربية لتطويع إيران
ظني دائما أن مستقبل العرب رهن تحررهم، وأن مناعتهم الاستراتيجية رهن قدرتهم على ممارسة السياسة بالمعنى الحديث، وضمنها القدرة على بناء أنساق أمن إقليمية تملأ الفراغ المحيط بهم، بدلا من التعويل على القوى العظمى خارج الإقليم، ومن ثم لا يمكن القفز على دول الجوار الكبرى كإيران. ورغم أنه ليست لدي أية أوهام شخصية إزاء نظامها الحاكم، كونه نظاما ثيوقراطيا يعاند حركة الزمن، يعيش بعقلية القلعة ويتغذى على الحصار، ولكنني في الوقت نفسه لا أرى أية إمكانية لتغييره بالقوة من خارجه، فالضغط عليه يزيد من شرعيته في عيون جمهوره، وحصاره يديم بقاءه، ومن ثم فالخيار الممكن هو تطبيعه، عبر الحوار معه. قد يتصور البعض أن خروج إيران من كهف الحصار، سوف يطلق يدها في الإقليم، استكمالا لما هو قائم من اختراقات، متجاهلين حقيقة أن إيران قد بلغت أقصى درجات انتشارها وهي محاصرة، وأن ذلك الانتشار بات عبئا عليها، والأغلب أن تسعى إلى التخلص منه بمجرد خروجها من الحصار وهو ما نبرره بدوافع عدة:
أولها: أن الأمة المحاصرة، كالشخص المحاصر، يميل كلاهما إلى التطرف في إبراز المكونات الصلدة لهويته، فيبزغ التدين المتزمت لدى الشخص، وتنمو الأفكار الشوفينية لدى الأمة، كي تبقى على مشاعر الثقة بالذات، وعلى حال الاحتشاد لدى جماهير تحتاج إلى تبرير لحالها، يتعين على النخب تقديمه، في صورة أفكار مثالية وميتافيزيقية، وأحيانا في صورة مقولات استعلائية وعنصرية. وليس بعيدا عن هذا الفهم استخدام مصطلح الشيطان الأعظم لوصف الولايات المتحدة، باعتبارها مستودع الشر المطلق قياسا إلى الذات الإيرانية المشبعة بروح الخيرية المطلقة، في نوع من الاجترار للصراع المانوي التقليدي المستبطن للثقافة الفارسية، المتجذر في موروثها الديني الزرادشتي، بين إله الخير أهورا مازدا وإله الشر أهريمان. أما في مواجهة العالم العربي، الشريك العقدي في الإسلام، والرفيق التاريخي في حضارة الشرق الأدنى، وإذ يصعب التأكيد على ذلك الفصل بين شر مطلق، وخير مطلق، فقد تم توظيف الفصل المذهبي، وإعطاؤه نكهة ملحمية، تتغذى على ما يعتبره الوجدان الشيعي مظلومية تاريخية. فإذا ما كان الإسلام المذهبي المؤدلج سياسيا، الذي انحرف عن نمط التشيع العلوي إلى التشيع الصفوي وخلط بين الديني والقومي، وادعى بالحق في تصدير الثورة، هو الذي صنع تلك اللحظة المعتمة بقصر نظره الثقافي وانحرافاته الطائفية، فإن الخروج منها يفرض الخروج من كهف الإسلام السياسي بالمجمل إلى فضاء إسلام حضاري منفتح، يسمح بالاختلاف في إطار الوحدة، ويضع القربى الدينية فوق الاختلاف المذهبي، ويرى في القرب الجغرافي ركيزة للتشارك في المصالح وليس التصارع على الحدود، ومن ثم يبني على الإرث المشترك للحضارات الكبرى: الفرعونية والبابلية والفينيقية والفارسية. إنه الإسلام المتمدن الذي يرفض الإكراه على المذهب لأنه من الأصل لا إكراه في الدين.
وثانيها: أن غياب إيران عن أي إطار إقليمي، جعلها أقرب إلى “فاعل شبح” يطرح تأثيراته من داخل فضاء مظلم، يمنحه فرصة التخفي ويعفيه من عبء الحساب. فمن ناحية هي قوة موجودة في ثنايا الإقليم، فاعلة في مشاكله. ولكنها، من ناحية أخرى، غير مرئية بوضوح، ويصعب حسابها لأنها خارج أي نسق إقليمي، غير محاطة بنسيج تفاعلات محكم بحيث يمكن تحميلها أعباء سياستها غير الرشيدة. ما يعني أن إعادة إدماجها في البنيان الدولي أو النسق الإقليمي، يقيدها أكثر مما يطلق يدها في المنطقة، لأنه يرتب أثمانا يتوجب دفعها حال خروجها على التوافقات الجديدة، من عوامل نموها اقتصاديا، ومنسوب الثقة بها سياسيا، فمن أدوات العقاب الأساسية التهديد بدفعها خارج ذلك الإطار الإقليمي الذي تنضوي فيه، أو حرمانها من نسيج العلاقات الودي الذي يحيطها. ويمكن هنا سرد عشرات الحجج على أن الموقف الاستراتيجي الذي تمتعت به إيران طيلة العقود الأربعة الماضية بغيابها كـ “فاعل شبح”، يغيب عن أي إطار تمثيلي، فضلا عن قطيعتها مع مصر كانا أكثر عناصر نجاح سياستها في الحقبة المنصرمة على حساب العالم العربي، الأمر الذي يرجح كفة منهج الاحتواء على منهج المقاطعة.
والسؤال الجوهري هنا: لماذا لا يتم احتواء إيران في نسق إقليمي بدلا من مقاطعتها وإضاعة الوقت في مجرد رد الفعل على سياسات الدول الصغرى المرتبطة بها أو في كبح جماح الحركات السياسية والجماعات المذهبية التي تخضع لغرائزها، كحزب الله والحوثيين؟. أما الحديث عن ناتو عربي من الدول السنية بقيادة أمريكية، يحاصر إيران الشيعية كما كان الناتو الأوروبي يحاصر روسيا السوفيتية فيبقى بمثابة خطأ رهيب في الحساب السياسي والاستراتيجي، يكاد يبلغ حد العماء التاريخي الذي يذكرنا بلحظات سابقة كان السلاطين المسلمين يتقاتلون خلالها فيما بينهم والتتار والمغول على مشارف بغداد. أو كان الصليبيون يشنون الحملة إثر أخرى على الشمال العربي الممزق بين ولاة وأمراء لا يفهمون في شئون الحكم والاستراتيجية شيئا، بل يتصورون أن عدوهم سوف يشبع بهضم جيرانهم ثم يدير رأسه عنهم. أو كان الأمويون يتحالفون خلالها مع بيزنطة البعيدة عنهم في مواجهة العباسيين المجاورين لبيزنطة، فيما يتحالف العباسيون مع حكام الدول الإقليمية الناشئة في غرب أوروبا من رحم الإمبراطورية الرومانية المقدسة، ضد الأمويين في الأندلس. إنها اللحظات التي أدانها التاريخ اللاحق عليها حتى بتنا نشعر إزاءها بالعار، ولكننا في الوقت ذاته لا نخشى أن يصبح زماننا هذا لحظة عار جديدة مشابهة، تُخجل من سيأتون بعدنا.
وثالثها: حاجة الأجيال الإيرانية الجديدة للانفتاح على العالم، وهو الأمر الذي يفسر حال البهجة التي عمت الشارع، ودفعت الشباب للاحتفاء بعودة وزير الخارجية من لوزان بعد التوقيع المبدئي على الاتفاق النووي نهاية 2015م، ما يفرض على الملالي إعادة ضبط إيقاعاتهم، حفظا لتوازنهم في سياق واقع جديد أقل حماسا للأيديولوجية المغلقة، حتى لا يقع صدام مروع بين الجمهور وبين ولاية الفقيه. وهو المسعى الذي يمكن فهمه باعتباره تجسيدا عمليا للسنة التاريخية المألوفة عن طبيعة الاجتماع السياسي والقائلة بقوة دفع التجربة الواقعية نحو العقلانية السياسية حيث تكون الخيارات العملية استلهاما لضغوط الحياة اليومية، ومطالبات الواقع المعاش على شتى الأصعدة.
لقد عاش نظام الجمهورية الإسلامية أربعة عقود على قاعدة المذهب الإمامي الاثني عشري، بإلهام النزعة المهدوية، كنظام خلاصي ادعى القداسة الدينية تأميما لمفهوم السياسة الدنيوية، ومنعا للتنوع البشري الخلاق من أن يعكس نفسه في رؤى تتباين مع رؤيته، باعتبارها فعل الله الفاضل في التاريخ، والتي يتوجب على الفعل الإنساني الإذعان له والاحتشاد خلفه. غير أن التاريخ قد وشى لنا ولا يزال يؤكد على أن الأفكار ذات المنزع اليوتوبي لم تكن أبدا فاعلة في حركة سيره، وأن كل محاولات الخلاص خارج قوانينه لم تكن سوى هوامش على متنه، ومن ثم فقد بات يهمس في أذن الولي الفقيه بهذه الحقيقة، وفي حال سد الولي أذنه عنه، وضاق صدره به، فالأغلب أنه سيصرخ بها في البرية الإيرانية على مسمع من الجميع. وعندها سينمو الصراع حول المرجعية الدينية، لتصبح محلا للنقاش، على منوال ما جرى إبان الثورة الخضراء قبل عشر سنوات، أعقاب انتخابات 2009م، التي أوقعت دماء وطرحت أسئلة لم يجب عنها الملالي، بل تم قمعها بعنف، ولكنها لن تزول بل الأغلب أن تتجدد بجذرية أكبر وقدرة أعنف على التحدي. فالنظام الإيراني، ككل نظام مغلق، ينمو على العزلة، ويتغذى على مشاعر الخوف، ويتقوى بالحصار. فما أن ينتهي الخوف، ويتفكك الحصار حتى تتوالى الأسئلة، التي سرعان ما تتحول إلى مساءلة، تقود جميعها في النهاية إلى مطالب مشروعة لشعب عريق فعلا، له الحق في تقرير مستقبله والسيطرة على مصيره. وإذا كان الولي الفقيه قد تخلص من آفة انتظار الإمام الغائب، ليأخذ الزمن بيده، ويصنع التاريخ بنفسه، فالأغلب أن تنزع الأجيال الإيرانية الجديدة إلى الخلاص من آفة انتظار الولي الفقيه نفسه، لتأخذ حاضرها بيدها وتصنع مستقبلها على أعينها.