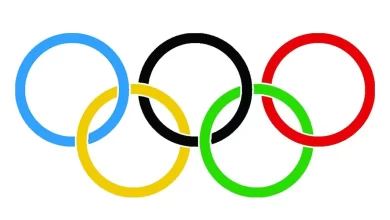تتأسس النزعة الإنسانية الملحدة على فهم جوهري يقول: “أن لا حرية إلا على حساب الألوهية، فلن يصبح الإنسان أبدًا كائنًا حرًا إلا إذا توارى الإله عن الكون، فعلى الإله أن يغيب كي يحضر الإنسان ويسيطر تمامًا على مصيره”. تربط الإنسانية الملحدة بين القيم النبيلة والغايات السامية والإنسان، فهو وحده مصدرها، اخترعها بإلهام خبراته وجسَّدها عبر مراحل تطوره بعيدًا عن أي قوة متعالية أو وحي متجاوز، فهي كنزه الذي يستحق التضحية لأجله خصوصًا من قبل العباقرة والأفذاذ، أبطال الإنسانية ومصدر وحيها الحقيقي، رواد الفكر والفلسفة والعلم، مبدعي الأدب والفن، السياسيين الكبار والعسكريين الأفذاذ، أولئك القادرون على الخروج من نفق تاريخهم الخاص الذي يدور في فلك العائلة والثروة، إلى أفق التاريخ العام بحثًا عن تحقيق خلاص حضاري داخل هذا العالم وليس في العالم الآخر- كما تفترض الأديان- وكذلك عن خلود تاريخي في تراثنا المدون ووعينا المتمدن، وليس عن جنة سماوية في أفق الغيب أو في قلب المجهول.
بلغت الإنسانية الملحدة ذروتها مع “نيتشه” صاحب البيان العدمي عن موت الإله، الذي لم يكن حقيقة من الأصل بل وهْم خلقه الإنسان وخلقه كي يبرر به ضعفه، ويُسقط عليه أوهامه، مؤكدًا في كتابيه الصاخبين “غسق الأوثان”، و “عدو المسيح”، على أن التعلق بالإله أو انتظار عنايته، لم يكن منذ البداية سوى خنوع وتضحية بالروح الإنساني والوجود الفردي وكل ما لدى الإنسان من حرية وكبرياء ويقين ذاتي، ومن ثم يقرر أن المسيحية لم تكن سوى وهم المسيح الذي لم يعرف الحياة أو يجربها حقيقة، وأنه لو عرفها لكان تجاوز أوهامه عنها، ومن ثم يطالب كل مسيحي بالتحرر من أوهامه حول المسيحية والمسيح. كما يطلب من عموم البشر أن يسترجعوا ذاتهم من ذلك الاستلاب الذي يشعرون به إزاء السماء، وأن يستمتعوا بالملذات ويتجنبوا الوقوع في قبضة الزهد الديني الذي يشل فعاليتهم، ولكن من الذي يستطع القيام بتلك المهمة؟ قطعًا ليس الإنسان العادي، الذي أفقده الجمود الطويل حيويته، وغرائزه الفعالة، بل الإنسان الجديد/ الفائق/ السوبرمان.
لا يتجاوز السوبرمان فقط إنسان المسيحية المغترب بل أيضًا الإنسان المتنور، وريث القيم الليبرالية كـ(التسامح، والمساواة، والعدالة)، وأخلاق العناية والمسؤولية التي تدعوا إلى الشفقة وحب الجار والخوف على الذات، والتي نظر نيتشه إليها جميعًا بارتياب شديد على أنها “أخلاقيات الراهبات المسيحية”، مجرد ستائر تغطي على حقيقة الضعف الإنساني وتعكس النقص العام في حيويته البيولوجية ومن ثم افتقاره إلى الثقة بالنفس. ومن ثم دعى نيتشه- بدلًا من تلك الأخلاقية التي تصنع تقدمًا زائفًا- إلى أخلاقية جديدة تتجاوز الخير والشر التقليديين، تناسب الإنسان الأعلى، الممتلئ بالثقة والشجاعة، القادر على اقتحام الزمن بحيويته الفياضة لاستعادة ماضي الحضارة الأوروبية الزاخر، سواء في صورته القريبة التي تتمثل لديه في عصر النهضة، أو البعيدة المتجذرة في العنصر الجرماني والحضارة اليونانية، حيث تأنسنت في الميثولوجيا اليونانية صورة الإله بأكثر الصور درامية، كما هو في “الإلياذة والأوديسا” خصوصًا في أسطورتي” بروميثيوس”، الذي تمكن من سرقة نار المعرفة من رب الأرباب زيوس وإهدائها إلى البشر؛ ليصنعوا بها مسيرة تقدمهم رغمًا عن إرادة الآلهة. و”أوديسيوس”، الذي تمكن بمعاون الآلهة الأخيار، من العودة سالمًا إلى بلدته أوديسا، ناجيًا من مصاعب وويلات فرضتها عليه آلهة الشر.
وجدت الإنسانية العلمانية تعضيدًا لها من قبل التيار الملحد في الفلسفة الوجودية، الذي تصاعد حضوره حوالي منتصف القرن العشرين على أيدي فلاسفة مثل (جان بول سارتر، وجابريل مارسيل، ومارتن هيدجر)، حيث صاغ الأخير مفهوم “الدازين”، أي الإنسان المفعول به، والذي هو مجرد “موجود – هناك”، ألقى به في العالم ليعاني الاغتراب في الواقع والقلق إزاء المصير، واعتبر أن من مقتضيات الوجود الحر أن ينتقل هذا الإنسان من كونه مجرد موجود هناك إلى حيث يمتلك زمام أمره ويحكم السيطرة على مصيره فيكون بمثابة “الموجود لأجل ذاته”، فعندها فقط يتوقف عن الإنصات إلى الناس وثرثرتهم، ويبدأ في إنتاج وعيه الخاص، ضمن صيرورة دائمة للتعلم يسميها هيدجر بـ “التصميم”، يتحرر بها الإنسان ممن يحيطون به، ويكتسب بها ذاته المتفردة وإرادته الحرة ويسعى إلى إثبات وجوده في الحياة؛ ليصبح فاعلًا ومؤثرًا فيها.
ومن جانبنا نؤيد هيدجر، مؤكدين على أن جميع الأعمال العظيمة: بطولة عسكرية، ثورة سياسية، إنجاز علمي أو فكري أو أدبي أو فني، وجود إرادة حرة تحفز الجهود الكبيرة المطلوبة لإنجازها، والتي دونها يصعب على الإنسان تحقيق أهدافه الكبرى أو بلوغ غاياته القصوى في الحياة. غير أننا، من جانب آخر، نؤكد على أن الإرادة الخلاقة والذات الحرة قد لا تكفيان لإنجاز الأعمال العظيمة التي تخدم البشرية كلها، كونها تحتاج إلى روحانية فائقة، أي أساس معنوي يدفع الفرد إلى الشعور بالمسؤولية عن مصير النوع كله، ويبرر له التضحية في سبيل البشرية بالوقت والجهد والمال؛ فكل أشكال التضحية الإنسانية لا يمكن أن تكون مقبولة إراديًّا إلا في سبيل معنى فائق يتجاوز الواقع اليومي والهم الدنيوي، ولذا فمن دون هذا الأساس المعنوي يصعب على الإنسان، ولو توافرت له القدرة، بذل جهد عائده ليس مضمونًا له ولا خاصًا به وقد لا يدركه أصلًا في حياته، بل لصالح الوطن أو الإنسانية؛ ذلك أن الذين يقومون بأعمالهم بعد دراسة جدوى تحسب العائد مقابل التكلفة، وتضبط معادلة المكاسب والخسائر، لا يقومون عادة سوى بالأعمال العادية في السياسة والحرب والعلم والفن. ولو أننا تصورنا عالمنا ماديًّا مسطحًا بلا أفقٍ سامٍ، يخلو من المُثُل والغايات والمبادئ العليا لكان سعينا الأساسي موجهًا نحو اللذات المباشرة كـ(الطعام، والشراب، والجنس)، فما مات منا الأبطال على مذبح الأوطان طلبًا لاستقلالها، أو نهض بيننا الثوار طلبًا لحريتنا فيها، فاستقلال الأوطان كحرية الإنسان، محض مفاهيم معنوية تلمسها الروح ويتذوقها الوجدان، ولا قام مبدعو العلم والفكر والأدب والفن بدورهم في تنوير البشر وتخليصهم من قبضة السلطات القامعة أو الآلهة المزيفة ولو دفعوا ثمنًا لذلك من جهدهم وأموالهم، وفي بعض الأحيان يكون الثمن هو حياتهم نفسها، فقد يموت أحدهم فقيرًا حزينًا من تجاهل معاصريه، لكن الشعور بالواجب يملأ كيانه ويمنح لوجوده معنى خاص به، كالمرأة التي تسعد بطفلها ولو ماتت عند ولادته؛ لأنها حققت من خلاله طبيعتها القصوى كأم منحت الخلق مولودًا جديدًا. قد تزداد صلابة هؤلاء بفعل الإعجاب الذي يكِنُّه الناس لهم، ولكن غياب الإعجاب لا يمنعهم من أداء واجبهم حتى لو غاب اليقين بشأن نتائجه: فهل كان الجنرال ديجول على يقين من انتصاره على حكومة فيشي والنازي معًا، ومن رئاسته للجمهورية الخامسة؟. أو كان جمال عبد الناصر ورفاقه من الضباط الأحرار على يقين من نجاح حركتهم ضد النظام الملكي والتاج البريطاني في الثالث والعشرين من يوليو إلى حد بلغت معه مستوى ثورة شاملة غيرت وجه الحياة في مصر؟. وهل كان “شوبنهاور” متأكدًا من أن عمله الأثير (العالم كفكرة وإرادة)، الذي قضى جل عمره في كتابته سوف يذيع بعد موته إلى درجة منحته الخلود ووضعه في زمرة الفلاسفة؟.
حسب هذا الفهم، نتحفظ على افتراض النزعة الإنسانية الإلحاد أساسًا لها، فكونها تندرج في سياق البحث عن معنى يبرر كافة أشكال التضحية، وتشترط تجاوز المحسوس، إنما تفترض الإيمان أكثر مما تفترض الإلحاد؛ لأن المعنى الفائق من أفق إنساني قريب قد يظل معرضًا للاهتزاز، قياسًا إلى معنى فائق بالمطلق، من أفق إلهي صلب. فمثلًا، يعكس مفهوم التصميم لدى “هيدجر”، إرادة الحرية التي تخلص الإنسان “الفرد” من سطوة الناس كجماعة بشرية ومحيط اجتماعي ضاغط، لكنه لا يضمن خلاصه من سطوة الطبيعة حيث تكمن الغرائز الأنانية والمشاعر القاسية، ولا من الهواجس الميتافيزيقية كالقلق إزاء الموت والعدم. وربما يفسر هذا ما نعرفه جميعًا من أن “هيدجر”- بعد أن صاغ مفهومه الأثير هذا- قد انصرف إلى تأييد النازية- إحدى أعتى النزعات الشمولية- التي نال في ظل حكمها أكبر سلطة أكاديمية على رأس جامعة برلين، بل مارس التحريض على مفكرين وأكاديميين آخرين، من بينهم تلميذته وحبيبته “حنا أرندت”، التي لم تسلم من شره، فلم يكن الرجل إذًا حرًا بالمعنى الجوهري، بل نفعيًّا أفضت النزعة المادية وما تنطوي عليه من تضيق لأفق وجوده الروحي_ إلى تغييب شعوره العميق بالواجب الأخلاقي، الذي كان “كانط” اعتبره أساسًا للتعالي والسمو، ومحورًا للإنسانية الحق.
النزعة الإنسانية الروحية:
في هذا السياق نرفض التصور الاختزالي الذي يضع النزعة الإنسانية، بمعنى الحرية والذاتية، في تناقض حتمي مع الإيمان، وكأن الألوهية مجرد سلطة عُليا أرضية( حاكم دنيوي يحد من حرية الإنسان)، وليست قوة خالقة تهيمن على الوجود بأسره، وتمنح للإنسان عنايتها ولو بشروط معينة، أو يجعل منها مجرد ترس في آلة إلحاد جل همها إنكار الحضور الإلهي في العالم والتمركز حول الإنسان بديلًا عنه. واعتقادنا الجوهري أن الحرية لا تتطلب الإلحاد بالضرورة، ولا التدين بحد ذاته، بل تحتاج إلى طلاقة الروح وصدقها، أن يكون الإنسان حرًا إلى درجة التمرد، صادقًا إلى درجة التجرد، وكلا المطلبين قد يتغذيان على التدين، إذ ما اقترن بذلك النوع العميق من الإيمان الذي يمنح صاحبه روحانية سامية، ورؤية شفافة للوجود لا تعتقلها غواية سلطان مستبد أو تحتبسها ضغوط المصلحة المباشرة، أو تقمعها تقاليد قطيع تردد المنقول كما يفعل جل السلفيين. وفي المقابل قد يتغذيان- تمرد الإنسان وتجرده- من الإلحاد شرط أن يكون من ذلك النوع الإنساني المهموم بحرية البشر ومصير الإنسان. وعلى هذا فإننا نقع في خطأ كبير إذا ربطنا الحرية والإنسانية والإبداع بضرورة الإلحاد، واعتبرناها قرينًا لمجرد غياب الإيمان؛ حيث يتبدى لنا عالم الألوهية الرحيب، كضمانة للتحرر من كتلة المادة الصلبة والتحليق في الفضاء الواسع؛ ليصبح ممكنًا السمو على الحس والإمعان في الخيال والإبداع، فالروح الصماء التي لا تدرك الروحانيات ويغيب عنها مفهوم الإيمان تختفي لديها جميع المفاهيم المعنوية التي تلهم وجودنا وتمنحنا المعنى وعلى رأسها (الحرية، والحب، والفن)؛ لأن اللغة الصماء التي تعجز عن فهم روحانية الإيمان هي نفسها التي تعجز عن توصيل مجازات الأدب وموسيقى الشعر وهمسات العشق. وفي المقابل، نخطئ إذا ربطنا الحرية بالدين، فعندها قد نواجه كهوف التدين المغلقة على كهنة الأديان، وهؤلاء من دون شك لا يستطيعون العيش إلا من خلال الوصاية، ومن ثم يسعون إلى تقييد الخيال وهجاء الحب والتعريض بالفن، واعتقال الحرية والذاتية والفردية خلف تراث المنقول والكلام المحفوظ كما يفعل أرباب الوعي السلفي، الذين لا الحديث في وجودهم أو معهم عن الحرية أو الإنسانية أو الإبداع، فهم لا يستوعبون عمق وثراء الوجود الإنساني الرحيب، ولا يفهمون مدى تعقيد التجربة التاريخية، بل ولا تجاربهم الذاتية نفسها.
بل إن النزعة الإنسانية نفسها تمثل أحد تجليات الحضور الإلهي في العالم، تلعب الدور المفترض أن يلعبه الإيمان، وتسعى إلى غاياته ذاتها ولو تحت مسميات علمانية، تنطق باسم العقل أو الإنسان، فليس هناك تناقض جوهري بين إيمان روحي يدعو إلى المساواة والمحبة البشرية، وبين نزعة إنسانية تخلص لجماع القيم النبيلة وتخلو من آفات الغرور البشري، وعقد التفوق العنصري، بل أرى تنافسًا شكليًّا يغطي على تكامل جوهري، فالإيمان الخالي من الكهانة يطلب التسامي الروحي باسم الله، والنزعة الإنسانية البريئة من العنصرية تطلب التسامي ذاته باسم الإنسان. ولأن الخالق العظيم يريد للإنسان سموًا ورفعة في كل الأحوال وبكافة الأشكال، فلعله لا يستنكر أدوار مبدعين ومفكرين ومصلحين وأبطال يلعبون في حياة البشر دور أنبياء العقل المكمل لعمل أنبياء الوحي. ومن ثم ندعي بأن النزعة الإنسانية الراقية تلعب دور الآلية العملية في خدمة الألوهية الحق؛ طلبًا لخير الجميع من الطائعين والعصاة معًا، إنه نفس الدور مثلًا، الذي تلعبه اللائحة التفسيرية في خدمة قانون عام، إذ تمد المبدأ النظري بالحمولة الواقعية وتمنحه القدرة على التغلغل في الأعماق والتفاصيل؛ تلبية لمتطلبات التحول والتغير.
المفارقة التي قد تربك البعض هنا، تكمن في وجود ملحدين أعمق فضيلة وأكثر تساميًا من متدينين كثيرين تدنست أرواحهم بالقسوة والعنف. ورغم أن الملحدين ليسوا جميعًا فاضلين، بل منهم سوقيون وأوغاد، يبقى تفسير المفارقة واجبًا. والبادي لنا أن أولئك الملحدين الفاضلين مؤمنون جوهريًّا بالقيم الدينية، خصوصًا التوحيدية حيث الإنسان مخلوق على صورة الله، يسعى إلى التشبه به ومقاربة بعض أوجه كماله، ولهذا يطلبون الرفعة والصلاح لغيرهم مثلما يطلبونه لأنفسهم، وإن جهلَ الكثيرون من بينهم مصدر قيمهم بعد أن تمت علمنتها وصارت قيمًا تنويرية أو مُثلًا إنسانية كـ(المساواة، والعدالة، والمحبة، وإنكار الذات). أما المتدينون غير الفاضلين، فبشر دنيويون حاولوا توظيف ممكنات التسامي (الديني) المتاحة أمامهم في خدمة غرائزهم، ولهذا فإنهم لا ينشدون صلاح غيرهم بقدر ما ينشدون بناء طبقية دينية يحتلون فيها مواقع أعلى من غيرهم، تمنح لهم حق الوصاية عليهم.
هكذا يتبدَّى الجذر الروحي العميق للنزعة الإنسانية، ويصبح الانتصار للإنسان ككائن حر بمثابة مطلب أخلاقي يمكن نسبته إلى الله وغاياته في الوجود بالقدر ذاته الذي يمكن نسبته إلى العقل المستنير، بل إن الجسارة الإنسانية في الفلسفة الحديثة إنما تستند إلى الله جوهريًّا إما (صراحةً) وبشكلٍ واعٍ كما ذهب ديكارت، الذي أثبت وجود الذات الإلهية المطلقة بطريقته المثالية، ثم عاد ليؤكد وجود ذات واعية ومفكرة، استنادًا إلى الذات الإلهية كجوهر يميز الإنسان عن غيره من الكائنات، يشترك فيه كل أعضاء الجنس البشري رغم اختلافاتهم الفرعية، وذلك هو أساس النزعة الإنسانية وما يتفرع عنها من منظومة حقوق أساسية لكل شخص، فقط لمجرد كونه إنسانًا كـ(حق الحياة، والحرية، والتفكير، والتعبير، والضمير، والاعتقاد،.. إلخ)، أو ضمنًا وبشكلٍ مضمر حسبما سيفعل “فيورباخ”، الذي استغنى عن الله لصالح إنسان فائق السمو، يكاد يملك مواصفات الإله، لكنه لم يبلغ ذروة تقديره للإنسان إلا بقياسه على معيار الألوهية، فعلى عكس ديكارت الذي رأى الله مصدرًا حقيقيًّا لكل القيم السامية، تصور فيورباخ أنه الله ، كان كذلك لا على وجه الحقيقة بل بفعل التوهم الإنساني عن الإله! أي أنه وصل من طريق عكسي إلى نفس الموقف الديكارتي، حيث الألوهية بمثابة المرجعية الأسمى للنزعة الإنسانية، صراحة أو ضمنًا.
قد يحاججنا أرباب الإنسانية العلمانية: ما جدوى الروحانية الدينية طالما انطوت النزعة الإنسانية على كل ما توصلت إليه الخبرة التاريخية من قيم فاضلة، وما تطلع إليه الناس من مُثُل عليا، تستحق التضحية لأجلها؟. وجوابنا: أن الإنسانية العلمانية لا تكفي وحدها لحل مشكل الأنسنة وذلك لسببين رئيسين: أولهما، إنها نفسها لا تعدو أن تكون ظلًا لإيمان توحيدي عميق يؤكد على وحدة الإنسانية، وإن اختفى خلف المفاهيم التنويرية، فكون النزعة الإنسانية مفهومًا ميتافيزيقيًّا، يجسد ليس فقط مجموع الناس الذين يعيشون بالفعل معنا وبيننا، بل ينطوي على الماضي والحاضر والمستقبل، إنما يستند إلى فهمنا الميتافيزيقي للسرمدية الإلهية. وثانيهما، إنها بمثابة روحانية للذات الأرستقراطية، التي تجتمع لها المعرفة مع الإرادة وتلك الذات لا تتوفر سوى للقليلين، كالفنانين ذوي الإلهام، والفلاسفة الكبار، والعلماء البارزين، والأبطال الفاتحين الذين يثقون أو يأملون في إمكانية أن يتوقف التاريخ عندهم، فيما يوفر الإيمان الروحي نزعة إنسانية تتسع لعموم المتدينين، العاديين أو البسطاء الذين يواجهون مصاعب يومية أو يتحملون مسؤوليات كبيرة، ويحتاجون في مواجهتها إلى طاقة روحية، لن يجدوها غالبًا سوى في الإيمان الديني المبرأ من التسييس والكهانة والخرافة.
والأغلب أن هذا الفهم مثل التربة التي نبتت فيها نزعة إنسانية روحية، من إنسانية روحية، انطلقت خصوصًا من النزعة الرومانسية، كاحتجاج هادئ على الإفراط في العقلانية التنويرية إلى حد جعلها شبه ديانة تطالب بتقديس العقل. بدأت الرومانسية كنزعة فلسفية لدى روسو في كتابه الرائد “أصل التفاوت”، الذي مجَّد فيه حالة الطبيعة، وذمَّ الملكية الخاصة التي أفسدت العالم وغذت الشر وعدم المساواة، لكنها سرعان ما امتدت إلى الفكر والأدب خصوصًا لدى الشعراء والأدباء الإنجليز الكبار: بيرسي شيلي، وجون كيتس، وبايرون، وألفريد تنيسون خصوصًا في قصيدته (للذكرى) 1850م، وتوماس إليوت في صيحته المدوية (الأرض الخراب)، وأخيرًا تشارلز ديكنز في (أوقات عصيبة) 1854م، التي صورت المدينة الصناعية الجديدة باعتبارها الجحيم الأرضي المدمر للنزعة الفردية.
الأنسنة في الفكر العربي:
كان لهذه النزعة أصداؤها في الأدب العربي لدى إبراهيم ناجي والشعراء الرومانسيين خصوصًا في مدرستي (أبولو، والديوان)، وكذلك في الفكر العربي لدي مفكرين بارزين كالمصري عثمان أمين في فلسفته عن “الجوانية” كنزعة وجودية روحية تمثل لديه: “أصول عقيدة وفلسفة ثورة”، ويردها إلى قوله تعالى: “لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”، وإلى الحديث النبوي الذي يقرر أن “لكل إنسان جوانيًّا وبرانيًّا”. فالآية والحديث برأيه ينطلقان من الإنسان ويرسمان صورة لحياته وقد استطاع بجهد باطني موصول أن يقيم توازنًا بين الحياة الروحية والحياة الدنيوية، تنطوي الجوانية على ما يسميه أمين “ميتافيزيقيًّا الرؤية الواعية” أي “رؤية روحية ندركها بعين البصيرة الداخلية” كما يقول الإمام الغزالي أو “بعيون الروح” كما يقول أفلاطون، “رؤية تسجل لحظات الإلهام التي تتجلى فيها الحكمة والتجربة والرؤية الإنسانية”، كما يذهب الرواقيون. رؤية وجودية بامتياز، تصالح بين الروحانية والحرية، الركيزتين الأكثر قدرة على تحقيق التكامل الإنساني.
وكذلك المغربي عزيز الحبابي في كتابه “الشخصانية الإسلامية”، الذي حاول فيه اكتشاف الذات المسلمة الحرة في مفهوم التوحيد نفسه، فالذي يشهد بوحدانية الله يؤكد- في نفس الوقت- على فردانيته كوحدة مخلوقة لله، نسخة من صنع الله، ولكنها نسخة فريدة؛ إذ يُشبِّه العالم الإنساني بكتاب عظيم غير متناهٍ، كل شخص فيه بمثابة ورقة، تتجاذب أوراقه وتتكامل برغم اختلافها واستقلالها، ومن ثم يؤكد على أننا نحيا الشعور بوجود الله، وأن ذلك الشعور يحيا فينا ومن هذه المعاناة الشخصية الوجودية يمكننا أن نميز الله الحق عن آلهة الزور، وأن نقر بأن “لا إله إلا الله”، ومن ثم يولد الضمير الحر الذي يجسد حضور الله فينا. هنا تصبح نقطة البداية في الإيمان هي الاستبطان، الشهادة الحية المنبثقة من أعماق الإنسان، فتلك الشهادة هي الأساس وليس الشعائر الدينية التي لا تبرهن على وجود إيمان ولا تقود إليه وإن كانت توفر له المناسبات التي يشعر فيها المؤمن بأنه أمام الله أو في حضوره. ومن ثم يرفض الحبابي روح التقليد الذي يعكس وصاية السابقين على اللاحقين، فمثلما اختفت في الإسلام مفاهيم الخطيئة والخلاص والفداء تحت مطرقة التوحيد لابد وأن يختفي التقليد والنقل لحساب الإبداع تحت مطرقة الاجتهاد، ومن ثم يصبح “الاجتهاد” و “التوحيد” بمثابة التوتر الأساسي في الإسلام، المحور الرابط بين العقيدة والفكر.
لكن يظل عباس محمود العقاد، بكتاباته الفكرية وميوله الأدبية وتجربته الحياتية، بمثابة التجسيد الأبرز للنزعة الإنسانية في الثقافة العربية. لقد كان معجبًا بـ”جوته”، كما تأثر بـ”روسو” وتصوره التنويري المتفائل حيال الطبيعة الإنسانية، فالإنسان لدى روسو “قابل للكمال عبر التربية والتعليم”، ولدى العقاد “كائن عاقل وحر وإيجابي، مشغول بالعالم، قادر على تغييره للأفضل، لكنه يظل مستخلَفًا عليه وليس حاكمًا له”. في كتابه الأثير “الله”، سعى العقاد الرجل إلى اكتشاف الحضور الإيجابي للإنسان في جل الثقافات والأديان السابقة على الإسلام (سماوية أو وضعية). أما في كتابه الأثير الآخر “الإنسان في القرآن” فيعيد اكتشاف مفهوم الاستخلاف القرآني الذي يجعل من المسلم ذاتًا فردية لا تذوب في الطبيعة كما تصورت الأديان الآسيوية خصوصًا (البرهمية، والبوذية)، بل تظل فوقها تسمو على قوانين الضرورة بملكة الإرادة الحرة، وكذلك مخلوقًا عاقلًا له ضمير مسؤول يحاسب على فعله، ويستطيع تحقيق خلاصه الفردي بالإيمان والأعمال بعيدًا عن مفهومي (الخطيئة الأصلية، والمخلص)، اللذين يذيبانه في الكنيسة باعتبارها جسد المسيح؛ ليبقى مالكًا “حريته”، مهيمنًا على مصيره، مستحقًا بجدارة لوظيفة “الاستخلاف”.
أما في سلسلة “العبقريات” فيبدو متأثرًا بالرومانسية الإنجليزية الحكيمة، خصوصًا بالمفكر “توماس كارليل”، وكتابه “الأبطال” الذي مجد فيه عشرة نماذج مختلفة للبطولة، من بينها نموذج النبي الذي اختار له نبينا الكريم “محمد”، وكأنه يشير على العقاد بكتاب “عبقرية محمد”، وما تلاها من عبقريات صحابته الأفذاذ (أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلى بن أبي طالب، وخالد بن الوليد)، فضلًا عن عبقرية (المسيح، وسعد زغلول، ومحمد على جناح مؤسس باكستان). لقد عوَّل العقاد على مفهوم “البطولة” كإطار يمكن للذات الفردية من خلاله أن تضع بصمتها على التاريخ، ممسكًا بالملامح المتفردة والمكونات النفسية التي صاغت شخصية هؤلاء الأبطال وألهمت وجدانهم وحفَّزت تضحياتهم الكبيرة. وهنا يستدعي الرجل ثلاثية النفس والعقل والروح من الفكر اليوناني الكلاسيكي؛ ليفسر كيفية تفاعلها داخل الشخصية الإنسانية، حيث تزدهر وتتحرك نحو البطولة حينما تسيطر الروح الموصولة بالإله- الروح الكلي للوجود- على العقل الذي يمثل طريق الإنسان إلى المعرفة ولكن المحدودة بعالم الطبيعة المشهود دون الغيب، كما يسيطر العقل على النفس الموصولة بالجسد ورغباته وغرائزه. أما سيطرة الغريزة على العقل فتشد الإنسان إلى الوجود الحيواني وتنهي نوازعه البطولية، مثلما تشده سيطرة العقل على الروح إلى وهم المعرفة اليقينية بالكون والوجود، وليس فقط بالظواهر الطبيعية الملموسة، وهنا تنشط ميوله البطولية ولكن في اتجاه إلحادي يصاحب الغرور العلمي.
عبر تلك العدة المفاهيمية، ناهيك عن شخصيته المتمردة والبطولية، اكتشف العقاد ما لم يكتشفه أي من فقهاء التقليد الإسلامي الذين أطنبوا في الحديث عن سير هؤلاء الأبطال وصفيًّا، أو الكتاب الإسلاميين الذين حاولوا توظيفها أيديولوجيًّا؛ ذلك أن الكشف عن جوانب التفرد لدى الآخرين يحتاج إلى تحرر الذات المكتشفة من الاعتقادات الشائعة والمسلمات السائدة، إذ لا يستطيع إنسان كشف أبعاد لا يوجد ما يضاهيها لديه. وقد عجز التقليديون والمتأسلمون عن إدراك جوانب التفرد لدى أبطال عقيدتهم لأنهم لا يملكون ما يوازيها، وحتى لو امتلك أحدهم فطريًّا بعضًا منها، فإن نمط التعليم الذي يتعرض له يقوم بطمسه؛ لأنه يتأسس على قواعد مدرسية تعلم الناس كيف يكونون حواريين وأتباعًا لا متمردين وأحرارًا، وهو أمر يتناسب مع طموح شيوخ التقليد وأمراء الجماعات إلى تشكيل عقلية قطيع يسهل تحريكها في الاتجاه الذي يريدون.
أما العقاد فكان ذا وجدان متفرد وشخصية متمردة، لم يتورع عن سب الذات الملكية دفاعًا عن الدستور ودخول السجن لمدة تسعة أشهر كاملة، لم تفقده شجاعة روحه، بل زادته شراسة في الدفاع عن الحرية. لم يستند تمرده إلى غرور إنساني يفترض الإلحاد طلبًا للحرية كما تفترض الإنسانية العلمانية، بل إلى نوع عميق ورهيف من الإيمان، يشبه روحانية الحدس الصوفي، يمنح صاحبه الشعور بالثقة والجدارة والقدرة على التحرر. إنه الإيمان الذي يشعر معه الفرد بذاته شعورًا قويًّا عميقًا، يوازي شعوره بأن الله يسكنه، مدركًا المغزى العميق للحديث القدسي القائل بأن أهل السماء والأرض، ولو اجتمعوا، لا يستطيعون أن يضروه أو ينفعوه بشيء لم يكتبه الله له أو عليه، ولعل هذا المغزى يمثل صلب النزعة الإنسانية الروحية؛ حيث الشجاعة القصوى في مجابهة الوجود المطلق، إذ يكشف لنا عن كيف يكون المؤمنون الصادقون أحرارًا كبارًا، لا يبررون ولا ينافقون؟ وكيف تصير الألوهية قوة تحرر للوجدان لا سلطة وصاية على الضمير؟ كما يؤكد لنا على أن الألوهية التي تعاند الحرية ليست إلا تأويلًا زائفًا لعقول بائسة عجزت عن النهوض بمسؤولية الخلافة الأرضية، أو رأت في الكهانة تحقيقًا لمصلحة بادية، فالإله الخالق هو النصير الكامل للإنسان، بقدر ما أن الإنسان الحر هو الإبداع الذاتي لله في قلب الوجود.