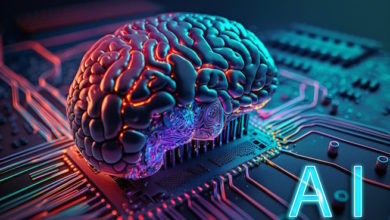منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 التي تعرضت فيها الولايات المتحدة الأمريكية لهجمات إرهابية غير مسبوقة، باعتبار أن الذين قاموا بهذه الهجمات عناصر جاءت من العالم العربي والإسلامي، منذ هذا التاريخ تحديدا طفت بشكل حاد علاقة التوتر بين الغرب وبين الإسلام كدين وكحضارة، وظهرت نظريات تؤصل لتاريخ هذه العلاقة ومكوناتها وتستدعي مراحلها المختلفة. ومن سوء الحظ أن تداعي الأحداث الإرهابية خاصة في المجتمعات الغربية المسيحية، قدم ذخيرة للنظريات التي تنبأت بأن العالم يقبل على صراع لن يكون سياسيا أو أيديولوجيا، وإنما صراع حضاري وثقافي بين الغرب والثقافات الشرقية ومن أهمها الإسلام، وعلى هذا الأساس قدموا توصياتهم لحكوماتهم حول كيف يديرون هذا الصراع المقبل. في ضوء هذا تبدو الحاجة إلى الرجوع إلى المؤرخين والباحثين الذين انشغلوا بتتبع تاريخ العلاقة بين الغرب والإسلام، وكان من أبرزهم الدبلوماسي والمؤرخ العربي خالد زيادة الذي قدم، في تتبع هذه العلاقة، ثلاثية تركز على تطور نظرة الإسلام إلى الغرب وكيف رأى مفكرون مسلمون منذ القرن التاسع عشر وفي بدايات القرن العشرين هذه العلاقة. وعلى المستوى الغربي اخترنا ثلاثة من المؤرخين الغربيين وهم: المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي، والمؤرخ البريطاني الأمريكي الجنسية برنارد لويس وعالم السياسة الأمريكي جون اسبوزيتو. وحيث تتباين مواقفهم بين العلاقة من الغرب والإسلام فيما يصف توينبي الإسلام كدين وكحضارة ويهاجم المؤرخين الغربيين ومركزيتهم في قراءة تاريخ الحضارات، ويقدم برنارد لويس تفسيرا “للتعصب الإسلامي” حيث يراه في تخلفه إزاء التقدم الأوروبي متجاهلاً التاريخ الغربي الاستعماري وبث إسرائيل في قلب العالم العربي أما جون اسبوزيتو فهو يُذّكر الغرب ردا على ربط الأصولية بالإسلام أن نسبة صغيرة من المسلمين هي التي تنتمي إلى هذه المجموعة.
أولاً: تطور النظرة الإسلامية إلى الغرب:
في عام 2016 أصدر السفير والمؤرخ خالد زيادة كتابا يحمل عنوانا لافتا ” لم يعد لأوروبا ما تقدمه للعرب” (الدار المصرية اللبنانية) خلال هذا تبين أن الكتاب هو جزء من ثلاثية انشغل فيها السفير زيادة بالبحث عن علاقة الإسلام والغرب وكانت البداية في كتابه” المسلمون والحداثة الأوروبية” (رؤية للنشر والتوزيع 2010) وهو ينبه في البداية إلى أن هدفه من هذا الكتاب ، بعد أن تناولته العديد من الأبحاث والدراسات التي قام بها مسلمون وعرب و أوروبيون، ليست إضافة وجهة نظر أخرى في هذا السياق، وإنما البحث عن الظروف التي اكتشف فيها المسلمون تقدم أوروبا، بعد أن استقر في وعيهم لزمن طويل أنهم متفوقون على العالمين، وأن الفكر العربي قد اعتبر أن بداية اتصال المسلمين بالتقدم الأوروبي حدث مع حملة بونابرت على مصر عام 1799. القضية المحورية التي يناقشها السفير زيادة طوال فصول الكتاب هي أن العثمانيين قد أدركوا قبل قرن من الحملة الفرنسية أن العسكرية الأوروبية باتت متفوقة على القوات العثمانية، وأنهم بفضل هذا أجروا، على امتداد القرن الثامن عشر، العديد من المحاولات لاكتشاف التنظيم والفكر العسكريين الأوروبيين.
غير أنه إذا كانت الدولة العثمانية تمثل الدولة الإسلامية الأقوى إلا أنها لم تكن تمثل مجمل المسلمين إذ بقيت خارج هيمنتها السياسية مجموعات واسعة من مسلمي آسيا وعلى هذا كان المسلمون في الهند من أوائل المسلمين الذين تعرفوا على المؤثرات الأوروبية بسبب وقوع الهند منذ القرن السادس عشر تحت تأثير البحارة والتجار الأوروبيين وبالتالي تحت تأثير الشركات التجارية لمختلف الدول الأوروبية.
وفي الطرف الآخر من العالم الإسلامي قامت اتصالات بين الأمراء المحليين وبين ملوك أوروبا عبر السفراء الذين كانوا ينقلون بعد عودتهم إلى بلادهم صورة مما شاهدوه في أوروبا وفي ظل مولاي إسماعيل سلطان فاس ومراكش (1672 ـ 1727) تزايد عدد السفراء المسلمين الذين أمكنهم أن يقبلوا على مظاهر التقدم الأوروبي.
وفي الدولة العثمانية حصلت استعانة بالسلاح الأوروبي المتطور، ومنذ القرن الخامس عشر لم تنقطع الاتصالات بين العثمانيين ودول أوروبا، والواقع أن الهزيمة العسكرية العثمانية عام 1699 أوجدت لدى الطبقة الحاكمة ميلا إلى الاستفادة من التقدم الأوروبي، وثبت الاعتقاد لدى السلاطين المتعاقبين خلال القرن الثامن عشر بضرورة إصلاح والأخذ بالتجربة الأوروبية في مجال التنظيم العسكري والعلوم، وقد أخذ هذا التأثير شكلا في عهد السلطان سليم الثالث حيث أخذ العثمانيون يكتشفون أوروبا الحديثة وأفكارها الجديدة من خلال سفرائهم أو من خلال الخبراء الأوروبيين والفرنسيين خصوصا، وينبه السفير زيادة إلى أن تجربة سليم الثالث في الانفتاح على التحديث الأوروبي لم تكن بلا مقاومة من جهاز العلماء ورجال الدين الذين اعتبروا إصلاحات سليم الثالث نوعا من البدعة والكفر، ووقع هؤلاء، حجة شرعية” تدين الإصلاح و “النظام الجديد” باعتباره بدعة وتقليدا للكفار وهكذا كانت معارضة العلماء ورجال الدين حاسمة في القضاء على تجربة سليم الثالث.
يستخلص السفير زيادة أنه مع نهاية القرن الثامن عشر والبدايات الأولى للقرن التاسع عشر كان التقدم الأوروبي قد أحاط العالم الإسلامي برمته ونشأ التفكير في هذا الإقليم أو ذاك بصورة الأخذ بالتقنيات الحديثة والتعرف إلى الأنظمة التي جعلت من الدول الأوروبية بلدانا متفوقة على غيرها من بلدان العالم. وهي نفس اللحظة التي بدأ فيها أيضا الجدل بين مفكرين مسلمين و عرب حول مدى تعارض أو اتفاق الأخذ بأساليب وأدوات التقدم الأوروبي ومن ثم حضارتها وقيمها مع ثوابت التراث الإسلامي وأصوله وهو ما سوف يناقشه السفير زيادة تفصيلاً في كتابه الثاني ” تطوير النظرة الإسلامية إلى أوروبا ” (الدار المصرية اللبنانية، 2016).
فإذا كانت نظرة الأوروبيين إلى الإسلام قد بدأت في إطار مؤسسة الكنيسة الكاثوليكية، لتنتقل في طور آخر إلى أيدي المتخصصين في الإنسانيات والآداب والأنثروبولوجيا ، فإن نظرة المسلمين إلى أوروبا كانت في البدايات من اختصاص الجغرافيين والمؤرخين والأدباء، وقد وصلت في زمننا الراهن إلى أيدي رجال الدين والناطقين باسم الحركات الدينية إضافة إلى اتباع أيديولوجية ممن يرون أن الغرب يتآمر على المسلمين والعرب ولم يكن هناك تكافؤ بين نظرة المسلمين إلى أوروبا وبين نظرة أوروبا المسيحية إلى الإسلام لم يحدث أن طابق المسلمون المسيحية مع أوروبا إلا مع العثمانيين، وبمعنى أدق: فقد اكتشف العثمانيون هوية أوروبا المسيحية في زمن يقول عنه رودنسون أنه شهد تغليب النظرة الواقعية والمصالح على العداء المطلق، وواقع الأمر أن العثمانيين تحالفوا مع جزء من أوروبا ضد جزء آخر منها. أما عن تكوين ملامح الصورة التقليدية الإسلامية عن أوروبا فلاشك أن هذه الصورة قد حظيت بملامحها الأساسية بين القرن العاشر والقرن الثاني عشر مع المسعودي والإدريسي وابن سعيد الغرناطي بشكل خاص، ولم يؤثر صعود أوروبا في مرحلة لاحقة، في حث المسلمين على تبديل نظرتهم فكانت الفئات العليا واثقة من مصادر ثقافتها وعلمها التقليديين، أما الوقائع الجديدة فلم تكن تجد من يصوغها ابتداء من عصر المماليك وما تلاه.
ويذهب السفير زيادة إلى أنه لم تكن نظرة أوروبا اللاتينية إلى الإسلام لتعادل نظرة الإسلام إلى أوروبا، فمنذ ظهوره على مسرح الأحداث العالمي، استشعر الأوروبيون خطر الإسلام الأكيد عليهم، وقد هدد المسلمون القسطنطينية ثلاث مرات عند نهاية القرن السابع الميلادي وبداية القرن الثامن، أما في الغرب فإن مقاتلين مسلمين وصلوا إلى أواسط فرنسا عام 723م صحيح أن معركة بواتييه التي جرت في ذلك العام قد وضعت حدا لتقدم المسلمين في الغرب اللاتيني، لكن هذه المعركة لم تبدد مخاوف الأوروبيين تجاه خطر الإسلام. صحيح أننا نعثر على حالات عديدة من التعبير عن الحرية في الآداب الإسلامية الكلاسيكية، وصحيح أيضا أن التعبير الاجتماعي للحرية لديهم قد اتخذ أشكالاً خاصة به إلا أن الصحيح أيضا أن مفهوم الحرية بما هو مبدأ سياسي لم يكن معروفا لدى المسلمين وأول من تنبه على مدلوله الأوروبي كان الأتراك الذين استخدموه عام 1774 في معاهدة كورندجيا.
ويتعقب السفير زيادة مساهمات إعلام الفكر العربي في التاريخ الحديث والمعاصر حيث كان كل واحد منهم قد أراد بطريقته الخاصة أن يضفر ثقافة الغرب الحديث وثقافة التراث العربي في جديلة واحدة.
وباعتبار أن علاقات أوروبا مع العالم العربي أصبح يتجاذبها عاملان، الأول الإرث التاريخي الذي اتسم بالعداء ويتمثل في الحروب الصليبية والعهد الاستعماري ثم بث إسرائيل في المنطقة العربية، والآخر إيجابي منذ القرن الثامن عشر، حين اقتنع السلطان أحمد الثالث بضرورة الأخذ بالعلوم العسكرية الأوروبية وافتتاح أول مدرسة للهندسة، كما اقتنع محمد علي بعد فترة من الزمن بإرسال الطلاب إلى فرنسا للتعرف على العلوم التي تمكن من إنشاء جيش قوي نظامي مزود بالآليات. ومع النصف الأول من القرن العشرين كتب أحد المفكرين العرب وهو طه حسين أنه إذا كانت بلاده تريد الاستقلال الفعلي فإن هذا لا يتحقق إلا بامتلاك وسائله أن نتعلم كما يتعلم الأوروبيون ونشعر كما يشعر الأوروبيون ونحكم كما يحكم الأوروبيون ثم نعمل كما يعمل الأوروبيون .وبفعل هذا توجهت أجيال من المثقفين العرب إلى جامعات أوروبا، وأسست حكومات عربية علاقات سياسية واقتصادية وثقافية واسعة وكان هذا التوجه يشير إلى أن العرب قد تجاوزوا مظالمهم التاريخية تجاه أوروبا وتصرفوا باعتقاد أن لدى أوروبا ما يساهم في تطور مجتمعاتهم.
وبعد هذه الرحلة في تتبع النظرة الإسلامية إلى الغرب خلص السفير زيادة مؤخرا إلى أنه لم يعد لأوروبا ما تقدمه للعرب” في كتاب صدر تحت هذا العنوان (الدار المصرية اللبنانية 2015) وتنطلق هذه الرؤية من استعادة التاريخ المشترك بين أوروبا والعرب، ويمثل علاقة فريدة بحكم التاريخ والجغرافيا، بين المجموعات الحضارية، فهو تاريخ طويل يمتد مسافة أربعة عشر قرنا تختلط فيه الصراعات والحروب بتبادل البضائع والأفكار والمؤتمرات والاجتماعات عبر ضفتي المتوسط. في هذا السياق يذهب السفير زيادة إلى أنه مثلما كان تأثير الإسلام والمسلمين في تشكيل هوية أوروبا المسيحية، كذلك لا يمكن على الإطلاق إنكار تأثير أوروبا في تطور العالم العربي والإسلامي وتحديثه وفي تطور الإنسانية جمعاء.
غير أنه في رأي الكاتب، أنه لم يعد لأوروبا ما تقدمه للعرب، أن نهاية الحرب العالمية الثانية كانت منعطفا في صورة أوروبا الكونية إذ بدأت تفقد أولويتها في مجال سحري هو التقنيات ولم تعد أوروبا الرائدة في صناعة الأدوات فقد أصبحت الولايات المتحدة قطبا منافسا في صناعة وسائل النقل والطائرات وإنتاج أول قنبلة ذرية والدخول في مجال الفضاء هذا فضلا عن ظهور منافس في المجال التقني وهو اليابان. ومنذ الثمانينات بدأت تبرز النمور الآسيوية في مجال التقنيات وكذلك الصين والهند، وإذا كانت الأفكار والنظريات الكبرى والتيارات الأيديولوجية التي جذبت المفكرين والمثقفين العرب قد صدرت عن أوروبا إلا أن هذا العصر قد انتهى، بل إن العرب الذين يعبرون إلى أوروبا لدراسة الطب والهندسة، يعودون إلى بلادهم مشبعين بأفكار الماركسية الليبرالية وقد اكتشفوا هويتهم وأصبحوا يتبنون أفكارا نقدية لأوروبا.
فهل حقا أن أوروبا لم تعد تملك ما تقدمه للعرب،؟ بما يعني ضمنا أن العرب لم يعودوا يعتمدون على أوروبا وأنهم يستطيعون الاستغناء عنها؟ حقيقة أن العرب أصبح لديهم بدائل لأوروبا وخاصة في مجال التكنولوجيا والسلاح نتيجة لقوى جديدة مثل اليابان، والصين والهند فضلا عن روسيا، غير أن هذا لا ينفي أن أوروبا مازالت مصدرا رئيسا لمصدرين رئيسيين للمجتمعات والحياة العربية التكنولوجيا المتقدمة، والسلاح، وهو ما يفسر ما حصلت عليه مصر مؤخرا من طائرات رافال الفرنسية وحاملات الطائرات ميسترال، وغواصات دولفين الألمانية، وهو نفس ما تفعله دول عربية أخرى مثل المملكة العربية السعودية ودول الخليج، هذا فضلا عن استمرار بل تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وحيث أصبح الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لدولة مثل مصر. وقد جاء عنصر آخر جعل أوروبا تتداخل بشكل غير مسبوق مع العالم العربي وهو الإرهاب، حيث أصبح هما مشتركا يدفع إلى التعاون والتنسيق لمكافحة آثاره المدمرة، والحقيقة أن التطور الذي لحق بالقوى الدولية قد وسع قاعدة الاختيار أمام الدول العربية وهو تطور صحي يصب في صالح استقلالية الدول العربية وقرارها الوطني، ولكنه لم ينفِ التلاقي والتعاون بين العرب وأوروبا في مجالات حيوية.
ثانياً: الإسلام والغرب عند المفكرين المسلمين:
على مدى القرن التاسع عشر و بدايات القرن العشرين شغلت العلاقة بين الإسلام والغرب اهتمام عدد من المفكرين المسلمين خاصة على وقع التقدم الغربي والسيطرة الأوروبية، وقد تراوحت نظرة هؤلاء العلماء المسلمين إلى الغرب ما بين الإعجاب بمظاهر التقدم الأوروبي وأدواته والدعوة إلى تبني النموذج الغربي في الحكم والمجتمع، وإن كان البعض وهو يسجل مظاهر التقدم الغربي، قد تحفظ على المدى الذي وصلت إليه علاقات المجتمعات الغربية من مادية، أما التيار الثاني من علماء المسلمين فقد دعا إلى عودة المسلمين إلى دينهم.
في تفصيل هذه التيارات والشخصيات الممثلة لها فإن البداية دائما تكون عند رفاعة الطهطاوي (1801 ـ 1871). والذي كتب، خلال إقامته في باريس إماما لمجموعات طلاب العلم الذين أوفدهم محمد علي للتخصص في مجالات مختلفة، كتب كتابه الشهير “تخليص الإبريز في تلخيص باريس” والذي نشر عام 1831 ويمكن القول إن الصورة التي قدمها الطهطاوي عن أوروبا، يمكن تلخيصها على النحو التالي : قدم لمعاصريه صورة مزدوجة وجهها الأول يتناول التقدم الأوروبي ووجهها الآخر يتناول النظام السياسي في فرنسا بوجه خاص، أو صورة الليبرالية السياسية في النصف الأول من القرن التاسع عشر. إن ظروف العصر هي التي حتمت دمج الجهدين في عمل واحد. فمصر لم تتعرف إلى أوروبا تدريجيا كما الحال بالنسبة لتركيا، بل كان أمامها أن تلتقي في آن معا مع التقدم العلمي، والليبرالية السياسية في وقت لم يعد من المجدي معرفة أيهما سبب الآخر. ومن جهة أخرى اعتقد الطهطاوي بأن منجزات المدنية الأوروبية يمكن استيعابها، ولم ير بأن الشريعة الإسلامية تعارض في ذلك ، بل حاول أن يوفق بين فرنسا والعرب، بين الإسلام وأوروبا وأن يدمج ما يراه نافعا في كلا الطرفين: المسلمون يقدمون الإيمان بالرغم مما يتخبطون به من انحطاط وأوروبا تقدم العلوم بالرغم من ابتعادها عن الدين كما كانت مسألة التوفيق بين الإسلام وأوروبا أيضا محاولة لأحد معاصري الطهطاوي والذي عاش ذات الظروف والتطورات التي شهدتها مصــر في القرن التاسع عشــر وهو علي مبارك (1823 – 1893) والذي كتب مؤلفا ضخما يحمل عنوانا معبرا هو: علم الدين: وقد كان علي مبارك ،الذي نشأ نشأة دينية في صباه، قد التحق بإحدى المدارس التي افتتحها محمد علي، وقادته الظروف إلى باريس (1844 – 1848) في رحلة مشابهة لرحلة الطهطاوي.
وحيث انتهى الطهطاوي إلى محاولة التوفيق بين فرنسا والغرب وبين الإسلام وأوروبا، فإن علي مبارك مؤلف علم الدين بعد ثلاثين سنة تقريبا من تخليص الإبريز إلا أن سرد المعلومات يأتي عن طريق نوع من الأسلوب القصصي والحوار بين شخصين أو أكثر.
ويمثل كتاب علم الدين نوعا من الموسوعة يمكن لقارئها أن يلم بالأوجه المختلفة للتقدم الأوروبي وقد كان لدى علي مبارك الوقت الكافي ليشرح بإسهاب جميع ما أراد تبيانه وإبرازه من ذلك أنه يفرد للحديث عن البخار مثلاً ما يزيد على 15 صفحة عدا ما يفرده من صفحات طوال للحديث عن المسرح والتربية والزراعة والجغرافيا وغير ذلك وعنده أن الإفرنج يعتنون بإتقان جميع الأشياء ويعتبر أنه بالرغم من ذلك فإن تقدم أوروبا لم يكن ليقوم لولا تقدم العرب السالف الذي شمل جميع الميادين.
وكان خير الدين التونسي (1810 – 1879) أحد أبطال التجربة الإصلاحية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ولعل إلحاح التونسي على ضرورة استيعاب تجارب الأوروبيين له ما يبرره، فقد لمس هذا السياسي الجدير ما تحمله القوة الأوروبية من خطر جدي على بلاد المسلمين وأدرك أن قوة أوروبا العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية لا يمكن مقاومتها فمن المستحسن والحال هذه أن يأخذ المسلمون بأسباب التمدن الأوروبي قبل أن تأخذهم قوته.
وقد لعب أحمد خان (1817 – 1898) دورا بارزا في الهند، وفي الوسط الإسلامي بشكل خاص وكان لزيارته المتأخرة لإنكلتره أن تضاعف من حماسته للعلوم الحديثة وللنظام الإنجليزي وقد أدى إعجاب أحمد خان بتقدم الإنجليز ونظامهم الليبرالي إلى طبع تفكيره وعمله ، وهو اعتقد مثل خير الدين، أن نشارك الأمم الغربية في معارفهم وأن نزاحمهم في مساعيهم بالمناكب والأقدام في كل خطوة يخطونها لكسب علم أو اختراع عمل، ولا منقذ لنا من براثن الفقر ومخالب الجهل إلا اقتطاف علومهم وإدخال مدنيتهم، ليكون هناك شيء من التكافؤ بيننا وبينهم لكن أبرز أثر للأفكار الأوروبية فيه محاولته تقديم تفسير جديد للقرآن إذ قال بأن الوحي كان بالمعنى لا باللفظ ودعا إلى تفسير القرآن بحيث يتفق مع العقل بالاعتماد على روحه لا على حرفيته الأمر الذي أثار النقمة عليه.
أما جمال الدين الأفغاني (1839 – 1897) فكان أول من أعاد طرح مسألة العلاقة مع أوروبا من زاوية جديدة، فلم يعد الأمر يتعلق بعلومها وتقدمها، وإنما يتعلق بالدفاع عن الإسلام أمام الأخطار التي تحدق به، وقد أثار عاصفة فكرية إبان إقامته في القاهرة قادما إليها من إيران والهند في الثانية والثلاثين من العمر، من حيث قدرته على النقاش وجرأته وتناوله للمسائل الراهنة قد جمعت حوله مجموعة من الشباب المثقف من المصريين والسوريين أيضا. إن تتبع أفكار الأفغاني ليس بالأمر السهل، لأنه لم يكن ميالاً للحياة العملية وإعداد المشاريع السياسية الكبرى، الفاشلة على الأرجح، والتي تمحورت حول فكرة توحيد المسلمين لاستعادة قوتهم في مواجهة السياسة الإنجليزية وقد لمس خطرها على المسلمين في كل من الهند ومصر. إلا أن أهميته يمكن أن ننسبها إلى كونه حقق، من خلال كتاباته القليلة وسجالاته، موقفا متكاملاً من الخطر الأوروبي وما يتوجب المسلمين أن يبذلوه في سبيل درء هذا الخطر.
وقد أبدى الأفغاني إعجابا بشعارات الحرية والمساواة والأخوة، وهي شعارات الثورة الفرنسية الكبرى، خلال وجوده في مصر وقد ذكر أن “أول ما شوقني للعمل في بناية الأحرار” عنوان كبير خطير: حرية ، مساواة ، إخاء.
إلا أن أفكاره هذه ستتعدل مع مرور الزمن، وها هو يهاجم في “الرد على الدهريين “فولتير وروسو وما نتج عن الثورة الفرنسية من ابتعاد عن الدين. جهد الأفغاني الفكري لا يتوقف عند هذه الحدود، بل يمكن أن ننسب إليه قبل أي مسلم آخر كشفه لوجه أوروبا الاستعماري، إن المقالات التي كتبها مع زميله وتلميذه محمد عبده في مجلة العروة الوثقى التي صدرت في باريس خلال أشهر من عام 1848 قد كتب جلها لفضح السياسة الإنجليزية في الهند ومصر والسودان.
وهكذا يتبلور الدور البارز الذي لعبه الأفغاني في إظهار وجه أوروبا الاستعماري والظالم للشعوب بل قال: فليعلم كل مسلم أن من نيتها ” إنكلتره” انقراض هذا الدين وأهله من وجه الأرض وإن لم يكن ذلك عليها بيسير. ولهذا فإن الرد الإسلامي لابد أن يكون باجتماعهم وعودتهم إلى دينهم.
وكان محمد عبده (1849 – 1905) معاونا للأفغاني في إصدار العروة الوثقى، وشريكا في أفكاره خلال تلك المدة ولعل التلميذ، قد ابتعد عن تعاليم أستاذه، وخصوصا في إهماله للنشاط السياسي والتحريض أو في اعتقاده بأن مهادأة الإنجليز يمكن أن تعود ببعض الفائدة على المصريين إلا أن النقطة المشتركة بين عبده والأفغاني تبقى في عودة المسلمين إلى فهم تعاليم دينهم الحقيقية وزوال أسباب انحطاطهم الراهن، وقد تيسر لعبده، الذي وضع على عاتقه مهمة إحياء العقيدة الإسلامية في النفوس وإصلاح مؤسسات التعليم، أن يرد على منتقدي الإسلام وأن يستعيد في رسالة قصيرة أسس الإيمان والتوحيد الإسلاميين، بالإضافة إلى تفسيره للقرآن تفسيرا يراد منه إظهار صلاحيته المستمرة.
وحسب محمد عبده فإن نشأة المدنية في أوروبا إنما قامت على هذين الأصلين، فلم تنهض النفوس للعمل ولم تتحرك العقول للبحث والنظر إلا بعد أن عرف الكثير أنفسهم وأن لهم حقا في تصريف اختيارهم وفي طلب الحقائق بعقولهم، وأن نهضة أوروبا التي ظهرت منذ القرن السادس عشر ليست إلا شعاعا سطع عليهم من آداب الإسلام ومعارف المحققين من أهله في تلك الأزمان.
وواقع الأمر أن الشيخ عبده كان متيقنا من تقدم أوروبا وحاجة المسلمين إليها، لكن الأمر لم يقتصر على هذا الحد إذ أن تفسيره للعقيدة الإسلامية أراده أيضا أن يكون موافقا للعقل: إن العقل وحده لا يستقل بالوصول إلى ما فيه سعادة الأمم بدون مرشد إلهي.
وينبغي أن نتفهم بالنتيجة أن صورة أوروبا المتقدمة علميا كانت تملي على الشيخ عبده الموقف التالي: “إنه ينبغي مباراتهم في هذا العصر، بعمل المدافع والبنادق، والسفن الحربية البحرية والبرية والهوائية، وغير ذلك من الفنون والعدد العسكرية ويتوقف ذلك كله على البراعة في العلوم الرياضية والطبيعية فهي واجبة على المسلمين في هذا العصر لأن الواجب في الاستعداد العسكري لا يتم إلا بها. وكان تقدم أوروبا عمليا وعسكريا وسياسيا كان دافعا قويا لديه ليعيد فهم العقيدة الإسلامية بل ليتبنى مشروع الإصلاح الديني، وهذا المشروع بحد ذاته كان يتعارض مع النزعة القائلة بإمكانية التوفيق بين إيمان المسلمين وتقدم أوروبا.
مثل محمد إقبال (1873 ـ 1938) تجربة أخرى وهي تجربة مسلمي الهند في صراعهم مع الاستعمار الإنجليزي وفي سعيهم إلى بلورة شخصية مستقلة عن الهندوس، وقد انخرط إقبال في هذه التجربة، بل يمكن القول بأن تأسيس دولة باكستان بعد تسع سنوات من وفاته هو نتيجة لجهده وفكره على السواء، إلا أن إقبال لم يكن رجل السياسة، بقدر ما كان رجل الفكر المرهف والعميق. إن دراسته الفلسفة والقانون في بريطانيا وألمانيا على السواء قد طبعت تفكيره وقد تبين له أن صورة أوروبا الفكرية تحمل تحديا خاصا للإسلام فقد تطورت الفلسفة وطرائق التطور، ومع ذلك فإن معرفة عميقة بالقرآن ومعرفة مدققة بالفلسفات الأوروبية الحديثة والمعاصرة ستؤدي عند إقبال إلى قيامه بمحاولة فريدة حتى ذلك الوقت حين ألقى في نهاية العشرينيات مجموعة من المحاضرات حول تجديد التفكير الديني في الإسلام تمثل أرقى ما كتبه مسلم متفائل بمكانة الإسلام في عالم ينطبع بصورة أوروبا.
ثالثاً : رؤية مستشرقين غربيين إلى العلاقة من الإسلام والغرب:
إذا كانت هذه هي مساهمة مؤرخين إسلاميين في تتبع علاقة الإسلام بالغرب، فكيف نظر مؤرخون ومستشرقون غربيون إلى هذه العلاقة، نختار من بينهم أحدثهم ليس فقط لتخصصه في التاريخ الإسلامي ولكن أيضا لأنه وخاصة في الفترة الأخيرة، الأكثر تأثيرا ليس فقط على الدوائر الأكاديمية والبحثية، ولكن أيضا على الدوائر والمؤسسات الرسمية، ونعني به المؤرخ الأمريكي الجنسية، البريطاني الأصل، اليهودي الديانة وهو برنارد لويس (1916 – 2015) وقد تزايد الاهتمام به خاصة في الولايات المتحدة، بعد هجمات 11 سبتمبر، حيث أصبح مستشارا للمؤسسات الرسمية الأمريكية في تفسير ما حدث في فهم العالم الإسلامي. ونذكر أنه بعد هذه الأحداث، طفت من جديد نظرية صدام الحضارات clash of Civilizations التي صاغها عام 1993 عالم السياسة الأمريكي صامويل هنتجنتون ونشرها أولاً في دورية Foreign Affairs ثم طورها في كتاب بعنوان ” صدام الحضارات: إعادة صنع النظام العالمي” في هذا المقال الكتاب اعتبر هانتجنتون أن الصراع القادم في العالم لن يكون سياسيا أو اقتصاديا، وإنما صراع بين الثقافات والحضارات، خص من بينهما الحضارة الإسلامية. غير أن الباحثين والمؤرخين الدارسين لإسهامات برنارد لويس اكتشفوا أن لويس هو أول من صك مفهوم “صراع الحضارات” وذلك في دراسة نشرها عام 1989 تحت عنوان ” جذور الغضب الإسلامي” The Roots of Muslim Rage.
وفي هذه الدارسة صك برنارد لويس تعبير “صدام الحضارات” غير أنه قبل أن نعرض هذه الدارسة من المفيد أن نشير إلى الدراسة التي نشرها لويس عام 1988 تحت عنوان ” الثورة الإسلامية ” Islamic Revolution والتي ركز فيها على الثورة الإيرانية واعتبر أن الهدف الأول للأصولية ليس الأعداء الخارجيين ولكن العدو الداخلي وهم النظم والحكام الذين تخلوا عن الشريعة الإسلامية وتبنوا النظم والقيم الغربية، ولذك فإنه فقط حين يخلع الحكام المرتدون عن الإسلام سوف تصبح الحرب ضد المعتدي الأجنبي والنصر عليه ممكنا، ويواصل لويس تفصيله للعلاقة بين الإسلام والغرب بقوله ” تاريخيا دارت الحرب في المفهوم الإسلامي والمسيحية والتي عرفت بعد ذلك بأوروبا ثم تجددت في الأزمنة الحديثة بالغرب، وقد تدعم هذا المفهوم بقرون من الصراع والجهاد والحملات الصليبية والغزو وإعادة الغزو، والغزو الإسلامي للعالم الغربي والغزو الأوروبي للإسلام، فإذا كان المنافس الرئيسي هو المسيحية والعالم الغربي، فإن العدو الرئيسي كان هو القوة القائدة في العالم، كانت في وقت ما الإمبراطوريات البيزنطية والرومانية، ورغم تعدد مصادر التهديد فإنه كان من الأسهل توجيه العداء للغرب باعتباره مصدرا لكل الأخطار التي حلت بالعالم الإسلامي في العصر الحديث والتي قوضت طريقة الحياة الإسلامية وهكذا فإن هدف الثورة الإيرانية ثم بعد ذلك في أماكن أخرى هو إزاحة التأثيرات الغربية التي فرضت على بلاد المسلمين وشعوبها في عصر السيطرة الأجنبية.
ويتساءل لويس عن مصادر الغضب والثورة الإسلامية وعنده أن الكتابات والخطب الثورية تكشف عن فرضين الأول هو الإحساس بالانحلال المتنامي وخاصة بين الفئات المتعلمة وخاصة الذين تلقوا تعليما في الغرب، أما الفرضية الثانية فهو شيوع العادات والبضائع الغربية الاستهلاكية وما خلقته عملية التغريب من فجوة كبيرة بين الغني والفقير وجعلتها أكثر وضوحا وبشكل جعل “النخبة المستغربة والأغلبية الغير مستغربة تعيشان في عوالم مختلفة.
وبعد هذا التقديم للثورة الإسلامية ودوافعها وأهدافها يتقدم لويس لكي يؤصل للغضب الإسلامي ويتعرف على أصله في تاريخ الحضارة الإسلامية وحيث كان العالم الإسلامي وهو في ذروة قوته، يرى نفسه كمركز الحقيقة والتنوير محاط ببرابرة والذين سوف يتمدنون ويتنورون في الوقت المناسب، ولكن كان ثمة اختلافات حاسمة بين مجموعات غير المؤمنين، فالبرابرة في الشرق والجنوب كانوا مشركين ووثنين لا يمثلون أي تهديد أو منافسة حتى ظهر منافس حقيقي تمثل في ديانة عالمية منافسة وحضارة متميزة تلهمها هذه الديانة، وعلى إمبراطورية، وإن كانت أصغر كثيرا إلا أنها لم تكن أقل طموحا في دعاويها وآمالها، كان هذا هو الكيان المعروف لنفسه وللآخرين بالمسيحية وهو التعبير الذي كان مرادفا لأوروبا وقد استمر صراع بين هذين النطاقين المتنافسين لقرابة أربعة عشر قرنا، وقد بدأ يتقدم في القرن السابع واستمر تقريبا حتى هذا اليوم وتكون من سلسلة طويلة من وإلى الألف عام الأولى الإسلام يتقدم والمسيحية تتراجع وتحت التهديد، وغزت العقيدة الجديدة الأراضي المسيحية القديمة في المشرق وشمال إفريقيا وغزت أوروبا وحكمت لفترة سيسيلي وإسبانيا والبرتغال وحتى أجزاء من فرنسا، وصدت محاولات الصليبيين لاستعادة أراضي المسيحية المفقودة في الشرق وحتى ما فقده المسلمون من جنوب غرب أوروبا قد عوض بالتقدم الإسلامي في جنوب شرق أوروبا والذي وصل مرتين إلى فيينا، إلا أنه وللثلاثمائة عام الأخيرة ومنذ فشل الحصار التركي الثاني لفيينا عام 1683 وصعود الإمبراطوريات الاستعمارية الغربية في آسيا وإفريقيا أصبح الإسلام في موضع الدفاع من هذا الأساس التاريخي يؤسس لويس ما يراه من المد الصاعد للثورة ضد هذا التفوق الغربي والرغبة في إعادة تأكيد القيم الإسلامية واستعادة العظمة الإسلامية، فقد عانى المسلمون مراحل متتالية من الهزيمة، كانت الأولى هي فقدان السيطرة على العالم للقوة المتقدمة لروسيا والغرب، والثانية هي تقويض لسلطة الإسلام في بلاده ذاتها من خلال غزو الأفكار الأجنبية والقوانين وطرق الحياة وفي بعض الأحيان الحكام الأجانب والمستوطنين وامتيازات العناصر الغير إسلامية، أما الهزيمة الثالثة القاصمة فكانت تحدي سيادته في بيته نفسه من النساء المتحررات، والأبناء المتمردين، ويستخلص لويس أن هذه كانت أكثر مما يمكن احتماله وكان اشتعال الغضب حتميا ضد هذه القوى الغربية والكافرة التي دمرت سيطرته وفككت مجتمعه وأخيرا خرقت حرمة بلاده كان طبيعيا أيضا ما ينتجه هذا الغضب في المقام الأول ضد هذا العدو وأن يستمد قوته من عقائد وولاءات قديمة.
أما المؤرخ الغربي الآخر فهو أرنولد توينبي (1889 – 1975) وهو المؤرخ الذي أصبح اسمه مألوفا للمثقف العربي لموقفه المنصف من القضية الفلسطينية ورؤيته للوجود الإسرائيلي في فلسطين اغتصابا لأراض الغير، وامتدادا للإمبريالية ضد الشرق، غير أن الرؤية الدولية العريضة التي اكتسبها توينبي قد ارتبطت بعمله الضخم “دراسة التاريخ” Study of History (12جزءا) والذي كتبه على مدى 20 عاما 1934 – 1954 وفي نطاق موضوعنا فإن النظرة الشاملة التي ميزت عمل توينبي، وهي النظرة التي جعلته يتحدى تمركز المؤرخين الغربيين حول تراثهم واعتبارهم أنهم بحضاراتهم الغربية إنما يحتكرون التاريخ وكأن التاريخ قد توقف تماما عند عالمهم الغربي، لذلك اعتبر أن مساهمة أرنولد الأساسية في تقاليد المعرفة هي رؤيته للتاريخ البشري من منظور أوسع وتذكيره للحضارة الغربية الحقيقية البسيطة، أن الحضارات الأخرى بما فيها الحضارة الإسلامية كان لها دور في التاريخ البشري.
وفي تعرضه للإسلام وعلاقته بالغرب، وباعتبار أن الإمبراطورية العثمانية كانت لعدة قرون تمثل الإسلام، فقد اختار تركيا لكي يناقش من خلالها علاقة الإسلام بالغرب. فقد مرت مائة عام وأكثر بعد كارثة هزيمة الأتراك على مشارف فيينا عام 1683 قبل أن يأخذ سلطان تركي الخطوة الأولى في تدريب القوات التركية وفقا للنموذج الغربي، كما مرت 236 عاما قبل أن يدفع رجل دولة تركي بقوة أبناء وطنه لتبَني أسلوب الحياة الغربي وبدون أي تحفظ، غير أنه في الفصل الأول من قصة تبني تركيا للأساليب الغربية، فإنه على الأتراك الذين كانوا مقتنعين بسياسة تحديث تركيا أن يكونوا – قلبيا – محبين لهذه الحضارة الغربية التي كانوا يدخلونها مجبرين، وكانت نيتهم تبني أقل جرعة من هذه الحضارة وبشكل يمكن أن يبقي على رجل أوروبا المريض حيا. مثل هذه الروح المتذمرة تسببت في إجهاض دفعة بعد أخرى من إصلاحات غربية، وكان حكم التاريخ على مثل هذه المدرسة الغربية من أنصار التحديث الأتراك هو في كل مرة : القليل جدا، والمتأخر جدا وقد كانت هذه المدرسة تتصور أن بإمكانها جعل تركيا تصمد أمام القوى الغربية لمجرد ارتداء الجنود الأتراك للزي العسكري الغربي واستخدامهم الأسلحة الغربية، وتوجيههم إلى التدريب المهني الغربي، كل هذا في نفس الوقت الذي يبقون فيه على كل جوانب الحياة التركية وعلى أسسها الإسلامية التقليدية.
ويواصل توينبي تقييمه لتجربة تركيا في التعامل مع الغرب وحضارته فيعتبر أن سبب فشل السياسة القائمة على أقل جرعة من الحضارة الغربية، هو أن المصلحين الأتراك قد تعاموا عن الحقيقة التي أدركتها عبقرية مصلح آخر هو بطرس الأكبر، هذه الحقيقة فيما يعتقد توينبي أن أية حضارة أو أي أسلوب في الحياة هو كل لا يتجزأ وحيث يعتمد فيه كل جزء على الآخر، فسر التفوق الغربي على بقية العالم في فن الحرب من القرن السابع عشر لا يكمن في مجرد الأسلحة الغربية والتدريب الغربي، كما لا يكمن في التكنولوجيا المدنية التي تزود المعدات العسكرية، إن هذا الشر لا يمكن فهمه دون الأخذ في الاعتبار كل مقومات الفكر والروح في المجتمع الغربي، وفي واقع الأمر فإن فن الحرب الغربي كان دائما أحد وجوه طريقة الحياة الغربية، وعلى هذا فإن المجتمع الأجنبي الذي يحاول أن يحصل ويمتلك هذا الفن دون أن يحيا حياة المجتمع الذي ينتجه، مقضي عليه بالفشل في التمكن والسيطرة على هذا الفن.
وبعد أن وضع الأتراك أنفسهم على حافة الدمار باتباع الاختيار الأول، فقد أنقذوا أنفسهم وقبل أن يصبح الوقت متأخرا جدا بالانغماس في طريق التحديث الغربي وبغير حدود تحت قيادة كمال أتاتورك، وكان معنى هذا الاختيار أن العثمانيين، قد اعترفوا لأنفسهم بحقيقة أنه في عملية التداخل والاتصال الحضاري فإن جانبا منه لابد أن يؤدي إلى جانب آخر، وأن تبني الأسلحة الغربية والتدريب الغربي لابد أن يتبعه ليس فقط تحرير المرأة المسلمة وإنما استبدال اللغة العربية بالحروف اللاتينية، وفصل الدين عن الدولة في كل مجالات الحياة، ويواصل توينبي تقييمه لتأثير أخذ أتاتورك بالحضارة الغربية في مجملها على المجتمع التركي فيقول إنه رغم أن ثمن هذا الاختيار كاد أن يخضع الأتراك لنظام فاشي، وإن كان نظام الحزب الواحد الذي طبقه أتاتورك لن يصل إلى التطرف الشمولي إلا أنه تطور بعد ذلك بشكل مبشر ففي الانتخابات التركية لعام 1950 تحولت تركيا من نظام الحزب الوحد إلى نظام الحزبين وبالقبول العام وبلا عنف أو إراقة دماء، وقبل الحزب الذي سيطر على الحكم لفترة طويلة إرادة الناخبين حين أجرى انتخابات حرة بالاقتراع الحر، ثم بتقبله لنتيجة التصويت المعارض له كإشارة له على أنه لابد أن يعتزل السلطة وأن يدعو المعارضة لكي تحل محل حكومته، كما أظهرت المعارضة من ناحيتها نفس الروح الدستورية.
أما المؤرخ الغربي الثالث فهو جون اسبوزسيتو أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الإسلامية في جامعة جورج تاون، فقد كتب على مدى 20 عاما عددا من الدراسات عن الإسلام والمسلمين أبرزها “الإسلام والسياسة” “الإسلام والطريق المستقيم” التهديد الإسلامي.. أسطورة أمام واقع” ومؤخرا ” مستقبل الإسلام” في هذه الكتب يناقش اسبوزسيتو نظاما عريضا من القضايا والأسئلة التي تتعلق بالإسلام والمسلمين في أمريكا والغرب ويجيب عليها موضحا من خلال التاريخ والواقع الإسلامي الالتباسات والتشويش الذي يحيط بفهم الغرب للإسلام ويقول اسبوزسيتو إنه يكتب عن الإسلام باعتباره مستقبلنا جميعا فالإسلام والمسلمون هم اليوم لاعبون متكاملون في التاريخ العالمي، وفي عالم نخضع فيه جميعا لثنائية نحن وهم، وهو ما يدفعنا إلى العلو عليه وعدم إنكار خلافاتنا، وتأكيد إنسانيتنا المشتركة، وأن نتأكد أننا ” نحن” سواء كرها أم اختيارا متصلون ببعضنا البعض ونخلق شكل مجتمعاتنا وعالمنا.
خاتمة:
على الرغم من أن الصورة اليوم تبدو قاتمة فيما يتعلق بالعلاقة بين الغرب والإسلام، وحيث تغزو قوى التطرف على كل جانب الآخر، إلا أن هذا لا يحجب جهود مؤسسات وشخصيات عاقلة لتصحيح هذه الصورة وبناء تصور وعلاقات إيجابية وبناءة بين الجانبين، من أبرز هذه الجهود في التقريب والتآخي بين الديانات هي الوثيقة التي صدرت عن زيارة فضيلة الإمام أحمد الطيب للفاتيكان في 4-5 فبراير 2019 ولقائه مع البابا وحملت عنوان ” الأخوة والإنسانية وأكدت الوثيقة أنه على المؤمن أن يرى الآخر أخاه وأن يؤازره ويحبه وانطلاقا من الإيمان بالله الذي خلق الناس جميعا وخلق الكون والخلائق وساوى بينهم برحمته فإن المؤمن مدعو للتعبير عن هذه الأخوة الإنسانية بالاعتناء بالخليقة وبالكون كله وبتقديم العون لكل إنسان لاسيما الضعفاء والأشخاص الأكثر حاجة وعوزا، وتدعو الوثيقة كل من يحملون في قلوبهم إيمانا بالله وإيمانا بالأخوة الإنسانية أن يتوحدوا ويعملوا معا من أجل أن تصبح هذه الوثيقة دليلاً للأجيال القادمة تأخذهم إلى ثقافة الاحترام المتبادل في جو من إدراك النعمة الإلهية الكبرى التي جعلت من الخلق جميعا إخوة.
أما المساهمة الغربية الثانية في بناء جو من التفاهم وتخطي العوامل التي تعمل على إذكاء التوتر ومنبعه مثلما حدث في الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للإسلام فقد صدرت عن مجموعة من السفراء الألمان المتقاعدين الذين يشكلون ما يسمى Diplomats for peace with the Islamic world وما قدموه من ورقة عمل اعتبروا أنها تعد خطوطا إرشادية لإعادة تحديد العلاقة بين الإسلام والغرب. “Basic Guide lines of relations between Europe and its neighboring countries and Islamic Region” في هذه الورقة اعتبروا أن الأزمة الحالية قد نمت نتيجة عوامل تاريخية ولهذا يجب توقع أن قرب حل المشكلة سيتطلب عملية رؤية طويلة وتطلب إدراج قوى للإسلام المعتدل، الذي يدين العنف ويتبنى فهما وتفسيرا إيجابيا ومسامحا للإسلام، ضمن العملية السياسية، وتركز الورقة على أن أي استراتيجية لإعادة تحديد العلاقة بين الإسلام والغرب يجب أن ترتكز على إدراك أن الاستقرار في العلاقة بين أوروبا والمناطق الإسلامية المجاورة سوف يتمثل فقط في المستقبل نتيجة لاحترام كل جانب لتكامل حضارة الآخر والاعتراف بالطبيعة المختلفة لمجتمعاته ونظمه السياسية، وهو يعني نبذ أي شكل من أشكال الدعوات سواء من جانب الغرب في صورة التدخل من أجل الديموقراطية أو تغيير النظم من الخارج، أو من جانب الإسلام لتأسيس الخلافة، إنما المطلوب هو تطوير علاقات قائمة على التعاون والتعايش السلمي. ويدعو السفراء إلى ضرورة أن تعمل أوروبا من أجل إجراءات عاجلة لتخفيض التوتر في الشرق الأوسط وخاصة في فلسطين.
أما الوثيقة الأوروبية الأخرى فهي التي صدرت عن البرلمان الأوروبي عام 2010 وموضوعها Our Relations with the Muslim world in the Eu’s” Immediate vicinity” وأهمية هذه الوثيقة أنها لم تصدر عن مجرد أفكار وتصورات نظرية إنما كانت نتيجة ما يمكن أن يعتبر مسحا ميدانيا قام به مجموعة من الشباب السويدي من أصول مسلمة حيث زاروا عددا من البلدان العربية واختلطوا بمجتمعاتها واستمعوا إلى قطاعات منها عن التطرف وأسلوب تعامله مع العالم الإسلامي وقضاياه، كذلك دعوة مجموعة من الشباب من العالم لزيارة السويد والاختلاط بشبابها والحوار معهم كذلك إدراك الوثيقة لأهمية الوعي بالقضايا الخلافية مثل القضية الفلسطينية والحرب على العراق والخلاف بين إيران والغرب، وأهمية هذه القضايا في تشكيل صورة كل طرف عن الآخر.