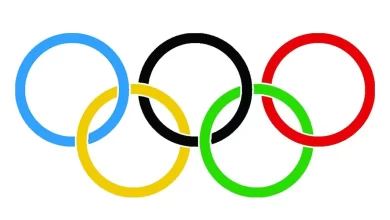هناك مقولة لا أتذكر من قالها، ولا أين قرأتها، تقول “القرى من الله أما المدن فمن صنع البشر”. ما أوسع الهوة بين إبداع الخالق وإبداع المخلوق. وعلى قدر ألفة القرى وسكونها، تأتي وحشة المدن وصخبها. ووسط هذا الصخب وتلك الوحشة الضارية يضيع كثيرون، ويهيمون على وجوههم، متنقلين في ذهاب وجيئة بين الحارات المتعرجة والميادين الوسيعة، وهم يحملون فوق جباههم لافتة تقول “غرباء” أو “طالبو عمل وسكن”.
إنها العلامة التي ترقد أيضا في قلب ونفس كل الذين يحملون أمتعتهم في أيديهم وآمالهم في عيونهم، زاحفين من الريف إلى المدن، إما أنهم ساعون وراء الرزق، أو طالبو علم، أو باحثون عن متعة، أو مغامرون راغبون في تجريب عالم جديد، أو متمردون على الجدران المصمتة والخضرة اليانعة التي ملأت عيونهم فجاءوا ليفرغوا ما فيها تحت أقدام البنايات الشاهقة الموحشة، أو يلونونه بالأحمر القانِ، والأصفر الفاقع، وأسود الأسفلت الذي يئن من دبيب الآدمين المتعبين، من صراع على المكانة الاجتماعية والمناصب السياسية والثروة.
لكن المدينة على تنصلها من القرية لا تستطيع أن تهجرها أو تطردها تماما من ذاكرتها، بل تستحضرها في الأشجار المغروسة على جنبات الشوارع الوسيعة، وفي الحدائق التي تفرش بساطها الأخضر بين البنايات الشاهقة، وفي نافورات المياه التي ترسم أشكالا مختلفة، وتنثر حباتها الشفافة على وجوه العابرين، وفي الحركات الاجتماعية المدافعة عن البيئة، والمطالبة دوما بأن يكون اللون الأخضر في كل مكان، وفي أيادي نساء جميلات يزرعن أصص الورد في الشرفات، ورجال يرمون أذرع اللبلاب على صفحات الجدران الواقفة في وجه الزمن.
وليست كل المدن سواء، فهناك العتيقة العريقة الضاربة في جذور التاريخ، وهناك الطارئة الجديدة على الدنيا، وهناك التي تتجاور فيها بنايات الفرق بين الواحدة وأختها مئات بل آلاف السنين، وهناك التي لا تجد فرقا بين قديمها وجديدها سوى بضع سنوات أو عقود على الأكثر. وهناك المدينة التي نبتت على ضفاف قرية أو طوقتها في دأب فزادتها ضخامة وغربة، فقال الناس “الريف قد تمدّن”، وهناك أخرى كانت في الأصل مدينة ونبت الريف حولها أو في جوانب منها، كزوائد دودية، فقال الناس “المدينة تريفت”، فوجدنا الموظفين في المنتصف، والفلاحين على الأطراف.
وهناك مدن عريقة أهملها أصحابها، فتركوا للمعمار الحديث بقبحه الطافح وجهامته- فرصة ليزحف ويرمي ظلاله الكئيبة على البنايات الخفيضة الوديعة المسكونة بالتاريخ والفن، فاختلط الحابل بالنابل. وهناك مدن حافظ عليها أصحابها فتركوها على حالها، ولم يمدوا إليها من مظاهر التحديث والحداثة إلا بالقدر الذي لا يأتي على شخصيتها الحقيقة ولا يضيع معالمها الأصيلة ولا يفقدها رمزيتها التاريخية، وحرصوا على أن يجعلوا من البيوت التي سكنها المشاهير أو التي شهدت أحداثا لا تنسى مزارات سياحية.
ويفرق علماء الاجتماع بين المدينة الصغيرة “البلدة” Town وبين المدينة الضخمة Megalopolis والتي هي تشير حاليا إلى ضواحٍ واسعة الأرجاء، تترابط وظيفيا، وكذلك المدينة الكبرى Metropolis وهي تشير إلى المراكز الحضرية الكبرى والضواحي المحيطة بها، وأيضا المجمع الحضري أو البقعة الحضرية Conurbation وهي تشير التجمع الذي يضم مدينة كبرى، تطوقها ضواحي مترامية الأطراف، لتكون بيئة حضرية وصناعية، تنمو باضطراد. وتتدخل الدولة لتربط بين هذه الأحياء عبر شبكة نقل عصرية، بما يوحدها في خاتمة المطاف، لاسيما مع ميلاد الأسواق ومناطق العمل وأماكن التريض والترفيه.
وليس كل أحياء المدينة الواحدة سواءً، فنحن نتحدث دوما عن “قلب المدينة” أو المضغة الأساسية التي نما منها كل هذا الجسد الأسمنتي المترهل ونسميه “Down Town”، ومنه يبدأ الحكماء والفاهمون رحلاتهم لاكتشاف معالم أي مدينة يحلون بها، فيقولون لمن يدفعونهم إلى الفنادق الفارهة والمخادع الناعمة: “نريد أن نرى القلب”. ونتحدث أيضا عن الأحياء الجديدة التي تنمو باستمرار، ويصيب بعضها ما قبله بالقدم، ونفرق بين ما نطلق عليها “أحياء شعبية” يسكنها بسطاء الناس ممن ينتمون إلى الشريحة العليا والمتوسطة في الطبقة الدنيا والشريحة الدنيا في الطبقة الوسطى، وما نسميها “أحياء راقية” والتي يقطنها عليَّة القوم، والشريحة العليا من الطبقة الوسطى. وهي تتفاوت في إمكاناتها بين عمارات تحوي شققا موزعة على أسر عديدة، وبين بيوت وحيدة فخيمة تقطنها أسرة واحدة أو عائلة نطلق عليها “فيللا”.
والصِّنف الأخير من الأحياء هناك قديمة- الذي يحتفظ بعراقته ووضعه الاجتماعي رغم تقادم عمره، وهناك الجديد الذي تنشئه الطبقات الثرية وتقيم حوله الأسوار التي تحميه من أيدي الطامعين من اللصوص والجائعين والمنتقمين والمشردين. وفي الوقت الذي قد ينيخ الدهر على سكان الشطر الأول فتتراجع مكانتهم الاجتماعية وثرواتهم ولا يحتفظون من إمكانياتهم القديمة إلا برائحتها أو ذكرياتها التي يستحضرونها، إما راغبين في إثبات تميزهم، أو من باب المباهاة بأنهم كان لهم مجد ومكانة قد راحت، أو لإخفاء عوراتهم الراهنة التي راكمها الزمن. وهناك من هذا الصنف ما يفقد خصوصيته ورونقه بمرور الزمن، ولا يعطى سكانه حتى فرصة الحديث عن ماضيهم التليد، أو مكانة حيهم التي تراجعت مع تعاقب الأجيال، حيث تكلح البنايات وتتصدع، ويزيد السكان على الحجرات، ويضغطون تحت أقدامهم اللاهثة بقايا الجمال النائم منذ زمن طويل، فيغيب تباعا، ويزحف إلى الشوارع الباعة الجائلين، والعربات الصغيرة الهائمة.
وهناك أيضا الأحياء العشوائية، وهي الضيف الجديد الثقيل على المدينة، الذي أتى إليها مع هجرات القرويين الساعين وراء ما يقيم أودهم، أو الهاربين من الفقر والجوع والمرض والإهمال المزمن، فبعض الآتين منهم إلى المدينة لا يعودون، إنما يبقون هنا باحثين عن مأوى، ولا يجدونه إلا في الزوائد الدودية المشرفة على التعفن، التي تطول جوانب المدينة، أو تسلل إلى داخلها في بعض المواضع، كبيوت متداعية، أو علب أسمنتية مبعثرة، أو عشش وأكواخ من الصفيح، يهزها الريح.
بل وصل تضخم هذه الحالة إلى درجة أننا نجد علماء الاجتماع قد خصصوا لها مصطلحا فريدا هو “مدن العشش” Shanty Towns؟” ، وهي منتشرة في دول العالم الثالث بكثافة، ولا يخلو منها العالم الأول أيضا. ومن سمات هذا النوع من المساكن شَغل الأرض بطريقة غير قانونية، عبر وضع اليد أو التجبر، والتجمع في البقع الاقتصادية ذات القيمة الاقتصادية المتدنية نسبيا، حيث يقوم من وضعوا أقدامهم فيها، أو أياديهم عليها، ببناء بيوت لهم بلا تراخيص قانونية، ودون التقيد بشروط العمران التي حددتها الدولة، ولذا تعاني هذه المباني من نقص المرافق والخدمات. وقد تمتد لها يد أهل الحكم والإدارة فيما بعد محاولة أن تنظم المبعثر منها، وتوفر الخدمات مثل المياه العذبة والصرف الصحي والكهرباء وتعبيد الشوارع المتعرجة وتشجيرها، وكذلك مكافحة الجرائم الساكنة فيها.
ويبقي للقاهرة وضع خاص، لا يعرفه غيرها من المدن، وهو “سَكنى المقابر”، إذ في مصر، التي قدست الموت وقدرت الموتى منذ آلاف السنين، يمكن للأحياء أن يعيشوا مع الأموات في مكان واحد. نظرا لتفاقم أزمة السكن، ومع تميز المقابر المصرية بالامتداد الأفقي الكبير، علاوة على أن مناطق المقابر مهندسة ومنتظمة حيث الشوارع المتقاطعة الوسيعة، بما تحرم منه العشوائيات، فضلا عن تشجيرها، بما جعلها منطقة جذب بالنسبة للطبقات الفقيرة، لاسيما بعد أن أحاطت المباني الحديثة بمناطق “القرافات”، وأصبح بعضها أقرب إلى قلب المدينة من أحياء كثيرة، ترتفع فيها أسعار الشقق، ولا يستطيع تملكها إلا القادرون.
وهناك مدن عربية عرفت ظاهرة “المخيمات” التي يقطنها اللاجئون، والمخيم حسب تعريف الأونروا” هو “قطعة من الأرض، تكون إما حكومية أو في أغلب الحالات استأجرتها الحكومات المستضيفة من الملاك المحليين، ووضعتها تحت تصرف الأنروا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في تسهيل احتياجاتهم الأساسية، ولا يمكن لسكان المخيمات تملك هذه الأراضي، ولكن لهم الحق في الاستفادة منها للسكنى فقط”. وتعد “المخيمات الفلسطينية” المتواجدة في لبنان والأردن والضفة الغربية لفلسطين مثالا واضحا على ذلك، وهي تعاني من كثافة سكانية كبيرة، وفقر مدقع، وقلة في الخدمات، وتراجع مستوى البنى التحتية. وإثر تحول الثورة السورية إلى حرب أهلية نزح ملايين السوريين إلى الأردن وتركيا ولبنان، وقطنوا مخيمات جديدة.
وقد انشغل الأدباء بهذه التجمعات السكانية البائسة، سواء كانت عشوائيات أو قرافات، ليبحثوا فيها عن قصص غير عادية لا تعرفها المدينة. وفي وقت مبكر تنبه يوسف إدريس إلى سكان مثل هذه الأحياء فكتب روايته القصيرة “قاع المدينة”، لكن الجيل الجديد من الروائيين المصريين أعطى لهؤلاء مساحة واسعة في إبداعه القصصي والروائي، ولعل رواية “فاصل للدهشة” لمحمد الفخراني هي الأبرز في هذا المضمار. وعلى المنوال ذاته سارت السينما، فبعد عقود من الحديث عن الواقعية التي بدأت بفيلم “العزيمة” جاء مطلع الألفية الثالثة ليجد السينمائيون أمامهم نماذج اجتماعية جارحة لا يمكن إغفالها، فولد فيلم مثل “حين ميسرة” وما على شاكلته.
والتوزع المعماري لأحياء المدن، المتفرق على عتبات التاريخ يعكس الصراع الاجتماعي الضاري بين الطبقات، ويرسم ملامح سكان المدينة، وطبيعة المشكلات التي يعانون منها مثل الجريمة المنظمة والفردية حيث السرقة دوما، والنهب والسلب أحيانا، وتفشي البطالة الجارحة، ووجود الآلاف من المشردين الهائمين على وجوههم وتحت الجسور سواء من أطفال الشوارع أو بعض المرضي النفسيين الذين لفظهم أهلهم أو هربوا هم منهم ولا يجدون لهم مكانا في المصحات المكتظة بنظرائهم، وانتشار ظاهرة الإدمان على المخدرات والإتجار بها، علاوة على التعصب العرقي والمذهبي، والتهميش الاجتماعي، والتوتر المستمر بين أرباب العمل والعمال، والزحام وأزمات المرور، والغش التجاري.
وليس كل سكان المدينة سواء، فهناك من ولدوا فيها، فشربوا من طباعها الخشنة، وتواءموا مع تجهمها وقلة اعتنائها بأهلها وهناك من أتوا إليها بعد أن ناموا طويلا بين جدران الطمي، ومشوا على الجسور وسط عجيج ترابها يطالعون الزرع والضرع، وسمعوا من الجدات الجالسات فوق تلة الزمن حكايات عن الخير الذي يفوز حتما، والشر الذي ينهزم دوما. يتقابل أفراد هذين الفريقين في شوارع المدينة، ويتفاعلون بلا انقطاع، من خلال التجاور في السكن، وعلاقات العمل، وتبادل المنافع والمصالح، وتقسيم الجهد، وتوزع التخصصات.
والمدينة هي القبلة الدائمة التي يحلم أغلب أهل الريف بالتوجه إليها، ليس فقط للبحث عن الرزق أو التحقق، إنما أيضا من أجل المتعة والنزهة والترفيه. ففي المدينة توجد دور السينما والمسارح والملاهي والمتنزهات والمكتبات والمتاجر الكبرى التي تبيع كل شيء. وفيها يمكن لابن القرية أن يكون أكثر حرية، حيث لا أحد يعرفه، ولا أحد يعد عليه أقواله وأفعاله، لكنه بالقطع سيكون غريبا، خاصة إن كان فقيرا معدما، أو لم تكن لديه خبرة سابقة في التعامل مع المدينة وأهلها.
وقد عبر الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي عن هذه الحالة ببراعة في قصيدته “الطريق إلى السيدة” ضمن ديوانه الأول والأشهر والأجمل “مدينة بلا قلب”، حيث يقول في مقطعها الثاني:
“وسرت يا ليل المدينة
أرقرق الآهة الحزينة
أجر ساقي المجهدة
للسيدة
بلا نقود، جائع حتى العياء
بلا رفيق
كأنني طفل رمته خاطئة
فلم يُعِره العابرون في الطريق
حتى الرثاء”.
ويصل الاغتراب إلى ذروته في المقطع الأخير من القصيدة، والذي يوضح كيف لا تتصافح الأيدي ولا تتلاقي الوجوه التي تتصادف في الشوارع، ولا تتبادل حتى الابتسامات، بل يمضي كل منهم إلى غايته، غير عابئ بغيره أبدا. وهنا يقول الشاعر:
“والناس حولي ساهمون
لا يعرفون بعضهم .. لا يعرفون
هذا الكئيب
لعله مثلي غريب
أليس يعرف الكلام؟
يقول لي .. حتى سلام”.
بل يجدد الشاعر نفسه لوعته وغربته في قصيدة أخرى بعنوان “مقتل صبي”، حيث يقول:
“الموت في الميدان طن
العجلات صفرت، توقفت
قالوا: ابن من؟
ولم يجب أحد
فليس يعرف اسمه هنا سواه
يا ولداه!
قيلت، وغاب القائل الحزين
والتقت العيون بالعيون
ولم يجب أحد
فالناس في المدائن الكبرى عدد
جاء ولد
مات ولد”.
وفي القرن العشرين بات زحف الحضر من أبرز مظاهر العولمة، كما يقول عالم الاجتماع الإنجليزي أنتوني جيدنز، وتجاوز الأمر تلك المدن التي عرفها العالم القديم والوسيط، حيث بدأت الكرة الأرضية تعرف في النصف الثاني من القرن المذكور، طريقها الوسيع نحو انتشار المدن، وبدأت نسبة سكانها إلى مجموع سكان الكوكب تتعزز بمرور السنين، حتى بات من المتوقع أن يصلوا إلى 63% مع نهاية الربع الأول من القرن الحادي والعشرين.
وكما يقول باتريك جديس فإن المدينة “ليست مجرد مكان في الفراغ فحسب، وإنما هي أيضا دراما مستمرة طيلة الوقت”، وجزء من هذه الدراما أن المدينة فاعل سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي قوي، فهي مجتمع تعددي حيث الدرجات المتفاوتة بين سكانه من حيث العوز والكفاية، ومن زاوية المشارب الفكرية والاتجاهات السياسية التي يعتنقونها، وكذلك من باب تنوع الأنشطة الاقتصادية. فعلى خلاف مع القرية التي يعمل معظم سكانها في الزراعة وما يرتبط بها من رعي وتجارة وطحن وخبز وتصنيع أدوات العزق والحرث والحصاد والدرس، فإن سكان المدن يعملون في مهن عدة، مثل الصناعة والتجارة والخدمات والإنشاء، وكذلك المهن المتخصصة في الطب والمحاماة والصحافة والمحاسبة والتدريس وغيرها.
وجاءت العولمة لتزيد من قدرة المدينة على أن تكون فاعلا في كافة مجالات الحياة ودروبها، لأنها راكمت على رأسها مشكلات جديدة تخص البورصة والبيئة واقتصاديات المعرفة ومواقع التواصل الاجتماعي التي زادت أهل المدينة اغترابا على غربتهم المزمنة. وراحت الأنظار تتجه إلى قياس مدى إسهام المدينة في الإنتاج الاقتصادي، وتطوير الدولة ودفعها إلى الأمام، مع قدرتها على مجابهة تحديات العمل وحفظ الأمن والحاجة المتجددة إلى السكن، وقدرتها كذلك على صهر “الثقافات الفرعية”، التي تتجاور وتتفاعل، في سبيكة واحدة متناغمة، أو على الأقل تتمكن من تقليص حجم الصراعات الناشبة بينها، أو إحداث حالة من التوافق تساعد على منع حدوث اضطرابات اجتماعية وسياسية أو التقليل منها إلى حد بالغ.
ووسط هذا التفاعل المتواصل، عبر شبكات معقدة، تنشأ الحاجة الماسة إلى التمثيل السياسي والمشاركة في صناعة القرار السلطوي، والمطالبة بالحقوق المدنية. وهنا تنشأ مؤسسات وهيئات الدولة الحديثة، حيث الأحزاب السياسية، وقوى المجتمع المدني، والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، وجماعات الضغط، والروابط المهنية والعلمية، وتلك التي تجمع أهالي الأطراف القاطنين للمدينة، والتحالفات السياسية، والهيئات الثقافية، والجمعيات الخيرية، والائتلافات الشبابية، ومختلف الحركات الاجتماعية التي تتوزع على بعض مجالات الحياة، وعلاقات السوق المتدرجة، وكل العناصر التي تغذي التنافس، وقد تنحدر إلى صراع ضار، يزيد المدينة غربة وتوحشا.