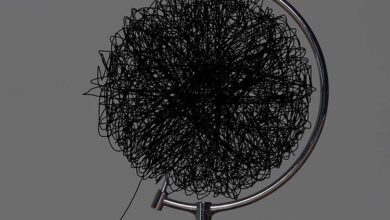الثورة السورية هي أطول الثورات أمدًا وأكثرها دموية وتدميرًا وضحايا، ولسوء قدر سورية وشعبها أن تكالب عليها عدة قوى إقليمية ودولية، إضافة إلى التنظيمات التكفيرية والإرهابية والمرتزقة، وتعددت أسباب استهداف سورية وفي مقدمتها ليس تغيير النظام السوري فحسب، بل هدفت القوى الخارجية إلى التأثير في مجمل أوضاع النظام الإقليمي العربي؛ لتحقيق تسويات للقضايا الإقليمية التي ما زالت معلقة في المنطقة وفي مقدمتها بطبيعة الحال بقايا الصراع العربي – الإسرائيلي، والقضاء على الدول التي ما زالت تقاوم مخططات التوغل الإسرائيلي في الأراضي العربية، وعلى رأسها (سورية، ولبنان)، الدولتان المتجاورتان لإسرائيل، والوحيدتان اللتان لم توقعا حتى تاريخه على اتفاق سلام مع الدولة المحتلة لفلسطين .
فكان لابد من القضاء على مقاومة سورية -بصفة خاصة- وإلغاء دورها الإقليمي المعارض لإسرائيل، وشعارات المقاومة ومواقفها التي ترفعها وتتخذها في المنطقة العربية، كما سبق إنهاء الدور الإقليمي للعراق بعد الاحتلال الأمريكي له، وهذا قد يدعو إلى التمعن فيما ذكره مناحم بيجن في مذكراته تحت عنوان “التمرد”، وورد فيها ” آن الأوان للعرب أن يشيعوا جنازة العروبة “، مضيفًا في فقرة تالية عبارة لها أكثر من دلالة ومعنى ” لو تم التوصل إلى السلام مع أي دولة عربية أو أكثر فإن هذا لا ينهي رسالتنا الأساسية، ألا وهي إنهاء حضارة العرب وإقامة حضارة اليهود” .
أما بالنسبة للكتاب فهو مقسَّم إلى (مقدمة، وثمانية فصول، وخاتمة)، الفصل الأول والثاني: يتحدث الكاتب فيهما عن مسيرة بشار الأسد وطريقة تعامله مع الانتفاضة السورية .
و كما هو معلوم في سورية أن أهم ركائز الإمساك بالسلطة يتمثل بالجيش، وبدرجة أقل بالحزب، لذا حرص الرئيس الراحل “حافظ الأسد” على تأسيس قاعدة تأييد لبشار داخل المؤسسة العسكرية، عن طريق شق مسار عسكري سريع له، من خلال إلحاقه بالخدمة العسكرية وترقيته سريعًا على سلَّم الرتب العسكرية، فالجيش في سورية ظل مصدرًا أساسيًّا لشرعية السلطة وكسب التأييد السياسي بالنسبة إلى كل من يريد شق طريق إلى القمة.
وساد الاعتقاد بعد ذلك أن الرئيس “بشار الأسد” سيدخل التغيير الجوهري والضروري في الواقع السوري، وهكذا تولى صلاحيته كرئيس لسورية وسط موجة ترقب للتغيير المأمول، وقدم نفسه في خطاب التنصيب في 17/7/2000، كحامل لبشرى التغيير والإصلاح .
ولكن يبدو أن الرئيس تراجع عن المباشرة بالإصلاحات الأساسية التي وعد بها، والتي تعكس تغيرًا جوهريًّا في إعادة بناء الدولة السورية التي كانت في أمس الحاجة إليها ، واكتفى في هذه المرحلة بتحسين الأداء الحكومي .
أما على المستوى الخارجي ازداد الاقتناع بأن سياسة سورية ومواقفها الخارجية أصبحت تشكل عبئًا في الداخل وثقلًا يفوق قدرات سورية على التحمل، وهو ما دفعها إلى الانسحاب من لبنان على نحو وصف بأنه كان انسحابًا من ورطة لبنان .
ففي عهد الرئيس “حافظ الأسد”، كان هناك تحكم في حدود الحركة الإقليمية لإيران، التي تستخدم سورية جسر عبور إقليمي ولا يُسمح لإيران بتجاوزه .
أما في عهد الرئيس “بشار الأسد”، ونتيجة لتعرض سورية لضغوط غير عادية استطاعت إيران أن تتجاوز الحدود السابقة، إذا كان النظام السوري يمر في أوضاع وظروف استثنائية ، وفي عزلة عربية استفادت إيران منها للإقدام على المزيد من الحركة السياسية الإقليمية المتجاوزة عبر القناة السورية وتحول منها ” تحالف الضرورة ” أيام الرئيس حافظ الأسد إلى تحالف ” المصير المشترك ” في عهد بشار الأسد.
ويتساءل الكاتب هل كانت سورية بحاجة إلى إستراتيجية جديدة لمواجهة المتغيرات والتحديات الإقليمية الدولية؟
وعلى كلٍ فيظهر من خلال تتبع مواقف الرئيس بشار الأسد في مرحلة البدايات الأولى للحركة الاحتجاجية أنه كانت تتنازعه عدة توجهات، ففي خطابه أمام الحكومة الجديدة في 16/4/2011، ابتعد عن مفردات الفتنة والمؤامرة وركز على ضرورة الإصلاح وأقر بشرعية التظاهرات الشعبية وأحقية مطالب الناس.
وصدر في 19/4/2011، مشروع مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين لكونه حقًّا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور، وكان هذا الموقف تحولًا إيجابيًّا من جانب النظام .
وبدأت تتردد فكرة إنجاز تسوية استباقية مع المجتمع، تربط بين متطلبات استمرار النظام وتحقيق مطالب المجتمع تدريجيًّا، وهذا أمر أبدى الرئيس بشار رغبته في تحقيقه منذ وصوله إلى السلطة عام 2000، لكن يبدو أنه تراجع عن ذلك بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية، وأخطار التهديدات التي أحاطت بسورية، فظروف كهذه لم تسمح له بالإقدام على إصلاحات جوهرية للنظام؛ لأن الأولوية كانت التصدي للمؤامرات التي تُحاك ضد سورية.
أما عن الثورة فيشير الكاتب أن هناك قوىً إقليمية تتقدمها تركيا كانت تسعى إلى قلب نظام الحكم في سورية، فاحتضنت (عناصر الجيش السوري الحر، والمرتزقة،… وغيرهم)، وبادرت في مطلع عام 2012 برعاية واشنطن، إلى اتخاذ قرار يُعد نقطة تحول خطيرة في مسار الصراع السوري، وهو الاستعانة – علنًا- بالمنظمات الجهادية والتكفيرية والمرتزقة وفي مقدمتها (داعش، وجبهة النصرة) .
انجذاب بعض المواطنين السوريين إلى تلك التنظيمات التكفيرية وحمل السلاح والمشاركة في بعض عملياتها ناجم عن موت السياسة وغلبة مفهوم ” المواطن المتلقي” وليس “المواطن المتفاعل”، وكانت النتيجة أن العامل الخارجي كان الأكثر تأثيرًا في مسار الحركة الاحتجاجية السورية، واستطاعت مجموعات جهادية وسلفية متطرفة السيطرة على مسارها، وساهمت في إنهاء وجهها السلمي الذي كان يشكل أهم أسباب التعاطف مع سلمية الحركة الاحتجاجية.
وبصفة عامة كسر تصاعد الاحتجاجات، سواء سلمية أو مسلحة، جدار الصمت والخوف معًا، فتحولت الحركة الاحتجاجية، أو حولت من حركة سلمية إلى مواجهة مسلحة، بعد توافر مصادر التسليح والتمويل لبعض فصائل المعارضة سواء من مصادر محلية أو مصادر إقليمية ودولية .
أما عن الدور الأمريكي المؤثر في مسار الأزمة السورية فيحدثنا الكاتب أن الرئيس الأسبق “أوباما”- قبل نشوب الأزمة السورية- كانت هناك علاقات ذات طابع مختلف بين (واشنطن، ودمشق)، وواصل السعي إلى تطوير الدور السوري وأوراقه الإقليمية، فواشنطن كانت حريصة على تهدئة الأوضاع في العراق بصفة خاصة؛ لاستكمال خروج مشرف وآمن للولايات المتحدة، وما يتطلبه ذلك من استقرار أمن للحدود المشتركة العراقية – السورية ومنافذها.
وقد مرت الأزمة السورية في أغلب مراحلها في عهد إدارة الرئيس أوباما (2011-2017)، وكان الرئيس الأمريكي يعدها خارج الأولويات الإستراتيجية للولايات المتحدة، ولم ترقَ إلى مستوى التحدي المباشر للأمن القومي الأمريكي، وعندما احتدت الثورة السورية تصاعدت لهجة الإدارة الأمريكية ضد النظام ووصلت إلى حد دعوة الرئيس بشار الأسد إلى التنحي عن السلطة .
وقد نجح أوباما في مقاومة الاتجاه الداعي إلى التدخل العسكري في سورية، فالتكلفة المالية والخسائر البشرية التي كابدتها الولايات المتحدة في حربها على العراق وأفغانستان، فرضت على إدارة أوباما العدول عن أي تدخل عسكري محدود أو موسع في الأزمة السورية، وانتهاج سياسة ” التفاعل الحذر”. وهناك اعتقاد أن مواقف إدارة أوباما تبنَّت أسلوب استمرار التقاتل الداخلي بين أطراف الصراع في سورية إلى أن يقضي أحد طرفي الصراع على الآخر، وبالنتيجة خروج سورية ممزقة سياسيًّا وعاجزة عسكريًّا ومحطَّمة شعبيًّا، وهذا الوضع الأمثل للولايات المتحدة الذي يضمن في النهاية أمن إسرائيل .
كما أن الأزمة السورية تزامنت في هذه المرحلة مع تركيز أوباما على التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران وهي تدخل من ضمن حساباته في الأزمة السورية، وهنا ظهر التردد الأمريكي مرة أخرى من تلك الأزمة لحساسية أوباما من تأثير ذلك في المفاوضات مع إيران .
أما الفصلان الثالث والرابع: يتحدث الكاتب فيهما عن تركيا ودورها التآمري على سورية، من بداية عهد الرئيس السابق “حافظ الأسد”، حيث اتسمت العلاقات بين البلدين بالتوتر إن لم يكن بالعداء؛ بسبب علاقة تركيا الوطيدة بإسرائيل وقضايا المياه والسدود وعلاقة سورية بحزب العمال الكردستاني، ومع تولي الرئيس بشار الأسد السلطة في عام 2000، انتقلت العلاقات بين البلدين إلى مرحلة جديدة تُوِّجت بزيارة الأسد لتركيا عام 2004، وردَّ أحمد نجدت سيزر- رئيس تركيا وقتئذٍ- الزيارة في عام 2005، وتم خلالها توقيع عدة اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات، وعبرت العلاقات الثنائية إلى مرحلة أكثر تطورًا نتيجة اعتماد رؤية أحمد داود أوغلو المتعلقة بـ” العمق الإستراتيجي”، واتجهت السياسة الإقليمية التركية إلى تبني مفهوم يقوم على تعدد المحاور وتنوعها بهدف جعل تركيا ” دولة مركزية” .
ودخلت العلاقات بين البلدين مرحلة أكثر تطورًا مع إنشاء مجلس التعاون الإستراتيجي التركي – السوري عام 2009، وأُجريت في العام نفسه مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين .
ثم جاءت مرحلة ثورات الربيع العربي فغيرت تركيا سياساتها الإقليمية وبدأت تخطط لمزيد من التدخل في شؤون المنطقة العربية، وانتقل خلالها الإسلام السياسي مرحليًّا من منطقة الهوامش إلى المركز وبدأت تركيا تقوم بدور “الأب الروحي” للحركات الإسلامية في المنطقة وعبر احتضانها التيار الإسلامي المعارض في سورية، على أمل أن تصبح أنقرة صاحبة النفوذ والكلمة الفصل مستقبلًا.
يُضاف إلى ذلك أن تركيا رأت أن انفراد إيران بالنفوذ في العراق بعد سقوط الرئيس “صدام حسين”، إضافة إلى وجود نفوذ إيراني كبير في سورية، سوف يطوق تركيا بهلال نفوذ إيراني يمتد من حدود أرمينيا إلى ساحل المتوسط؛ لذلك عندما اندلعت الانتفاضة السورية عام 2011 لاحت لتركيا فرض هيبة لتغيير موازين القوى وتصحيحها لمصلحتها، وبدأت تخطط لإسقاط النظام السوري المؤيد لإيران، ناهيك عن التخوف التركي من تأسيس دولة كردية على امتداد حدودها وكان هذا ملمحًا جوهريًّا للسياسة التركية ضد أكراد العراق في التسعينيات والآن امتد ليشمل أكراد سورية، وتخشى أنقرة استغلال أكراد سورية أو الحديث عن مصطلح الفيدرالية في سورية، وقتها سيصبح هناك حكم ذاتي لأكراد العراق .
أما عن المواقف الإسرائيلية في مسار الأزمة السورية، فيقول الكاتب: “إن القيادة الإسرائيلية اعتمدت حيال الأزمة السورية ” الثورة السورية” على ثلاثة مسارات :-
- المسار الأول: العمل على استمرار الأزمة لأطول حقبة ممكنة، وهو ما يؤدي إلى إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد وإضعافه، وإنهاك الجيش السوري وتدمير مقوماته.
- المسار الثاني: السعي إلى إنشاء دويلات تحقق التناسق الجغرافي، والديمغرافي، والديني لأطياف المجتمع السوري ومكوناته .
- المسار الثالث: إسقاط نظام الرئيس الأسد والمجيء بنظام جديد يتسم بصبغة إسلامية سُنية، يسقط ركنًا أساسيًّا من محور الممانعة ويحرم حزب الله من الدعم السوري .
أما الفصلان الخامس والسادس: فيستكمل الكاتب حديثه عن القوى العظمى الموجودة في المنطقة ودورها في الأزمة السورية، حيث لاحظت القيادة الروسية حماسة الإدارة الأمريكية في عهد أوباما لقادة الإسلام السياسي في العالم العربي، وعدم ممانعة وصوله إلى السلطة، فقد اتجهت روسيا من بدايات الانتفاضة السورية إلى دعم النظام السوري، ولم تكن متحمسة لأي من الثورات العربية وانتابها حظر مبكر وريبة من وصول الإسلاميين إلى السلطة، وتزامن نشوب الثورة في سوريا مع استعداد روسيا لأداء دورها على الصعيد العالمي بوصفها دولة عظمى، بعدما أثبتت نفسها في جورجيا، ومقتنعة أن الولايات المتحدة سوف تبدأ تراجعًا منظمًا من منطقة الشرق الأوسط، بعد فشل التجربة الأمريكية في (أفغانستان، والعراق)، وبعد اكتشاف طرائق استخدام النفط الصخري، وتراجع اهتمامها المباشر بالمنطقة، عدا ما يتعلق بالخليج وإسرائيل وضرورة مكافحة الإرهاب.
وقد أدركت القيادة الروسية أن الحرب في سورية هي حرب ضد مصالح روسية، فقبل التدخل العسكري الروسي المكثف في سورية بأربع سنوات بادرت روسيا إلى التصدي للقرارات الدولية ضد النظام السوري، فصدرت تعليمات لدى مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة باستعمال الفيتو ضد قرارات مجلس الأمن؛ دفاعًا عن النظام السوري.
إلا أن التدخل الروسي ألقى الضوء على التدخل الأمريكي، وفضحه، فالولايات المتحدة لا تريد شركاء خارج نطاق حلفائها قد يسهموا في إعادة التشكيل السياسي لمنطقة الشرق الأوسط، ولكن تحت ضغط تطورات المنطقة، قبلت إدارة أوباما التدخل العسكري الروسي كأمر واقع من ناحية؛ آملةً من ناحية أخرى أن تتورط روسيا الاتحادية في المستنقع السوري مثلما حدث في أفغانستان.
وهنا يتبادر لنا أن نطرح سؤال هل نجح التدخل الروسي في إحداث اختراق لواقع الأزمة السورية والاقتراب من الحل السياسي؟
ثم يتطرق الكاتب إلى الأزمة السورية من منظور الدور الإيراني فيها، حيث أن الموقف الإيراني من بدايات الحركة الاحتجاجية في سورية متوقعًا، فقد طالب الرئيس الإيراني “أحمدي نجاد” النظام السوري بوقف العنف ضد المحتجين، ناصحًا بأن الحل العسكري ليس الخيار السليم، وربما كان ذلك موقفًا تكتيكيًّا مرحليًّا متأثرًا بما كان يتردد على نطاق واسع حول استخدام العنف ضد المتظاهرين والهتافات التي ترددت على نطاق واسع، وسرعان ما تبدل هذا الموقف؛ ربما لاكتشاف إيران بعض الحقائق عن تدخلات الأطراف الخارجية على نطاق واسع في مسار الأزمة السورية على نحو أدى إلى اقتراب النظام السوري من السقوط، فسارع النظام الإيراني إلى رمي كل ثقله خلف هذا النظام ردًا للجميل، حيث كان النظام السوري واقفًا وداعمًا لإيران خلال حربها الطويلة مع العراق في عهد الرئيس صدام حسين .
وجاء التدخل العسكري الإيراني في الأزمة السورية الراهنة بِناءً على استدعاء سوري رسمي، وهو ما كانت تدافع به كل من (إيران، وروسيا) عن الوجود الإيراني في مواجهة المطالب الإسرائيلية والأمريكية بخروجها من سورية، فالوجود العسكري الإيراني في سورية تم بناء على طلب من الحكومة السورية وهو لذلك وجود شرعي على العكس من الوجود الأمريكي أو التركي.
وقد تم توقيع اتفاق إستراتيجي طويل الأمد بين إيران وسورية، وهذا التحول فرضه تداعيات الأزمة السورية التي كادت تسقط النظام السوري نفسه.
فضلًا عن ذلك كانت سورية في تقدير القيادة الإيرانية، جبهة متقدمة في محور إستراتيجيتها في المنـــــــطقة، فإذا انهارت يأتي دور الجبهة الإيرانية، لذا قامت إيران بمساعدة سورية على جميع الأصعدة، فقامت بتشكيل وحدات عسكرية غير نظامية للقتال إلى جانت قوات النظام السوري، إضافة إلى التنظيمات المسلحة التابعة لها، فضلًا عن حزب الله اللبناني، كما عملت على تزويد السلطات السورية تكنولوجيًّا.
وعلى كلٍ فلولا مبادرة إيران وحزب الله والتدخل الكثيف، والدعم المادي واللوجستي والبشري لمواجهة تداعيات الأزمة السورية داخليًّا وخارجيًّا، لانهار النظام السوري وتغير الوضع الجيوسياسي، الذي تمثله سورية في الصراع العربي – الإسرائيلي في مواجهة المشاريع الأمريكية في المنطقة .
ويرى المحللون أن دخول روسيا بعد ذلك وقبلها إيران وحزب الله، على خط الحرب في سورية، كان عامل تعويض لنقص القدرات العسكرية والتسليحية للجيش السوري، الأمر الذي مكَّنه من الصمود أمام جحافل المرتزقة والقوى التكفيرية التي تدافعت إلى الداخل السوري عبر الحدود المشتركة التركية – السورية .
أما الفصلان السابع والثامن: فيتحدث فيهما عن المواقف العربية من تطورات الأزمة السورية ، حيث تتلخص في :-
- خشية استمرار الثورات الاحتجاجية اتجاه الدول العربية الأخرى إثر السقوط المتوالي للنظم العربية .
- تأثير التيارات السلفية في بعض من الدول العربية، وبعضها بلغ مستوى من القوة والفاعلية والتصرف على نحو شبه مستقل في دعم الجماعات السلفية الجهادية التي تغلغلت في الداخل السوري، وهو ما أدى إلى خلل كبير في علاقات القوة داخل مجموعات ” الثورة السورية ” برمتها وأسفر عن استقواء العنصر السلفي منها على حساب العناصر المتدينة الأخرى .
- الدمار الذي حصل في سورية كان الدرس الأشد تأثيرًا لدى الشعوب العربية، كما أن ما حدث لشعوب الدول التي ثارت كان بمنزلة فزاعة أسهمت في تكبيل شعوب عربية أخرى من إمكان الخروج على أنظمتها، وهذا درس مرير مفاده أن كل سيئات أي نظام قائم تبقى أفضل كثيرًا من الانحدار نحو مصير مشابه للمصير السوري التدميري .
- مواجهة النفوذ والتدخل الإيراني في مسار الأزمة السورية الذي أيقظ بعض دوائر صنع القرار في بعض الدول العربية على بقاء النظام السوري في محور المقاومة .
أما عن تدخل جامعة الدول العربية فعلى حسب قول الكاتب كان تدخل غير مسبوق، ذلك باستنكار استخدام أسلوب القمع ضد الحركة الاحتجاجية داخل سورية وفقًا للانطباع الذي أشادته القنوات الفضائية العربية والأجنبية، والتي أخفت على نحو متعمد دور المرتزقة من التنظيمات الإرهابية، أضف إلى ذلك تكالب عدة قوى خارجية على سورية وشعبها، وبعد طرح الجامعة العربية خطة عربية متكاملة العناصر وكانت بمنزلة خريطة طريق إلا أنه بعد ذلك قررت الجامعة العربية تجميد عضوية سورية، وبالتالي عدم مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها .
ثم يضيف الكاتب “إنه بعد مرور السنوات العجاف على الشعب السوري، الذي تشتت بين مخيمات النزوح في الداخل واللجوء للخارج ومعاناته لأوضاع إنسانية صعبة جدًا في ظل أزمة طال أمدها بفعل التكالب غير المسبوق على دولته التي كانت جريمتها الدفاع عن أراضيها المحتلة” .
إن التدخلات الإقليمية والدولية في مسار الأزمة السورية أدى إلى تراجع أدوار الأطراف المحلية المنخرطة في الأزمة السورية لحساب قوى خارجية أصبحت المتحكمة في توجيه مسارها، من غير الاهتمام بمعاناة الشعب ومصالحه .
وإذا كانت للقوى الدولية والإقليمية المتداخلة في الأزمة السورية أهدافها ومصالحها، فإن ذلك لا يعني عدم التنسيق بينها، فالتنسيق كان متواصلًا ويشارك فيه ممثلون من أجهزة الاستخبارات الإقليمية والأجهزة الأمريكية، عدا اجتماعاتها المنتظمة في إسطنبول وأضنة لتوزيع أدوار المؤامرة الكبرى، فقد شكلت مثلًا غرفة عمليات في هاتاي التي كانت بمنزلة مركز رئيس لتوفير الدعم اللوجستي للتنظيمات التكفيرية، وشارك في اجتماعاتها ضباط من (فرنسا، وبريطانيا، وأمريكا، وتركيا، وآخرون)، وأنشأت غرفة عمليات في مدينة أضنه التركية، وهو ما سمح لتركيا بالإشراف على تدفق الأسلحة التي يتم تسريبها إلى المرتزقة في الداخل السوري بغية تعزيز سيطرتهم على الأرض السورية، حيث جمعت سائر الأطراف المعادية لسورية وشعبها .
والآن بعد عِقد من الزمن تم تدمير كيان دولة وتشريد شعب، عبر مؤامرة متعددة الأطراف، بدأت الدول المعنية تراجع موقفها وبينها أطراف عربية وأخرى أوروبية، وتفكر في إعادة فتح سفاراتها في دمشق، إذ أدركت متأخرة مواقفها وسياساتها حيال الدولة السورية وشعبها .