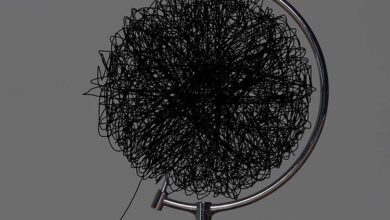هذا الكتاب يحاول فيه كاتبه قراءة المستقبل وتنطلق تلك القراءة من تحليل دقيق وعميق لما يجري في الواقع المعاصر من أحداث هي نفسها تداعيات لأحداث سابقة عليها، وبالتالي فهي بلا شك تمثل مقدمة لأحداث تالية.
والقضية الأولى في هذا الكتاب تناقش الصورة العامة للأحداث القادمة وتناقش الملامح الأساسية لصالح هذه الأحداث، وهل سيستمر اللاعبون الأساسيون على سيرك الحياة المعاصرة أم أنهم سيتغيرون بعد ما طال بهم الزمن وآن الأوان لاستبدالهم و زوال هيبتهم وتسلطهم ؟!
أما القضية الثانية، فهي محاولة للتدليل على الرؤية الفلسفية العامة للمستقبل، فرغم ما تقدمه من براهين على أننا لم نعد نعيش عصر ما يُسمى العولمة، وأن انهيارها أصبح حتميًّا مع انهيار أسسها وقادتها، ومع تنامي رفض بقية شعوب العالم لقيمها ولهيمنة قادتها، كما تم وضع صورة لما بعد العولمة وكيفية نشوء الدورة الحضارية التالية وأهم معالمها.
وبالنسبة للكتاب فهو مقسَّم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول بعنوان “قراءة في مستقبل التفاعل الحضاري”، حيث يقول الكاتب إنه رغم زخم الحديث عن العولمة وتأثيره الطاغي في كل أنحاء العالم على كافة الأصعدة (ثقافيًّا، وسياسيًّا، واقتصاديًّا، ومعرفيًّا)، فيعتقد الكاتب أن عصر العولمة أوشك على الانتهاء، وأن الحديث عن نظام عالمي تقوده الحضارة الغربية ممثلة في (أمريكا، وأوروبا)، وتهيمن عليه الأولى بقوتها العسكرية والاقتصادية بامتلاكها معظم آليات الهيمنة الثقافية والمعلوماتية_ أصبح حديثًا لا يخلو من مخاطر الوقوع في براثن النظرة أحادية الجانب، وهي نظرة أصبحت حسب ما يرى كثير من المحللين والمفكرين محل شك !
ويكمل الكاتب حديثه إن استشراف المستقبل ينبغي ألا يدور حول الحديث عن العولمة، بل حول التساؤل عن “ما بعد العولمة”، وحول المعالم الرئيسة والتفاعلات الحضارية لهذا العصر الذي يراه الكاتب قريبًا، ويعتقد أن الخمسين عامًا القادمة ستشهد بزوغ دورة حضارية جديدة تلي هذه الدورة الحضارية التي شهدت سيطرة أوروبا ثم أمريكا على العالم طيلة القرون الثلاث السابقة على الألفية التي نعيش بداياتها الآن.
ثم ينتقل الكاتب بحديثه بعد ذلك إلى موضوع مستقبل التفاعل الحضاري فيما بعد العولمة، وهنا يقول “إن الاهتمام بقراءة المستقبل أصبح الشغل الشاغل لكثير من المفكرين والمحللين السياسيين والاقتصاديين ومنظري السياسات العالمية، وتتراوح قراءة كل هؤلاء للمستقبل حول ثلاثة احتمالات: احتمال نشوب صراع حضاري يأخذ صورة الصدام المسلح، والثاني يرى أصحابه أن الحوار السلمي بين الحضارات كفيل بإزالة أسباب هذا الصراع التصادمي، أما الاحتمال الثالث فهو مزيج من الاحتمالين السابقين؛ حيث إن الصراع التصادمي والحوار المترتب عليه يمكن أن يحدث من خلالهما تفاعلان يؤديان إلى بروز قوى جديدة، مما يعد تبشيرًا ببداية حقبة حضارية جديدة لا يهيمن عليها قطب عالمي واحد أو قطبان، بل تتعدد فيه الأقطاب حسب الأثقال النوعية والجغرافية التي ستتولد عن كل من الحوار والتصادم “.
ثم يضيف الكاتب إنه ومن خلال قراءة مستقبل التفاعل الحضاري والتنبؤ بصعود الشرق الآسيوي المرشح لقيادة الدورة الحضارية القادمة، إن هذه الحقيقة تتمثل في أن المستقبل ببساطة لا لأمريكا ولا للغرب رغم هيمنتهما الحالية ورغم سطوتهما الأمنية، وإنما المستقبل سيكون في يد الشرق الآسيوي.
ولذلك يعتقد الكاتب أن مستقبل العرب الحضاري مرهون بثلاثة عوامل متشابكة وينبغي العمل معًا بشكل متوازن ومتوازٍ وهي باختصار :-
- البناء الذاتي لعناصر القوة (اقتصاديًّا، وعلميًّا، وفكريًّا، واجتماعيًّا، وتكنولوجيًّا)، وهذا البناء الذاتي لكي يتم ينبغي الاستفادة من كل عناصر القوة (العلمية، والاقتصادية) للقوتين المنافستين الآن(الشرق الأوسط الآسيوي، والغرب الأمريكي – الأوروبي) .
وأيضًا الحفاظ على قوة الدفع الذاتية من خلال تفعيل عناصر التقدم في ثقافتنا العربية، وهي بلاشك تمثل الوقود والمحرك لكل تقدم نريد تحقيقه، ولا نقف بأي حال عائقًا أمام التفاعل الإيجابي مع حضارة العصر الحالي، ومتطلبات التقدم فيه.
- البدء في إجراء حوار حضاري حقيقي مع بلاد الشرق الآسيوي، ذلك الحوار الذي من شأنه زيادة عوامل التقارب مع (الصين، واليابان، وكوريا، وماليزيا، وسنغافورة، والهند،… وغيرهم)، ولا ينبغي أن يقتصر هذا الحوار على الأطر النظرية للتقارب بين العرب وبين هذه الدول، فهذه الأطر النظرية للتقارب موجودة وقائمة بالفعل ولا تحتاج أكثر من إيقاظها ونفض الغبار عليها، وإنما ينبغي التركيز في هذه المرحلة على ترسيخ أسس التعاون المشترك (اقتصاديًّا، وتجاريًّا، وثقافيًّا، وعلميًّا، وتكنولوجيًّا) .
فموقعنا كعرب من التفاعلات الحضارية القائمة الآن وفي المستقبل مرهون بهذه العوامل الثلاث وبنجاحه في التعامل مع الشرق والغرب بتوازن يحقق أقصى قدر من الاستفادة الذاتية والمساعدة في تفعيل القدرات العربية الذاتية وبناء عوامل قوتها التي هي السبيل الحقيقي للمشاركة في صناعة الدورة الحضارية الجديدة، بل وربما في قيادتها في نهاية الأمر.
أما القسم الثاني من الكتاب فهو بعنوان “قراءة جزئية لمستقبل التفاعلات الحضارية “.
ويقول الكاتب إن العقول المفكرة في العالم تشغله كما تشغلنا صورة المستقبل كيف سيكون ؟ وعلى أي نحو ستكون حياة البشر خلال هذا القرن الجديد ؟
والحقيقة الغير قابلة للشك، هي أن التقدم التكنولوجي هو المؤثر الأكبر في تحديد تلك الصورة للمستقبل القريب أو البعيد للبشر، كما كان هذا التقدم صاحب التأثير الأعظم على البشر طوال القرون الثلاث الماضية .
فالصورة العامة لمستقبل التقدم العلمي تتحدد في رأيه في ضوء التقارب الشديد والاستفادة المتبادلة بين ثلاث ثورات علمية، شهدتها نهاية القرن الماضي وبدايات هذا القرن الجديد، ألا وهي (الثورة المعلوماتية، والثورة البيوجزئية، وثورة الكم)، فالتلاقح أو التلاحم بين هذه الثورات العلمية الثلاثة هي الملمح الرئيس من ملامح كل ما سيحدث من تطور علمي وتكنولوجي مذهل سيشهده البشر خلال القرن الحادي والعشرين .
والحقيقة أن أثر التقدم العلمي على حياتنا في المستقبل سواء القريب أو البعيد يمكن تخيله من خلال حياتنا الحاضرة ومدى ما تلعبه المخترعات والتكنولوجيات بها، فلا شك أن اعتماد أي إنسان في حياته على الآلات بدأ يتعاظم منذ منتصف القرن العشرين، ومن يراقب شباب اليوم وهو يجلس أمام جهازه الخاص متصفحًا كل ما يجري في العالم من خلال الاتصال بشبكة الإنترنت سيدرك حتمًا مدى التقدم الذي حدث ويستطيع أن يتصور الحياة في المستقبل، فقراءة المستقبل ضرورة لمن يودون المشاركة الفاعلة فيه، ولذلك فإن فلاسفة التاريخ من الأوروبيين والأمريكيين فضلًا عن المؤرخين والعلماء مشغولون دومًا بقراءة واعية للمستقبل في كل مجالات الحياة .
وتتجه معظم هذه القراءات إلى التأكد على أن المنافسة الحضارية ستكون في مطلع هذه الألفية وطوال هذا القرن الجديد منحصرة بين الغرب من جهة، والإسلام وآسيا من جهة أخرى.
والحقيقة التي لا يستطيع أن يغفلها أحد حين يقرأ أو يحاول أن يقرأ مستقبل آسيا، هي أن اليابان ستكون صاحبة الدور الأكبر في السيادة الآسيوية بالإضافة إلى الصين، فإن كان من المقدور أن يحدث التقارب المنشود بين (الصين، واليابان) لدرجة توحد المصالح والأهداف بعيدًا عن الهيمنة الغربية وبالذات الأمريكية، فإن السيادة حتمًا ستكون لآسيا، فكل الدول الآسيوية الأخرى سواء المتخلفة أو النامية أو الآخذة في سبيل التقدم، كلها تدور شاءت أم أبت في تلك القوتين الاقتصاديتين الكبيرتين (الصين، واليابان)، فهل يمكن قيادة المستقبل بالنسبة للــــــــــيابان، ومدى تقاربها مع الصين؟ هذا هو السؤال الأهم في هذه الدراسة.
ويختتم الكاتب حديثه في هذه الجزئية بحديث “روجيه جارودي” حيث قال: “إن صناعة المستقبل الأفضل للبشرية أساسها إعادة تأسيس النظم السياسية والتعليمية والاقتصادية والدينية؛ لتكون في مصلحة الإنسان كإنسان بصرف النظر عن لونه أو ثقافته المحلية أو دينه الخاص أو مقدار ثقافته أو انتمائه العرقي، بالطبع فهي رؤية يوتوبيَّة جديدة لعالم يمكن أن يولد غدًا أو بعد قـــــــرن” .
أما القسم الثالث من الكتاب فهو بعنوان “نحن والمستقبل موقفنا منه وآليات مشاركتنا فيه” .
وهنا يشير الكاتب إلى الصورة الحالية الغربية المتقدمة في هذا العصر، حيث يقول: “إننا إذا تأملنا لها جيدًا لوجدنا التفكير العلمي في تحديد وتطوير الحاضر وتحسينه من أجل مستقبل أفضل، وهو سماتها الأساسية ونحن لا نطالب إلا بأن نلتقط هذه السمة ونتأثر بها في حياتنا، وهي ليست سمة تتميز بها المجتمعات الغربية فقط ، بل هي سمة كل أمة وكل شعب يريد أن يتقدم، فالتفكير العلمي في مشكلات الحاضر والتوجه نحو المستقبل خطت شعوب شرقية عديدة خطوات رائدة نحو السيادة في المستقبل، مثل: الصينيين، واليابانيين، والكوريين، بل والهند، وباكستان، بل وشعوب أخرى صغيرة العدد أصبحت كبيرة القدر والقيمة، مثل: شعب سنغافورة، وشعب تايوان، وهونج كونج” .
ثم يضيف أننا كعرب نملك من إمكانات التقدم الكثير منها: إمكانات بشرية، ومادية، إمكانات لا تملكها هذه الشعوب الصغيرة المتقدمة، ونملك من الدافع الديني والتاريخي ما لدى هذه الشعوب ومع ذلك نتقاعس عن استغلال كل هذه الإمكانات المدفوعة بكل الدوافع الدينية والتاريخية ولا نزال نقف محلك سر .
وإن ما نلمسه من تناقض وعدم تناغم في الأداء الحضاري لشعوبنا العربية وحكوماتها سر من أسرار عدم تقدمنا، وعائق يعوق التقدم، وهذا التناقض نابع من انفصال الأقوال عن الأفعال، فنحن قد نفكر ونتحدث وندلي الآراء الصائبة ونصطدم بعد ذلك بعدم تحقيق هذه الآراء .
فمثلًا يجب اتخاذ قرارات إستراتيجية لصالح مستقبل العرب نحو إصلاح المسار السياسي بالمزيد من إعطاء الحقوق والحريات للمواطنين، ديمقراطية حقيقية تتيح لكل فرد المشاركة السياسية الحقيقية في صنع اتجاه دولته، في صنع مستقبلها.
يتطلب الأمر كذلك اتخاذ قرارات إستراتيجية نحو إصلاح مسار التعليم في الوطن العربي؛ ليركز على تخريج الأجيال القادمة على العمل مسلحة بكل آليات التكنولوجيا والعلم الحديثة .
فأهم ركن من أركان الحضارة الحديثة هي النظام التعليمي في بلادنا العربية، فهو الأساس المنشود في ثورة التحديث وصنع التقدم الذي نطمح إليه، وإذا ما أردنا حقًا أن يكون هذا التطوير أساس هذه الثورة فلابد أن نتخلى عن كل هذه المناهج التقليدية التي لا تزال تعتمد على التلقين والكتاب المدرسي التقليدي وأيضًا الأساليب التدريسية التقليدية.
وأيضًا يجب التركيز على تقديم المعلومات عبر الوسائل الحديثة ومن خلالها يمكن لهم أن يتعودوا تلقائيًّا على استخدامها.
فبالنظر إلى مقدرتنا الدراسية الحالية في المرحلة قبل الجامعية فلا يوجد من بينها مقررًا واحدًا يعالج هذا الموضوع، فقد خلت هذه المقررات من مادة يدرس فيها الطالب العربي مبادئ التفكير العلمي سواء على المستوى النظري أو المستوى التطبيقي.
وفي النهاية نود أن نؤيد فكرة أن ” الآخر” لا يُعنى بلغة القوة فقط بل هو يسخرها لفرض رؤيته، ومن ثم فعلينا أن نعي أنه لا ” حوار” بدون امتلاك بعض آليات ” الصراع”، وهي ليست إلا مزيجًا من امتلاك عوامل القوة الذاتية (اقتصاديًّا، وعلميًّا، وتكنولوجيًّا، وعسكريًّا، وسياسيًّا) .
فثقافتنا، وإن كانت جوهرها سلام وإيمان، فهي ثقافة تحضنا على امتلاك عنصر القوة الذاتية، وعدم الثقة المفرطة في الآخر فهذا الإفراط في الثقة هو ما جعلنا ننسى سنوات الاستعمار، وجعلنا ننسى اغتصاب الأراضي الفلسطينية كاملة بفعل مؤامرات الغرب الأوروبي في منتصف القرن الماضي، وبفعل استمرار هذه المؤامرات في المساندة السافرة من قبل الولايات المتحدة لإسرائيل حاليًّا.
إن التعامل مع العصر وقيمه لا ينبغي أن يؤجل حتى تَحرُّر الأرض عبــــــــر ما يسمـونه “ثقافة السلام”، بل ينبغي أن يكون تعاملًا تتوازن فيه عوامل بناء القوة على كل المستويات مع عوامل الحذر في الحوار مع الآخر، ذلك الحذر الذي يجعلنا دائمًا في يقظة كاملة نتحسب كل الخيارات ولا نركن إلى مهدئات السلام والمفاوضات وبناء شرق أوسط جديد إلى آخر هذه المصطلحات التي يستخدمونها لتحرير شعوبنا، وإزكاء روح التكامل والتواكل طمعها في أن تضغط أمريكا وأوروبا فيحل السلام الشامل محل الصراع والحرب، وهذا أمل بعيد المنال، ولعل ما يحدث الآن في الواقع على الأرض الفلسطينية المحتلة إنما يكشف مدى هذا الأمل، ومدى ما وصلنا إليه من نتيجة وهي الركون إلى ثقافة السلام وعدم الأخذ بعوامل التحدي الحضاري الشامل.