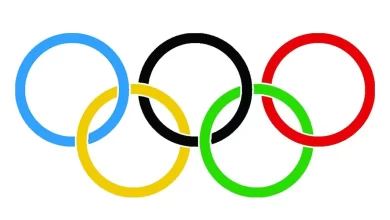في يوم الثلاثاء 2 فبراير 2015، كان مقررًا عقد ندوة شعرية للشاعر والفنان زاب ثروت، وذلك في المقهى الثقافي بمعرض الكتاب الدولي بالقاهرة، وكان الوقت المخصص للندوة ساعتين، أي من الساعة الثالثة، حتى الخامسة عصرًا، ولاحظ المشرفون على المقهى الثقافي وجمهور المعرض توافد أعداد من الشباب منذ الساعة الحادية عشرة صباحًا، وحجز مقاعد بالقاعة التي تكفي بالكاد حوالي 500 من الحضور، وبدأ عدد الجمهور يزداد بطريقة ليست عادية، وبدأت ندوة من الساعة الواحدة ظهرًا، وكانت مخصصة لتأبين الراحل والتربوي الكبير د حامد عمار، وكان الضيوف من أبرز أساتذة علم الاجتماع في مصر، ولاحظ المتحدثون أن القاعة منفصلة تمامًا عن المنصة، القاعة تثير هرجًا ومرجًا وتصفيقًا ليس مرتبطًا بالحديث المثار من قبل الأساتذة المتحدثين، وهنا توقف الدكتور صالح سليمان أستاذ علم الاجتماع بآداب عين شمس، ثم توجه ببعض الأسئلة للجمهور الذي يجلس في القاعة، فاكتشف أن الحاضرين لا يعرفون شيئًا عن موضوع الندوة المنعقدة، وكذلك لا يشغلهم أمرها كثيرًا، وأعرب الحاضرون عن أنهم جاءوا من أجل توقيع ديوان شعر “حبيبتي” لزاب ثروت، بعدها قرر الأساتذة المحاضرون إلغاء ندوتهم بشكل حاسم، ليعلنوا هزيمتهم أمام ذلك الجمهور الجديد، وطبيعته، وانحيازاته المفاجئة.
عندما جاءت الساعة الثالثة تمامًا، كان المخيم امتلأ عن آخره، وفاضت الأعداد خارجه بكثافة شديدة، ووصلت أعداد الحاضرين إلى ما يزيد عن أربعة آلاف شخص، كان أكثر من نصفهم خارج المخيم، كما أن الباب الذي يدخل ويخرج منه ضيوف المقهى قد أغلق بأجساد الحضور، وتم فتح ثغرة في خلفية المقهى لإدخال الشاعر زاب ثروت ومعاونيه وناشره، كما استدعت إدارة المقهى الثقافي ما يزيد عن عشرة من جنود الأمن المركزي للمحافظة على النظام، وصناعة حائط بشري بين المنصة والقاعة، وكذلك لمنع أي تحرش في القاعة يمكن أن يحدث في ظل هذا التكدس الرهيب.
وعندما دخل زاب ثروت وصعد على المنصة، ظلّت القاعة تهتف باسمه بشكل هستيري لوقت زاد عن عشر دقائق، وكان الحضور يرفعون إلى أعلى كتابه “حبيبتي”، وبدا أن القاعة لن تستعيد انضباطها، حتى وقف “زاب” على المنصة، وراح يخاطب جمهوره بهدوء واحترام، وطلب من جمهوره الهدوء والالتزام، ثم قرأ بضعة قصائد من أشعار له خارج الكتاب المعد للتوقيع، حيث إن الكتاب كان عبارة عن رسائل موجهة إلى حبيباته الأم والأخت، وهكذا جاء الشاعر بخطاب معاكس لما هو مألوف وسائد.
في الوقت ذاته، وعلى التوازي تمامًا كانت هناك ندوة على بعد أمتار للشاعر الكبير “علي أحمد سعيد” الشهير بأدونيس، ذلك الشاعر الذي يعمل في الثقافة والشعر والفكر الأدبي منذ منتصف الخمسينات، ويعتبر أحد الأعلام الجاذبين دومًا للمثقفين والكتاب في أي مكان في العالم، ولم تكن ندوة “أدونيس” تقام في “مخيم” متواضع الترتيب مثل المقهى الثقافي، ولكنه كان في المكان الرئيسي الذي يستقبل فيه الوزراء والمدراء ورؤساء الهيئات، أضف إلى ذلك التدشين الإعلامي الذي أعدّه المسئولون للترويج للندوة، ورغم ذلك فالمقارنة بين الندوتين من حيث الحضور والتأثير الجماهيري كان لصالح ندوة “زاب ثروت”، وفي ذلك الشأن كتب الكاتب والروائي عزت القمحاوي في مقال له تحت عنوان “ثقافتنا بين أدونيس وزاب ثروت” قائلاً بعد أن رصد بأن الندوتين كانتا أهم ظاهرتين في معرض الكتاب الدولي: “.. من حيث الصورة، بدا أدونيس كما يحب أن يبدو دائمًا في المحافل العامة، بشعره الرمادي المسترسل، وكوفيته الحمراء وردائه الأسود، الشعر الطويل مع لون الكوفية، يوحيان بالجرأة والمغامرة، بينما يأخذنا الأسود إلى الحكمة والتقاليد والغموض والتشاؤم، ….. زاب ثروت على العكس تمامًا، ليس حبيس (كليشيه) خاص لمظهره، يرتدى جميع الألوان….هذا يفسر زحف آلاف الشباب للتدافع للحصول على توقيع كتابه (حبيبتي)”.([1])
والمدهش أن الصحافة والمتابعين والمثقفين والكتّاب بشكل عام، فوجئوا بذلك الشاعر الجديد الذي جذب الأضواء من أكبر شاعر في الوطن العربي، والمرشح الدائم منذ سنوات بعيدة لجائزة نوبل العالمية، وانقسم الرأي العام بين الانتصار لزاب ثروت وضرورة التعرف على طبيعة ما يكتبه، وبين نبذه وتسفيه وتسخيف ما يكتبه، بل الأشد والأنكى طالب البعض بعقاب المسئولين في المقهى الثقافي لمجرد أنهم أقاموا له ندوة، واستضافوه في ظل أجواء الأدب الرصين، والكتابة المستقرة، ولم يفكروا لحظة واحدة، بأن زاب ثروت ومن شابهه، لا يحتاجون كثيرًا إلى هذه الأروقة الرسمية، بل إنهم يبنون أمجادهم تحت شروط شعبوية وجماهيرية لا تخضع للرسميات والأكليشيهات البراقة.
وجدير بالذكر أن كثيرًا من الأدباء لم يعلنوا رفضهم لما يكتبه زاب ثروت فحسب، بل حاولوا لصق صفات غير حميدة بالشاعر، كما أن البعض اخترع صفحات كاذبة له، ونسبوها إليه زورًا وبهتانًا لمحاربته، ولم يدر هؤلاء بأن زاب ثروت ومن يشبهه وجماهيره الواسعة لا تأبه بذلك على الإطلاق، ولكنهم راحوا يرددون ما كان يطلقه من أغاني الراب، ويكتبون على صفحاتهم بعض مقاطع من نثره وشعره، ولا يفوتنا التنويه بأن كتابه “حبيبتي” باع أكثر من عشرة آلاف نسخة في معرض الكتاب فقط، بينما لم يحظ أي كتاب آخر بهذا الرقم بشكل حصري.
يقول زاب ثروت في مقدمة كتابه: “بصراحة أنا عمري ما كتبت جواب قبل كده، بس النهاردة حسيت إن دي أحسن طريقة ممكن أعبر وأوصف بها اللي جوايا، وأحسن حاجة أبدأ بيها .. هي اسم الإنسان اللي موجه له الجواب ده.. إلى (حبيبتي)”.([2])
وكلما أمعنَّا في الكتاب، لن نجد ما سوف يحل الألغاز التي تكاثفت حول ظاهرة الكتَّاب والشعراء الجدد الذين خطفوا الأنظار الجماهيرية حولهم، ولم يلفتوا النظر فقط، وراحت كتبهم تحقق مستويات غير تقليدية في السنوات الأخيرة. أسماء شعرية من طراز عمرو حسن وزاب ثروت ومحمد إبراهيم ودعاء عبد الوهاب، وغيرهم، وأسماء روائية مثل أحمد مراد ومحمد صادق وحسن كمال وعصام يوسف وغيرهم، وكانت كتبهم تحقق طبعات عديدة تصل للعشرين، ولا نحتاج إلى التأكيد على أن هذا لا يحدث مع كتَّاب كبار ومرموقين من طراز جمال الغيطاني وبهاء طاهر ويوسف القعيد على سبيل المثال.
وإذا كان البعض يقول بأن زاب ثروت ليس شاعرًا فحسب، بل إن دوره كمطرب “راب” ساعد على انتشاره كشاعر، والرد على ذلك يكاد يكون جاهزًا، لأن هناك بعض شعراء آخرين حققوا الحضور ذاته، الشاعر محمد إبراهيم الذي لا يقيم في القاهرة، ورغم أنه كان ينشر قصائده على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تقرأ بشكل واسع، إلا أنه عندما يصدر له أي ديوان، يحقق مبيعات مذهلة، ويحضر له جمهور واسع ومختلف، وكذلك الشاعر عمرو حسن، الذي يلقى الحضور ذاته، وللأسف فإن تلك “المواهب/ الظواهر” لا يحتفي بها النقاد الأدبيون الكبار من طراز د. جابر عصفور أو د. صلاح فضل، وغيرهم، ولا تجد اهتمامًا من نقاد علم اجتماع الأدب، وهذا الملمح الأخير ينم عن عجز حقيقي للتواصل مع الأجيال الجديدة، مما يمعن في تكريس الانفصال بين الأجيال، ويؤجج هذا الصراع غير المرئي، وتحدث مفاجآت في أشكال التلقي لتلك الظواهر الجديدة.
وربما لا تكون تلك الظواهر جديدة بشكل كامل، لأننا عندما نتصفح بعض صفحات هؤلاء الشعراء والكتاب، لا نجد ما يبهرنا نحن، بل هو يشد بقوة مساحة واسعة للغاية من جماهير عمرية أخرى، ففي قصيدة شهيرة – على سبيل المثال – للشاعر عمرو حسن، عنوانها :”الحرب العالمية الثالثة” يقول:
باكتبلك قبل نهاية العالم بدقايق
قبل الجنرال ما يسيب القاعة ويدي أوامر بالضرب
قبل ثواني من الحرب
باكتبلك وايديا بترعش م الخوف والبرد
شوفتي العالم يا حبيبتي في عز الشيخوخة!
صف كمنجات مكسورة ف روح صبار
الدنيا بتتحول من زرع البذرة لضرب النار
وانا وانت صغار جدا ع الموت
وكبار ع العيشة بدون مزيكا ودون أشعار.([3])
هكذا نجد الشاعر والمغني يكتبون شعرًا، أو قل كلامًا لا يحتاج لكثير من التأمل لكي يتم استيعابه، وأعتقد أن هذه الظواهر من الضروري أن تخضع للتحليل الثقافي العام، ذلك التحليل الذي يضع في اعتباره الظاهرة من زوايا مختلفة، ويكون لعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم النقد الأدبي أدوارًا لقراءته، كما أن الصورة التي يقدمها هؤلاء الشعراء ضرورية للغاية كما أشار عزت القمحاوي من قبل، تلك الصورة التي لا تنطوي على أي استعلاء أو تعاظم، وتقديم نص يستعصي على الفهم والاستيعاب، وهذا ما حدث على مدى عقود طويلة، ونحن هنا لا ندين النص الأدبي الصعب في استيعابه، ولكننا نشير إلى النصوص المغالية في إحداث تلك المعضلات التي تتأبى على الفهم تمامًا، ويجد القارئ نفسه أمام نص يكاد يكون مغلقًا تمامًا، نص مركب على المستوى الصوري واللغوي والفكري، نص لا يستسلم لأي تحليل أو استيعاب، وهذا النص كاد يكون هو النص النموذج في مرحلة السبعينات الوعرة، وذلك على المستوى العربي.
ولو عدنا قليلاً إلى عقدي السبعينات والثمانينات، سنلاحظ أن الشعر على وجه الخصوص قد أخذ منحنى آخر، ذلك المنحنى الذي يقول بأن الفن لا بد أن يعبر عن أشواق الجماهير، وليس شرطًا أن يكون مفهومًا، لأن العمل الفني كما أشار وشرح باستفاضة د. عبد المنعم تليمة، في غاية التعقيد إذ “كانت اللغة في كل تلك الموازاة الرمزية – الممارسات الفنية – تقوم بدور أساسي، إذ أن التعبير كان – كالتصوير والتشكيل والتمثيل – قوة سحرية يصطنعها الإنسان للسيطرة على عالمه حسب ما صوّر له المنطق الأسطوري (فكرًا) يحققه الإنسان البدائي من تطور المجتمعات البشرية..”.([4])
ولم يكن الناقد والأستاذ الدكتور عبد المنعم تليمة إلا المعبّر والمنظّر الأدبي للحركة الأدبية في عقد السبعينات، وسنجد أنه يقيم صالونًا أدبيًا كل خميس على مدى عقود عديدة، وكان يشرح نظرياته باستفاضة، وكان يقول للشعراء: “عليكم أن تكتبوا، وعلينا نحن النقاد أن نقعّد” ([5])، أي يبحث عن القواعد التي تفسّر ما يكتبه الشعراء، وكان تأثيره على الشعراء قويًا، وكان الشعراء ينطلقون بكل حرية في الكتابة، متجاوزين القانون المادي الجدلي “الحرية والضرورة”، ذلك القانون أو القاعدة التي تدفع البشر عمومًا، أيًا كانوا شعراء وكتّابًا، يعبّرون عن أنفسهم كما يريدون، شريطة أن تكون هناك ضرورة الالتزام بالتواصل مع الجماهير، وليس التعبير عنهم فقط، ومن ثم وجدنا الشعراء يفتحون باب التجارب على مصراعيه.
ولم يكن حلمي سالم رحمة الله عليه شاعرًا عاديًا، بل إنه كان يقف على رأس حركة شعرية كاملة، ويعتبر رائدها ومحركها وقائدها ومنظّرها، وله ما يزيد عن عشرين ديوانًا، وما يزيد عن عشرة كتب نقدية، وكان له حضور وتأثير كبيران على أبناء جيله والأجيال التي تلته، ولذلك فهو ممثل للمدرسة الشعرية التي سادت في ذلك الوقت، وكانت تلك المدرسة تجد من التشجيع والدفع قسطًا كبيرًا، وبذل الكاتب والروائي والناقد إدوار الخراط مجهودات كبيرة في متابعة تلك الحركة أو المدرسة، في الشعر والقصة والرواية، وهو أحد الذين كرّسوا لما يشبه نظرية الفن للفن، وهاجم في هذا السياق شعراء من طراز أمل دنقل، وكتّاب قصة من طراز يوسف إدريس، وروائيين من طراز نجيب محفوظ.
ولا أظن أن إشكالية التواصل بين الفنان وجمهوره، كانت جديدة على الحياة الثقافية، بل كانت قديمة منذ أن راح الإنسان يعبّر عن نفسه في خطوط غامضة على الجدران، ولا نريد أن نذهب بعيدًا، فما حدث في المنتصف الأول من القرن العشرين، بين مسرح يوسف وهبي التراجيدي، ومسرح نجيب الريحاني الكوميدي، كانت الكفة دومًا يميل إلى مسرح نجيب الريحاني، ليس لأنه مسرح كوميدي، بل لأنه كان مسرحًا قادرًا على استيعاب الجمهور، ويخاطب لحظة خاطفة، ويتكئ على شخصيات مستلهمة من الواقع الشعبي أو الريفي، مثل شخصية “كشكش بك”، تلك الشخصية التي سحرت الجماهير، وظلت فاعلة وحية لفترة طويلة.
ولو عدنا إلى قطبي جيل الستينات الشعري، سنجد الشاعر أمل دنقل، والذي وجدت أشعاره طريقًا واسعًا بين القراء والسامعين على السواء، مثل قصيدته الشهيرة ” كلمات سبارتاكوس الأخيرة”.
ولا مناقشة في أن أشعار أمل دنقل ظلّت تتردد في كل المناسبات الوطنية والسياسية والاجتماعية، وكانت سيفًا مسّلطًا على أعناق الحكّام في عقود الثمانينات والتسعينات وما بعدها، رغم أن الشاعر كان قد رحل عن دنيانا عام 1983، بينما كان شعراء أحياء مثل الراحل محمد عفيفي مطر، والشاعر محمد إبراهيم أبو سنة – أطال الله في عمره – لا يجدون ذلك الانتشار الجماهيري مثل مجايلهم أمل دنقل الذي رحل منذ ثلاثة عقود، ومراجعة سريعة لما أتى به الشاعر محمد عفيفي مطر، كان لا بد أن الكفّة تميل لأمل دنقل.
ولو عقدنا مقارنة بين أشعار أمل دنقل، وبين أشعار محمد عفيفي مطر، ودون الاحتكام إلى الجماهير، ومستوى وكثافة أو انحسار البعد الجماهيري، سنلاحظ أن كفّة أشعار أمل دنقل هي التي تفوز، وهذا ما يجعلها حتى الآن شائعة وتجد حياتها بين مستويات عديدة من المتلقين والقراء، ولا فرق هنا بين النخبة المثقفة، والقارئ الجامعي، والموظف البسيط، وهذا الأمر يحتاج إلى تفسير نقدي متعدد الوجوه، لتحليل أشكال وطبيعة التلقي المتعدد لأشعار شعراء من طراز أمل دنقل، مع اعتبار أن العامل السياسي ليس هو العامل الوحيد في انتشار قصائد أمل دنقل، كما أن رباعيات وأشعار صلاح جاهين وعبد الرحمن الأبنودي وسيد حجاب ليس مساحة الجاذبية فيها نابعة من أبعاد سياسية، بل إن رباعيات جاهين تنحو ناحية التفلسف بشكل عميق، ورغم ذلك، سنلاحظ أنها لا تبهر القارئ فقط، بل هناك بعض القراء يحفظون تلك الرباعيات، ويرددونها في مواقف مختلفة.
وربما يكون شاعر عربي آخر هو الشاعر الفلسطيني محمود درويش، قد استطاع أن يزاحم شعراء كبارًا وهو في شرخ الشباب كما يقولون، وقاد ظاهرة شعرية هو وبعض شعراء آخرين، وأطلق عليهم شعراء الأرض المحتلة، أو شعراء المقاومة، وكان ديوانه “آخر الليل”، قنبلة في الحياة الشعرية العربية، وقد لفت الأنظار، وجذب إليه كثيرًا من الجماهير العربية، ولا شك أن البعد السياسي لعب دورًا كبيرًا في لفت الأنظار، خاصة أن القضية الفلسطينية كانت مشتعلة على موائد الدول العربية ودول العالم، وكان درويش يخشى أن تضيع معالم قصيدته الجمالية، والإنسانية، في ظل ذلك التناول السياسي الذي يصل إلى حد الفجاجة أحيانًا، لذلك كتب مقاله الشهير “أنقذونا من هذا الحب القاسي”، والذي قال فيه – بعد أن حلّل كافة أشكال التناول المختلفة لقصائدهم -:”.. وملخص القول إنه آن الأوان، لأن توضع حركتنا الشعرية في مكانها الصحيح، بصفتها جزءًا صغيرًا من حركة الشعر العربي المعاصر عامة، وذلك يستدعي تخلّص الناقد العربي من الخضوع التام لدوافع العطف السياسي وحدها، على أصحاب هذه الحركة، فلا يكفي هذا الشعر أنه يكتب في إسرائيل، إن وضع الحركة في مكانها الصحيح هو خير طريقة لنموها وتطورها لارتياد آفاق أوسع خاصة إذا تذكرنا دائما أنها مازالت في المراحل الأولى من الطريق الطويل..”.([6])
هنا نستطيع أن نجزم بأن البعد السياسي ليس هو الدافع الأهم ولا الأعمق في انتشار جماهيرية شعر أمل دنقل وعبد الرحمن الأبنودي ومحمود درويش وصلاح جاهين، ولكن الروح التي كتبت بها هذه القصائد، والتي حملت جوانب إنسانية عالية، وتستطيع أن تقفز إلى مراحل زمنية مختلفة، هي المسئول الأول عن انتشار ورواج قصائد من ذكرناهم سابقًا.
وإذا كنا قد لاحظنا ذلك الانتشار في مجال الشعر، فالأمر كذلك يشبهه على مستوى السرد، وخاصة في مجال الرواية، ولاحظ الجميع أن عام 2001 شهد صدور عدد كبير جدًا من الروايات في مصر والعالم العربي، كما تحول شعراء كثيرون إلى كتابة الروايات تباعًا، أبرزهم الشاعر العراقي سعدي يوسف، والذي كان قد كتب روايته “مثلث الدائرة”، وصدرت في منتصف عقد التسعينات عن دار المدى، وظلّت ظاهرة انتشار الرواية تتعملق، حتى أن كتب الناقد الدكتور جابر عصفور كتابه الشهير “زمن الرواية”، معلنًا فيه انحسار ظاهرة الكتابة الشعرية، وذلك لصالح الكتابة الروائية، وما أن جاءت الألفية الثالثة، حتى تحققت النبوءة، وكان العام 2003 الذي شهد عشرات الروايات التي لاقت قبولاً واسعًا، وأطلقت جريدة “أخبار الأدب” على تلك الظاهرة، مصطلح “الانفجار الروائي”، ومما لا شك فيه أن رواية هامة صدرت في ذلك الوقت، وهى رواية “عمارة يعقوبيان” للكاتب والأديب علاء الأسواني، والتي صدرت طبعتها الأولى في أواخر عام 2002 عن دار ميريت، ونفدت تلك الطبعة سريعًا، وتلقاها ناشر كبير بعد ذلك، وهو الحاج محمد مدبولي، لتصدر الرواية في طبعات عديدة، وأحدثت الرواية رواجًا كبيرًا، ليس على مستوى رواية “عمارة يعقوبيان” فحسب، بل دفعت النوع الأدبي نفسه – أي نوع الرواية – لكي يتفوق على كافة الأجناس الأدبية الأخرى، مثل القصة القصيرة والشعر، وصارت الرواية ظاهرة تتناولها الأقلام النقدية بتوسع، وتوقف عندها طويلاً الناقد فاروق عبد القادر وقال عنها في سياق دراسته: “.. تعكس “عمارة يعقوبيان” وجهًا من وجوه تغير النخب المصرية – لو صح الوصف – من ثلاثينيات القرن الماضي في نهايته على وجه التقريب، وهي – زمن الكتابة – تقوم على وجود عالمين مختلفين كل الاختلاف: عالم أصحاب الشقق والمحلات من جانب، وسكان غرف السطح من الهامشيين، أو المهمشين من الجانب الآخر..” ([7]).
وإذا كان النقاد تناولوا الرواية بالنقد والتحليل، وبالسلب أو الإيجاب، ولكنهم لم يتوقفوا عن السبب الذي جعل رواية “عمارة يعقوبيان” تنتشر إلى هذه الدرجة، وتتحول إلى فيلم سينمائي، عام 2006، ويكتب السيناريو وحيد حامد، ويخرجه ابنه مروان حامد، ثم تتحول إلى مسلسل تلفزيوني عام 2007، ويكتب السيناريو عاطف بشاي، ويخرجه للتلفزيون أحمد صقر، والثابت أن الرواية أحدثت خلطة كانت حديثة على الكتابة الروائية، وأيًا كان النقاد غير راضين عن الرواية، وعن مدى الحداثة التي تقدمها، إلا أن الكاتب قدّم فيها عدة وجبات ساخنة للغاية، واختار إحدى العمارات الشهيرة في مصر، وهى العمارة التي أنشئت عام 1934، وضمت بين جدرانها فئات وطبقات وطبائع بشرية مختلفة، هذه الخلطة شملت الجنس والدين والسياسة، واستطاع الأسواني أن يجنح إلى زوايا حادة تمامًا، فلم يختر الجنس في شكله التقليدي، ولكنه أنشأ شخصية تدعى حاتم رشيد، وجعله شاذًا جنسيًا، وكان يرتكب حماقات من أجل الحصول على رغبته الجارفة، ولم يكن حاتم رشيد ابنًا للطبقات المتوسطة، أو الدنيا، ولكنه كان ابنًا لأحد القضاة الكبار، كما أنه كان يعمل رئيسًا لتحرير إحدى الصحف التي تصدر بلغة غير عربية، ولذلك كان القارئ يبحث دومًا عن نظير لحاتم رشيد في الواقع الصحفي، ولم تكن شخصية حاتم رشيد هي اللافتة للنظر، ولكن شخصية طه الشاذلي، ذلك الطالب الذي ينحدر من أسرة فقيرة للغاية، وكان أبوه هو بواب العمارة، وكان طه قد حلم ذات يوم أن يكون ضابطًا في الشرطة، وبعد حصوله على الثانوية العامة قدّم في كلية الشرطة، فلم يقبل لأنه ابن غفير أو بواب، ونال قدرًا من الإهانات المعتادة في مثل هذه المواقف، فما كان منه إلا أن يلتحق بالجماعات المتطرفة، والتي تستثمر عنصر الدين أمام هؤلاء الأشخاص، وهنا نجد لأول مرة روائيًا يقول لنا: “كيف يتكون الإرهابي؟”، ذلك اللغز الذي حيّر علماء الدين والنفس والاجتماع، وكان السؤال الذي حاولت الرواية أن تجيب عنه، هو: المراحل المتوفرة التي تجعل من الشخص الطبيعي، شخصًا إرهابيًا، ومن الطبيعي أن يتحول إلى انتحاري، فطالما أنه يعيش في بيئة فقيرة، ولم يجد حظه في الدنيا، فالفتاوى متوفرة عند ذوى التطرف، والعجينة البشرية جاهزة تمامًا للتشكل، فضلاً عن شخصيتي حاتم رشيد وطه الشاذلي، حاول الكاتب أن يقدم ما يشبه شخصيات روائية، ليست منفصلة إطلاقًا عن نظائر لها في الواقع، كل هذا كان جاذبًا وشيقًا وممتعًا، ولأول مرة يجد القارئ كل هذه العناصر في رواية، فضلاً عن السلاسة التي تميّزت بها الرواية.
وإذا كانت رواية “عمارة يعقوبيان” لفتت النظر بقوة إلى الفن الروائي، وحققت حضورًا قويًا، وجاءت بعدها سلسلة روايات تعزف على الأوتار نفسها، بوتائر مختلفة، إذ صدرت رواية الكاتب حمدي أبو جليل “لصوص متقاعدون”، وهي تحكي حكايات عديدة لمجموعة شخصيات شبه خارجة عن القانون، أو منحرفة عن السياق الاجتماعي الطبيعي، ومن هنا اعتبرت الرواية كاشفة أو فاضحة لطبائع بشرية مسكوت عنها، فالرواية تدور في إحدى الضواحي أو الأحياء العشوائية. ورغم أن كتّابًا من جيل الستينات قد تناولوا تلك الأحياء في رواياتهم، منهم جميل عطية إبراهيم في روايته “النزول إلى البحر”، ويوسف القعيد في روايته “ثلاثية المصري الفصيح”. والفرق بين تناول حمدي أبو جليل وتناول أسلافه من الروائيين، أن أبا جليل يسعى للفضح والكشف بشكل يكاد يكون سافرًا، فهو يسمي الأشياء بأسمائها، ويبدو أن القارئ بات ينتظر من الكاتب أن يحاكي الواقع دون أي تزويق أو تجميل أو مجاز أو خيال، فرواية حمدي ينتشر فيها أشخاص يتعاطون المخدرات، ليس على شاكلة الترميز السياسي عند نجيب محفوظ في روايته “ثرثرة فوق النيل”، بل إنه – أي حمدي – لا ينشئ شخصيات رواياته ليرمز إلى ظاهرة سياسية، ولكنه يصف الحشّاش باستفاضة. وهناك روايات كاملة قامت على ظاهرة التعاطي، وهي رواية “رع جرام” لعصام يوسف، ومن المعلوم أن تلك الرواية حققت رواجًا ومبيعات خيالية، وهذا يدل على أن القارئ يريد أن يجد نظائره في الفن وفي الرواية، وجدير بالذكر أن الشخصيات التي تتعاطى المخدرات انتقلت من الرواية المكتوبة، إلى شاشات التلفزيون المرئية.
ظهرت وصدرت على هامش رواية “عمارة يعقوبيان” روايات عديدة، وقد أصبحت هذه الرواية نموذجًا لكسر الحاجز الوهمي بين القارئ والفن الروائي، حتى أن صدر كتاب آخر، صنّفه كثير من النقاد على أنه رواية، وهو كتاب “تاكسي .. حواديت المشاوير” في يناير 2007، ويكفي أن يجد الكتاب مادحين له من طراز د. عبد الوهاب المسيري الذي اعتبره أحد الكتب الإبداعية الأصيلة، وكذلك د. جلال أمين، ومن على طرازهم، لكي يروج الكتاب بشكل واسع، فالكتاب يصف حال بلادنا في لغة بسيطة، ويقدم – كما فعل الأسواني – سلسلة قضايا اجتماعية وسياسية عبر حوارات مع سائقي التاكسي، ووجد الكتاب رواجًا واسعًا، وتمت ترجمة الكتاب إلى لغات عديدة، ومن خلال هاتين الروايتين، وما بينهما من روايات أخرى، نجد أن القارئ ينجذب لمن يحكي له عن الواقع المباشر، وكذلك يتناول ذلك الواقع في لغة بسيطة، لا يجد القارئ أي معضلة أو صعوبة في التعامل معها، وربما اعتبر كثير من النقاد أن هذا الأمر ، ما هو إلا رجوع اضطراري إلى الخلف، ورأوا أن الكاتب يقدم تنازلات جسيمة أمام القارئ، واستغناء عن اللغة الرصينة، والتقنيات الفنية الرفيعة، انحيازًا لمستوى القارئ الذي لا يعرف القوانين الفنية، كما قال بعضهم بأن هذه العودة تعتبر عودة لما قبل نجيب محفوظ الأربعيني.
ورغم صيحات النقاد، وشجبهم لهذا المنحى من الكتابة الروائية، إلا أن الكتّاب والمبدعين الروائيين، أصبحوا ميّالين إلى تلك الكتابة التي تجد لها قارئًا، فهم يبحثون عن القارئ، بعيدًا عن المجد الذي يرونه وهميًا في إنشاء نصوص روائية، وذات تقنيات عالية، ولكن لا يقرؤها أحد، ولا تجد من يقرؤها، هكذا كتب أشرف الخمايسي روايته “انحراف حاد” على شاكلة تلك الروايات، بعد أن كتب رواية “منافي الرب”، التي لا تتناسب مع ذوق القارئ العام والمعاصر، وجاءت بعده روايات الكاتب والأديب والقاضي أشرف العشماوي، منها روايات “البارمان”، و”كلاب الراعي”، ورغم أن روايات العشماوي تدور في مناخات ومجالات ليست شائعة بين الطبقات المتوسطة أو الدنيا، إلا أنها تجد رواجًا وإقبالاً واسعًا، وهذا يعود لشيئين، الأول هو التخلي عن اللغة السردية المقعرة، والتي تكون أحيانا منفّرة، والعنصر الثاني، هو إضافة قدر من التوابل السردية اللطيفة التي تعطي للرواية طعمًا مختلفًا عن الروايات السابقة عليه.
وبعيدا عن ظاهرة انتشار الرواية، جاء عنصر الميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، لتكرّس لظاهرة انتشار بعض من الكتابات الجديدة، منها مدونة الكاتبة والصيدلانية “غادة عبد العال”، تحت عنوان “عايزة أتجوز”، وحققت تلك المدونة رقمًا عاليًا جدًا في القراءة، وعندما أدركت دار الشروق ذلك الإقبال الجارف على تلك المدونة، اقترحت على الكاتبة أن تصدر كتابًا يتضمن ما كتبته في مدونتها، وبالفعل صدر كتاب “عايزة أتجوز” في طبعته الأولى في فبراير 2008، وتصدر بعده في العام نفسه ثلاث طبعات أخرى، حتى يتحول إلى مسلسل تلفزيون، تقوم ببطولته الفنانة والنجمة هند صبري، ويجد المسلسل رواجًا واسعًا بين جمهور المشاهدين، إذ أنه كان يعرض في شهر رمضان، لينافس على أكثر المسلسلات مشاهدة.
ولا تزعم غادة عبد العال أن كتابها رواية أو مجموعة قصص قصيرة، بل إنها تكتب في مقدمة تحت عنوان “بداية الحكاية”، وتدخل في الموضوع مباشرة، وتقول: “سموا كده وخليكوا معايا واحدة واحدة، خلينا نتفق الأول إن موضوع الجواز والعرسان وتأخر الجواز ده موضوع حساس جدًا.. صعب جدًا، إنكوا تلاقوا حد بيتكلم فيه صراحة، خصوصًا بالنسبة للبنات .. لأن اللي بتتكلم فيه بصراحة يا إما بيتبصلها على إنها قليلة الأدب وماتربتش.. يا إما على إنها مسروعة ع الجواز.. يا إما على إنها بارت ومش لاقية حد يتجوزها. عشان كده تلاقوا بنات كتير بتقول: “جواز إيه بلا نيلة .. يعنى هما اللي اتجوزوا كانوا خدوا إيه ..”.([8])
وهكذا تأخذ غادة عبد العال قارئها إلى سلسلة حكايات ومغامرات في لغة دارجة واضحة، وتنطوي على خفّة دم ملحوظة، وبدا أن الموضوع يشغل قطاعات واسعة من القراء الذين تابعوا الكاتبة على مدونتها، ثم ذهبوا لشراء الكتاب بعد جمعه ونشره، ومما لا شك أن القضايا التي أثيرت في الكتاب، منذ بداية الحكاية، ومحاولة الكتابة في كسر تابو الخوف من طرق موضوع من هذا النوع، مرورًا بالمشاكل التي تواجه البنات في المدرسة والجامعة والأتوبيس والميكروباس والسوبر ماركت، وتدير حوارًا واسعًا مع كل طوائف الشعب، من البواب إلى دكتور الجامعة، إلى سائقي التاكسيات إلى نوعيات الشباب المرشح للزواج، حوارات ثرية، رغم بساطتها، استطاعت الكاتبة أن تطرق أبوابًا واسعة كانت مغلقة، ولم يعرفها الأدب من قبل، ويصبح كتاب “عايزة أتجوز” لغادة عبد العال أحد الكتب التي فتحت سككًا واسعة لهذا النوع من الكتابة، وربما لم يحالف كثيرًا منها النجاح، والفرق أن “عايزة أتجوز”، كان سبّاقًا ومفاجئًا، وربما فاجأ الكاتبة نفسها، كما فعلت رواية “عمارة يعقوبيان” التي فاجأت الكاتب نفسه، حيث إنه عانى معاناة مريرة في النشر قبل ذلك، ورفض له الكاتب الروائي الراحل محمد البساطي نشر مجموعة قصصية، عندما كان رئيسًا لتحرير سلسلة “أصوات أدبية” التي كانت تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك عام 1999، لذلك لم يكن علاء الأسواني متوقعًا رواج روايته بهذه الطريقة، ذلك الرواج الذي قاد الرواية لكي تترجم إلى اللغات الأجنبية الحية، وتجد نجاحًا ليس له نظير من قبل بالنسبة لروائيين ذوي الشأن في تاريخ الرواية العربية، ولا ننسى أن الرواية كانت تنشر مسلسلة في صحيفة “أخبار الأدب” القاهرية، وذلك قبل صدورها في كتاب.
كانت هذه المقدمات التي سردناها سابقًا، لكي تنتج لنا الحياة الثقافية كل عام نجومًا جددًا، وعلى رأسهم الكاتب أحمد مراد، والذي بدا أنه غزير الإنتاج، وأغرت رواياته صنّاع السينما أيضًا، كما راجت كتابات لمحمد صادق في روايته “هيبتا”، وعلى هذا الطريق جاء كتَّاب وكاتبات لا تكفي هذه السطور لرصدهم، وجدير بالذكر أن كل نجاح لرواية يثبت أنها مختلفة عن الأخرى، فهذا التوغل في كتابة الرواية، أعطى مبررات قوية لكل روائي في تقديم شكل مختلف في الكتابة، وعناصر مغايرة في الأفكار، فهذا عز الدين شكري فشير، يقدم رواية “باب الخروج” عام 2012 وهي رواية مستقبلية، وراح يكتب فيها ما يتنبأ به، ويراه قابلاً للحدوث عام 2050، وتبدو هذه حيلة روائية لكي يخرج من فخ التقريرية والمباشرة، وهذا إبراهيم عيسى يعمل على الداعية الإسلامي في روايته “مولانا”، ويكشف قدرًا من مساحة الانتهازية التي ينطوي عليها بعض الشيوخ في الفضائيات، وربما يحكي إبراهيم عيسى في استطراد عن وقائع يعرفها جيدًا، وذلك بحكم تواجده وعمله في مجال الإعلام، وهذه الكاتبة رضوى الأسود في روايتها “زجزاج” تقدم ست شخصيات نسائية عانين من إحباط وأشكال من الفشل لا نظير لها، وتقول الراوية في إحدى الفقرات: “ما أحست به رانيا شبيه بصدمتها الأولى في طليقها ووالد طفليها في زواجها، حاولت الاستمتاع بكل شيء رغمًا عن كل شيء..”.([9])
أما عمار علي حسن، فقدم سلسلة روايات استطاع أن يصنع بانوراما واسعة على الحياة المصرية من زوايا مختلفة، وتعد روايته “سقوط الصمت” محاكاة فنية عالية لما حدث بعد 25 يناير 2011، ثم رواياته “جبل الطير” و”السلفي” و”بيت السناري” و”خبيئة العارف” وغيرها من الروايات، التي يشتبك بشكل فني وجدلي مع الواقع في حاضره وفي ماضيه.
ولا بد أن نشير إلى ذلك السيل الذي زاد عن حده في الروايات التي كتبها شباب كانوا ينتمون إلى جماعات متطرفة، مما يشي بأنها روايات بديلة للسير الذاتية، فإذا كان سامح فايز الشاب الإخواني المنشق، والذي كتب كتابًا يشبه الاعترافات أسماه “جنة الإخوان”، وكله وقائع مباشرة، سنجد شابًا آخر يكتب “ابن الجماعة” وهو أحمد حسام الدين، ويكتب حسام الدين في مطلع الرواية بعد مقدمة تشرح بعض أحوال الراوي: “.. لذا أجد من الواجب علىّ وأنا في زهوة الشباب، وقد أتممت الخامسة والثلاثين من العمر، أن أدوّن كل ما مضى في حياتي إذا ما بلغت المشيب – كما ذكرت – قرأت ما كتبت، فأستغفر الله على ما بدا مني من سيئات، وأحمده وأشكره على ما أعانني عليه من فعل للخيرات ..” ([10])، وهذا المقطع يدلّ على أن الكاتب لن يخرج عن خبرته المباشرة، وهذا ما بدا عند كتاب كثيرين.
مما تقدم نستطيع أن نخلص إلى أن ملامح الكتابة الجديدة،
هي مجموعات الخبرات المباشرة التي يعرفها الكتَّاب، دون أي مثاقفة أو تقنيات
معقدة، ومحاولات اقتراب مباشرة من القضايا المطروحة على الساحة الاجتماعية
والسياسية دون أي تعقيدات كانت تتطلبها الروايات في العقود السابقة، وهذا ما جعل
الرواية المعاصرة تحقق أشكالاً من التوزيع والرواج والمقروئية لم تحدث من قبل.
([1]) عزت القمحاوي .. “ثقافتنا بين أدونيس وزاب ثروت” جريدة المصري اليوم، 9 فبراير 2015.
([2]) زاب ثروت، “حبيبتي”، دار دون، الطبعة الثالثة، فبراير 2015.
([3]) عمرو حسن ، باندا ، ديوان بالعامية المصرية، دار تشكيل للنشر والتوزيع، 2015.
([4]) عبد المنعم تليمة، مقدمة في نظرية الأدب، طبعة دار التنوير الأولى، 2013، ص43.
([5]) عبد المنعم تليمة ، “الشعر ينبئ ويتنبأ”، مجلة إضاءة 77، العدد الثاني، أغسطس 1977.
([6]) محمود درويش، شيء من هذا الوطن، دار العودة، بيروت، 1971، ص34 و35.
([7]) فاروق عبد القادر، في الرواية العربية المعاصرة، دار الهلال ، سبتمبر 2003، ص51.
([8]) غادة عبد العال، عايزة أتجوز، دار الشروق، الطبعة السادسة، ص5.
([9]) رضوى الأسود، زجزاج، دار نهضة مصر، 2017، ص103.
([10]) أحمد حسام الدين، ابن الجماعة، دار المصري للنشر والتوزيع، 2012، ص7.