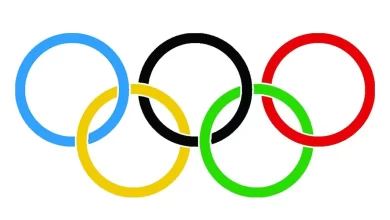لعل أكثر ما يمكن أن ننعيه فى عالم اليوم هو ذلك الشعور البسيط والإحساس العام بالتناغم مع المبادىء الأساسية للوجود، حيث يتعمق الارتباط بين البشر والمجتمعات ارتباطا يقوم على المحبة والتراحم، ويناهض القسوة والعنف. لقد غاب ذلك الإيمان، مرة بفعل التقدم التكنولوجى وتوحش السوق الرأسمالى الذى، ومرة أخرى بفعل تطرف الفكر الوضعى الذى يكاد يفصم عرى العلاقة بين الإنسان والله بفعل الإفراط فى تقديس الإنسان لإرادته، ومرة ثالثة بفعل التدين المتطرف والإرهاب العدمى، الذى يمثل رد فعل أهوج على ثقة الانسان بمعرفته وحريته فى صورة انتقام يقوم به إنسان آخر يفتقد هذه الثقة، ولكن باسم الله جل شأنه، وهكذا أخذ الجميع يضلون الطريق إلى الروحانية المؤمنة كما إلى الإنسانية الحقيقية.
عندما وقع زلزال 11 سبتمبر، كان متصورا أن الإرهاب بلغ ذروته، وأن مسيرة دحره قد بدأت مع إعلان الولايات المتحدة الحرب ضده، واحتلال بلدين مسلمين بذريعة مواجهته. ولم يكن هذا التصور صحيحا، حيث هبت على أوروبا موجة إرهاب عاتية تفوق فى مدى انتشارها حدث سبتمبر الأمريكى، وإن لم تعادل، لحسن الحظ، الحجم المأساوى لضحاياه. ففضلا عن هجمات بروكسيل التى راح ضحيتها خمسة وثلاثون قتيلا وأكثر من مائتى جريح، شهد العام (2015م) هجومان كبيران على باريس وحدها: أولهما حادثة الاعتداء الشهيرة على مجلة شارل إبيدو، والتى راح ضحيتها 18 شخصا مطلع شهر يناير. وثانيهما سلسلة هجمات نوفمبر الانتحارية التى أودت بحياة مائة وعشرين شخصا، مع مئات الجرحى من جنسيات مختلفة، وذلك قبل أن تتوالى خلال الأعوام الثلاث المنصرمة وقائع الدهس والقتل فى غير عاصمة أوروبية. أما الولايات المتحدة فشهدت خلال تلك السنوات ولا تزال تشهد العديد من حوادث العنف بدءا من مذبحة لاس فيجاس التى قام بها “ستيفن بادوك” قبل ثلاثة أعوام وراح ضحيتها ستون شخصا على الأقل، فضلا عن خمسمائة جريح بإصابات متفاوتة، وحتى الهجوم الأخير (نوفمبر 2018) على نادى ليلى للرقص. ناهيك بالقطع عن كل ما يدور فى جنوب المتوسط من حوادث إرهابية شبه يومية، لعل آخرها الاعتداء الآثم على زوار دير الأنبا صموئيل فى محافظة المنيا بصعيد مصر، والذى نال من سبعة أرواح بريئة، وجرح أضعافهم. ولن نتحدث هنا عن باقى المآسي العربية حيث يختلط العنف السياسي بالعنف الدينى، وتختلط وقائع الإرهاب بوقائع الحروب الأهلية، وتتداخل الأدوار الإقليمية الشريرة مع المطامح العالمية الانتهازية.
تكشف قدرة الإرهاب هذه على التوغل والانتشار فى أوروبا عن توازن سياسي غرائبى نشأ تلقائيا بين طرفى معادلة القوة ـ الضعف، فثمة قوة الشمال وتقدمه التكنولوجى، وثمة فى المقابل ضعف الجنوب وجنونه وأزماته كالفقر والهجرة واللجوء السياسي، ناهيك عن الإرهاب، وجميعها عوامل إرهاق للشمال لم يعد قادرا على إدارة الظهر لها، بعد أن وصلت مخاطرها إليه فعليا، فيما بات ثمن مواجهتها كبيرا ومكلفا من الأموال والأرواح. وقد كان الحديث عن ذلك التوازن الغرائبى داخل القرية الكونية يتردد أحيانا ولكن على سبيل الرفاهة الفكرية، على ألسنة ذوى النزعة الإنسانية المفرطة، أو نشطاء البيئة، ولكنه فى الأعوام القليلة الماضية صار يتردد أيضا فى المحافل السياسية، والكهوف الأمنية، التى اكتشفت واقعيته المؤلمة بفعل العلاقة الآثمة التى نمت ولا تزال تنمو بين الإرهاب والتكنولوجيا، لتجعل من التحديث المتسارع، طريقا إلى العنف لا الحرية، كما تقول نظريات التحديث التقليدية، وهو تطور صادم يتجذر فى ذلك الانفصال المرير بين منتجات التحديث وقيم الحداثة، ما يرتب نتائج مريرة لن يكون ممكنا أبدا مواجهتها ولا تحييد مخاطرها إلا بقدر فائق من الاتساق الأخلاقى العالمى يتناسب وحجم الشر الكونى المحيط بالجميع، فى عالم صارت عضلات البشر فيه تتفوق على ضمائرهم وأرواحهم.
لقد بات العنف حقا مشكلة عالمية، لا يستطيع أحد مجابهتها وحده، بل ثمة حاجة إلى أخلاقية عالمية، منصفة وتعددية وإنسانية، لمجابهة الظاهرة وتقليل خطرها على المصير البشرى. هذه الأخلاقية تفرض، فى الوقت نفسه، كبحا مثلثا لجماح التطرف فى فهم الدين، ولجماح النزعات الفوضوية فى ممارسة الديمقراطية، ولجماح السوق فى تطبيق الرأسمالية، دفاعا عن مفهوم الخير الكونى، وغرسه فى أذهان الناس؛ أى في سلوك الأفراد والجماعات وبنى الثقافات، وهو ما لن يكون ممكنا إلا إذا اقتنع الجميع بأن العالم يمكن أن يسعنا جميعا مهما كانت اختلافاتنا.. يسع المؤمن والملحد، الأبيض والأسود، الغنى والفقير، طالما ساد التعاطف الذي يسمح بالتفهم وليس فقط الفهم.
يقتضى إعمال هذا المبدأ الأخلاقى ألا يتطلع كل فرد إلى مصلحته فقط، بل إلى هذه المصلحة فى سياق الصالح العام للمجتمع أو الدولة، ليكون ممكنا الحديث عن مجتمع واحد، وألا تسلك أمة سوى الطريق الذى يحقق مصلحة جموع الأمم حتى يكون ممكنا الحديث عن عالم واحد؛ يتجذر فى ذلك الشعور بالواجب المشترك الناجم عن القوة الروحية للنزعة الإنسانية، حيث يتمكن الأفراد المستنيرون فى جميع الأمم من تجاوز حدود دولهم وأممهم إلى الشعور بالمسئولية عن المجتمع البشرى قاطبة. إنه الشعور الذى نما فى ضمير البشرية بظهور الديانات العالمية وحلولها محل نظائرها المحلية، وأيضا مع تبلور الأنساق الفلسفية الكبرى خصوصا فى العصر المحورى، وخصوصا مع رسوخ النزعة الإنسانية العلمانية فى العصر الحديث، ولكن أثره السياسي المباشر لم يبلغ ذلك القدر الضرورى اللازم لقيام مجتمع عالمى، ومن ثم يتوجب الشروع فى تعليمه لمواطني كل الدول بدعم من حكوماتهم حتى لا يظل قصرا على المستنيرين والخواص وحدهم.
وقد لا يكون سهلا بلوغ المثال الأعلى لهذا المجتمع العالمى، بحكم أسباب كثيرة، ولكن علي الجماعات البشرية كلها أن تسعى صوب هذا الهدف، كى تصيب ولو قدر منه؛ أو تتمكن، على الأقل، من وقف الحركة فى الاتجاه العكسي له؛ فإذا ما تركنا النزعة الفردية الضيقة تصل إلى ذروتها المطلقة نكون بشكل أو بآخر أمام أنانية جديدة، ليست تلك الأنانية البدائية القديمة قليلة الحيلة، بل الحديثة المسلحة بكل عوامل القوة والدهاء، القادرة على النيل من كل فرد آخر أو قيمة اجتماعية مستقرة. وإذا تركنا الفكرة القومية تعمل بلا حدود، وتتعملق بلا رادع فإن المثال النازى المقيت لن يظل خلف ظهورنا، ولا النموذج الفاشي سيبقى مجرد جزء من ماضينا التعيس، بل سوف نواجههما على طريق المستقبل، غدا وبعد غد، فالهمجية الجمعية لا حدود لها يمكن أن تقف عندها، خصوصا مع التطور الهائل فى إنتاج شتى أدوات الدمار والموت.
إننا، اليوم، أحوج ما نكون إلى إعادة بناء مثل التنوير العليا، فى مكونها المتصالح مع الإيمان الروحى، وبالذات النزعة النقدية وأخلاقيات العقل العملى كما تصورهما العظيم إيمانويل كانط، وإلى تحويل مفهومه عن “الواجب الأخلاقى” إلى نص شبه مقدس عن “الواجب الإنسانى المشترك”، نقرؤه صباحا ومساء، بحيث نتصرف تجاه العالم بالشكل الأخلاقى الذى نأمل أن يتصرف به العالم تجاهنا، وأن نؤمن بأن سلوكنا اليوم وغدا هو سلوك الآخرين جميعا، كى نجعل من سلوكنا مصدرا لخير العالم. باختصار نحتاج إلى ضمير جديد لا يصنعه الدين وحده بل تلهمه الخبرة الإنسانية المشتركة كلها، لا يخاطب فقط عالما غيبيا ولا يخطب ود زمن مقدس عند لحظة بدء تليدة، بل يخاطب واقعنا هنا وعلى هذه الأرض، وزمننا هذا (المدنس)، إيمانا بقدرتنا على أن نجعله أقل دنسا وربما أكثر طهارة، عندما نقيم سلام العالم وأمن الدول على قاعدة الديمقراطية والمشاركة والحوار داخل هذه الدول، الأمر يفرض علينا مساءلة ثلاثة أنساق أساسية تحيط بالإنسان وتهيمن على مصيره :
النسق الأول هو المجتمع القاعدى، حيث يأخذ مبدأ الخير العام شكل منظومة المثل العليا والقيم الأخلاقية المعتبرة، التى تحظى بتوافق واسع دلت عليه الخبرة الإنسانية المشتركة كما جسدتها الحضارات الكبرى، ومن ثم ينبع إيماننا بوجود أخلاقية إنسانية عابرة للأديان والثقافات، قد لا تنتظم فى قواعد مفصلة على غرار قوانين العلم الطبيعي، ولكنها تبقى متجانسة، تعكس حكمة التاريخ، وخبرة المجتمعات، وسعى الإنسانية إلى الحق والخير، ابتعادا عن الشر والظلم، واتجاها نحو ضمير مشترك، يتجلى بألوان مختلفة فى الثقافات المتباينة، حيث تميل بعضها إلى تغليب المكون الدينى فى الأخلاق، بينما تميل الأخرى إلى تغليب المكون العقلى فيها، ومن ثم تكتسب جميعها خصوصية ما “نسبية” فى وسائل إدراك الخير وحصار الشر، ولكن تبقى الركائز المشتركة لهذا الضمير متجانسة، تنفى الخصوصية المطلقة فى تعريف ماهية الخير وكينونة الشر.
عبر التوافق على تلك المثل العليا والقيم المشتركة تكتسب التيارات الأساسية، العريضة والأكثر اعتدالا داخل الأديان جميعا قدرة كبيرة على البقاء، وطاقة لا نهائية على التجدد، وتفويضا واسعا فى تمثيل معتنقيها، أما التفريط في تلك المثل والقيم فيمنح للأصوليين فى كل دين مبررا أخلاقيا لممارسة العنف، وقدرة عملية على تجنيد أصوليين آخرين، بذريعة التصدى لأولئك “الفجار” الذين يتنكرون للأخلاق السماوية، أو يرفضون المشيئة الإلهية. ولعل إحدى أبرز القضايا التى تعكس هذا الأفق تتمثل فى الأخلاق الوضعية التى تسعى إلى هدم الأخلاق الكلاسيكية، وتأسيس أخلاق ما بعد الطبيعة، وبالأدق “المثلية الجنسية” التى تظل بمثابة بقعة سوداء فى ثوب الإنسانية، تشبه الثقوب السوداء فى الفضاء الكونى، التى طالما أرقت علماء الطبيعة، ولهذا استمر التعاطى معه على قاعدة أنه استثناء سلبى، عرفته جل المجتمعات والحضارات القديمة، فيما أدانته الأديان خصوصا السماوية، وحذرت منه كتبها المقدسة، بل اعتبرته طريقا إلى الهلاك والجحيم، ولكن بعض المجتمعات ما بعد الحديثة، باتت تعتبرها مجرد “مثلية جنسية”، تعكس تنوعا طبيعيا فى الميول العاطفية، ومن ثم اندفعت حكوماتها أو البؤر الليبرالية المتطرفة فيها، إلى محاولة فرضها على الآخرين؛ بزعم الحق الإنسانى فى الاختلاف.
يتناقض هذا الحق مع الشرائع الدينية بالضرورة، إذ يتجذر فى طور من العلمنة الفائقة “الوجودية”، لا يكتفى بإزاحة الدين من المجال العام، بل يسعى، من دون إعلان عن ذلك، وأحيانا من دون وعى به، إلى نفيه من الوجدان الفردى والوجود الاجتماعى، والدفع به إلى أكثر المواقع هامشية فلا ينحيه فقط عن التدخل فى بنى الاقتصاد والسياسة والمعرفة على المنوال الذى تنادى به العلمنة السياسية، بل تحرمه أيضا من دوره فى صوغ نظم القيم السائدة، التى طالما عبرت عن نفسها اجتماعيا فى قوانين الزواج والطلاق، وأنماط العيش المختلفة، على نحو يفكك العلاقة بين الإنسان والمقدس، ويُفقد الفضائل الأخلاقية مطلقيتها، ويكسبها طابعا نسبويا مفرطا، فيصير الخير ما يراه الفرد خيرا والشر ما يراه شرا. وهنا يمكن النظر بعين الاعتبار والاحترام والتقدير إلى الموقف الأصولي الإنجيلى، والتعبئة الكاثوليكية، ومواقف اليهود الحريديم، وكذلك موقف عموم المسلمين وليس فقط الأصوليين، الرافضة لتقنين المثلية الجنسية باعتبارها تحديا لمركزية الله فى الوجود الإنسانى، يمثل القبول بها أفضل ذريعة للتطرف.
والأكثر من ذلك أنها تتناقض مع مبدأ الخير العام الكونى، عندما يسعى إلى كسر الفطرة الإنسانية. فرغم أن الاعتداء الجنسى العابر للنوع يبقى فعلا محرما فى كل الأديان، يسمى مرتكبه “زانيا”، وجريمة مؤثمة فى كل النظم القانونية، يسمى فاعلها “مغتصبا”، إلا أنه لا يعدو أن يكون مجرد كسر لـ “لقانون” ديني أو وضعي، أما المثلية فتمثل كسرا للطبيعة الإنسانية يُفضى إلى إفساد حركة الكون، لدافعين أساسيين: الأول كونه تهديما لحال العمران وتعطيلا لمسيرة النمو البشرى التى ترعاها العلاقة الجنسية الطبيعية، العابرة للنوع، وما يترتب عليها من تناسل ونماء للنوع البشرى ذاته. والثانى كونه تهديما للأسرة التقليدية، كنواة أثبت التاريخ أنها الأقدر على رعاية الأطفال وتنمية ذواتهم الفردية، والأكثر فعالية فى ذرع جذور الانتماء للجماعات الأكبر بدءاً من القبيلة وصولا إلى الدولة الوطنية الحديثة.
وقد يرى البعض أن ثمة تناقض بين مبدأ الخير الكونى العام وما يمليه من التزامات، باعتباره قيدا على الإرادة الإنسانية، وبين النظريات الليبرالية، التى تعتبر أن الخير العام هو مجرد حاصل لخيارات الذوات الفردية الحرة. غير أننا ندعى بأن مثل هذا التصور ليس إلا نتاجا لفهم ظاهري مسطح؛ لأن تحديد معايير كلية وسقوف عليا للخير والشر هى أمور لا تنال من إرادة الفرد ولا من حريته فى ارتكاب الأفعال الشريرة، حيث الفارق كبير بين وضع معايير عامة وكلية للخير، يمكن للأفراد أن يستلهموها، وبين جبر هؤلاء الأفراد على السير نحوها، وذلك على منوال القانون، الذى يمثل قواعد عامة مجردة تحدد الخطأ والصواب، وهو مطلب أساسي لكل مجتمع متمدين، وبين قسر الناس على أن يكونوا مواطنين صالحين يراعون تلك القواعد القانونية، من دون إنكار لحق المجتمعات فى عقاب الخارجين عليها.
بل إن فلسفة التنوير فى ذروتها النقدية تدعم فهمنا هذا، والمتنورون الحقيقيون لا يعز عليهم إدراك مغزاه، فلدى التنويرى الأبرز كانط تتجسد القاعدة الأساسية للسلوك الأخلاقى فى مفهوم “الواجب المشترك”، ويعنى به أن نتصرف تجاه العالم بالشكل الذى نأمل أن يتصرف به العالم تجاهنا، وأن نتصور وكأن الآخرين جميعا سوف يشاركوننا غدا السلوك الذى نقوم به نحن اليوم، ثم ننظر لنرى هل تُحقق هذه المشاركة خير العالم أم لا؟.. ولنا هنا أن نتصور حالة تحول فيها الجميع إلى شواذ، لا يتزاوجون عبورا على النوع بل داخله، فهل يصبح عالمنا أفضل مما نحن فيه الآن؟ والذى لا شك فيه أن عالما كهذا لا مصير له سوى الفناء بعد جيلين أو ثلاث، ومن ثم يمكننا الإدعاء بأن رفض الشواذ وحصارهم بل وعقابهم على سفورهم لا يمثل مجرد وجهة نظر يمكن لمدعى ليبرالية أو استنارة أن يرفضها، بل هو فريضة يمليها علينا الشعور بالمسئولية عن المصير الإنسانى، الذى تتضامن فى صونه الأديان السماوية، ومثل التنوير العليا، والحس الإنسانى السليم، أما التعاطى الخجول مع تلك الظاهرة، ناهيك عن محاولة تقنينها، فليس إلا إهدارا سافرا لمبدأ الخير الكونى، يسمح للثقب الأسود فى الطبيعة الإنسانية بأن يتمدد حتى يلتهم المصير البشرى كله.
وهنا تكمن أهمية الإسهامات التى قدمها الفيلسوف الألمانى يورجن هابرماس وبالذات بحثه عن “الدين في المجال العام”؛ فالتسامح لديه أساس الثقافة الديمقراطية، ولكنه يتشكل من مسار ذي اتجاهين دائما، فلا ينبغي أن يتسامح المؤمنون فقط إزاء اعتقادات الآخرين وقناعاتهم، بل من واجب العلمانيين والملحدين أن يثمنوا قناعات المتدينين، حتى لا تصبح العلمنة سلطة عليا تضبط الأمور وتحدد لنا ما ينبغي التفكير فيه وما لا ينبغي التفكير فيه؛ بمعنى ألا تتحول إلى أيديولوجيا شمولية مغلقة تطرح نفسها على الجميع فى صورة أمر فكرى أو سياسي أو أخلاقى، فعندها سوف تتوقف عن محاولة الفهم، وتتحول إلى ما يشبه سلطة الفقهاء المسلمين المتشددين الآن، أو سلطة الأكليروس المسيحى فى العصور الوسطى، محض تصور سلفى عن أصل ما، وإن اختلفت منابع الأصولية العلمانية، كسلفية تنسب إلى أصل مرجعى حديث، عن الأصولية الدينية كسلفية تنسب إلى أصل مرجعى قديم.
هكذا يتبدى مفهوم هابرماس الأثير عن المجتمع ما بعد العلمانى وكأنه طريق ثالث، قادر على تحقيق مصالحة تاريخية بين الدين والعلمانية، يلتمس استمرارية الجماعات المتدينة في محيط يستمر فى ممارسة العلمنة، فحال ما بعد العلمانية بقدر ما هي حال تاريخية فإنها تحيل إلى وضع ينفرد ويتجاوز تاريخه. إنها الحال التى تتجاوز التطرف الديني والعلماني معا، ولا تقر بهيمنة الدين أو اللاديني، بل تدعو إلى تفاعل الجميع على أرضها، سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين. الأمر الذى يتيح الشراكة بين المؤمن وغيره في رحاب فضاء تعددي يقبل الدين مشاركًا في صنع التشريع بطريقة علمانية، حيث يمكن للمتدين أن يعيش فى إطار العلمانية، فيما العلماني لا يستطيع العيش تحت مظلة الديني، ما يجعل فى قبول الدستور العلماني منفعة للمواطن المتدين، إذا ما أراد العيش في إطار أشمل من هويته الضيقة وعالمه المغلق، ينعم فيه بالدولة القانونية والهوية الكونية.
والنسق الثانى هو الدولة، باعتبارها النظام المجتمعى الأكثر تأثيرا فى حياة الإنسان، صاحبة الحق الأول فى التحكم بالمجال العام؛ ومن ثم يتوجب تقديم نقد أخلاقى لطريقة عملها يدفعها إلى العمل لا وفقا للأخلاقية الدينية، وإلا كان الأمر خلطا ينال من مبدأ الفصل القانونى، بل وفقا للمعايير الجوهرية الصحيحة التى تنبع من المجال السياسي نفسه؛ أى محاكمتها بمعاييرها الأكثر أصالة وصدقا فى التعبير عن دورها فى المجتمع الحديث. وهنا يتجسد مبدأ الخير العام فى مساءلة العقائد السياسية والأمنية القومية المعتبرة لدى الدول: فهل ما تمارسه النظم القمعية من قهر واستبداد وتسلط على مواطنيها يستهدف الحفاظ على أمن الدول أم أنه تكأة لتأبيد حكم تلك النظم ؟. وهل ما تعتمده من استراتيجيات تحرك فى المجتمع الدولى يمثل احتياجات ضرورية لأمنها، أم أنها تعكس فقط ميولا عدائية، وتبغى تحقيق غايات استعراضية ؟. وهل ثمة معقولية للأسلحة النووية باعتبارها سلاحا للدفاع والردع، رغم قدرتها على التدمير الشامل والمتبادل؟؛ ما يجعلها سلاحا لا عقلانيا ولا إنسانيا، حيث تسمح، بل أدت بالفعل إلى هلاك أعداد لا تحصى من البشر على مذبح تفوق القوى العظمى، وسياسات الهيمنة العالمية؛ سواء فى الحروب الساخنة أو الباردة، ناهيك عن التكلفة المادية الهائلة لها، والتى إذا ما استخدمنا فى مواجهتها القانون الاقتصادى الشهير عن “الفرص البديلة”، وتخيلنا إنفاقها المنضبط والعقلانى على التنمية البشرية، وما قد يفضى إليه من ترقية عيش الإنسانية برمتها، ومن ثم حصار بعض نزعاتها الشريرة التى تنطلق من الفقر والحاجة والضغط الاقتصادى، كان فى مقدورنا أن نحلم بعالم أقل عنفا وأكثر إنسانية عن ذلك الذى نعيش فى ظله.
إن الواجب الإنسانى المشترك، القادر على تحقيق مبدأ الخير العام الكونى، هو فكرة شفافة، تبدو إنسانية جدا ولكنها أيضا ضعيفة جدا، لا يمكن أن تبقى أو تنمو طالما تركت أسيرة فقط لوعي الأشخاص القادرين على اتخاذ مبادرات فى هذا الاتجاه، بل لابد من تغلغلها فى بنية الدولة الديمقراطية، وفى البنيان الدستورى لها، ومن ثم فى صرح القانون العقلاني المدنى، الذى يعكس خبرات المجتمعات والحضارات الكبرى لها، ويجسد فعلا المشترك الإنساني، وهو صرح غالبا ما تكون له أصول دينية، فكثير مما يعبر عنه اليوم بالعقلانية القانونية ما هو إلا نوع من تقاليد تشريعية كانت في الدين أصلا ولكن تمت أنسنتها ، لتصبح فيما بعد علمانية أو دنيوية؛ ولذلك فعلى الحس المشترك أن يعمل انطلاقًا من أرضية فعل ديمقراطي تعددى بالمعنى الواسع لا الضيق، فلا يعمل من أجل جماعة سياسية واحدة بل من أجل إنسانية واحدة، تنطوى على نظم سياسية متعددة ولكنها يمكن أن تكون متقاربة، يمكن أن تختلف فى حول وسائل بلوغ الخير العام، ولكنها تتفق على ضرورته.
فى هذا السياق أدان جون رولز التعصب لـ “الديمقراطية الليبرالية”، واعتبارها الطريق الوحيد إلى التسامح؛ لأن التعصب لليبرالية كالتعصب ضدها، أو التعصب لأى فكرة أخرى دينية أو فلسفية، لا ينتج سوى أسوأ نزعات الشر لدى الإنسان. ومن ثم يرفض رولز اعتبار الديمقراطية الليبرالية أو العلمانية غايات تُطلب لذاتها، فالغايات لابد أن تكون أسمى، ومحل اعتبار من كل الأمم، وذلك من قبيل العدالة الدولية، والسلام العالمى، ولتبقى الديمقراطية الليبرالية والعلمانية السياسية مجرد وسيلة، ضمن وسائل أخرى، لبلوغهما. ومن ثم يتصور رولز، كما يقبل، وجود دول / أمم منضبطة، تمارس سياسات عقلانية، وتندمج في الاقتصاد الدولي، والنظام العالمي، وتسهم أيضا فى حركة التاريخ ولكن من داخل خصوصياتها الثقافية التى تتجاوز الحدود الضيقة للديمقراطية الليبرالية، التى قد يؤدى إعمالها كمرجعية وحيدة للحضارة الإنسانية إلى تخريب السلم العالمى وإشعال حرائق غير محدودة.
أما النسق الثالث فهو السوق الرأسمالي المعولم فى عصر ما بعد الصناعة، الذى شهد انعكاسا جذريا فى العلاقة بين النظامين: التكنولوجى/ الاقتصادى، والأخلاقى/ الاجتماعى. ففي عصور طويلة مضت كانت الحاجة هى أم الاختراع، أى أن الفن الإنتاجي كان يقوم على تلبية حاجات إنسانية قائمة فعلا، وملحة أيضا. لكن ومع التقدم التكنولوجيا المطرد صار الاختراع هو أبو الحاجة، القادر على توليدها وتنميتها في الوعى عبر الإلحاح بشتى الصور حتى تستحيل مكونا أساسيا في حياة الإنسان، وعندها يهرب الاختراع إلى ابتكارات جديدة، وممارسة إلحاح أشد محولا إياها إلى حاجات فعلية جديدة، وهكذا يتم تطويع الإنسان واستلابه فى المجتمع المعاصر الذى يصير تدريجيا أسيرا لأزمة معنى هائلة، تكاد تجسد إقطاعا روحيا، نحتاج معها إلى استعادة بعض السحر القديم إلى داخل عالمنا الذى صار جافا سواء بعقلانيته الآداتية أو فوضويته الزاعقة.
وعلى هذا يتوجب محاكمة هذا السوق، ومساءلة ادعاءاته بالعمل وفق آليات لا شخصية ولا أخلاقية. قديما تحدث آدم سميث عن اليد الخفية للسوق الرأسمالى؛ باعتبارها آلية تصحيح تلقائى لتشوهات هذا السوق على أصعدة الإنتاج والتجارة وتوزيع الثروات بين الأمم، وهو فهم لم يكن صحيحا بالمطلق، أوقع العالم فى أزمات، على رأسها الكساد الكبير نهاية عشرينات القرن الماضى، حتى أتى ماينرد كينز مصححا تلك التشوهات عبر هندسة آليات جديدة دشنت مفهوم دولة الرفاهة، وأسهمت فى تعطيل المد الشيوعى داخل أوروبا، وأدت فيما بعد إلى إسقاط التجربة السوفيتية. ومنذ العقدين، تبدى خطاب العولمة كيد خفية جديدة، تنادى بالسوق الرأسمالى الكونى، المتجاوز لحدود الدول، المقتحم لسيادتها، باعتباره حكمة الزمن الجديد التى لم تساءل بعد، أو بالقدر الكافى على الأقل. ومن ثم لابد من إعادة طرح السؤال: هل العولمة المقتحم للبنى المجتمعية كافة، والاقتصادات المحلية جميعها، هى آلية حتمية للتطور الاقتصادى العالمى لا بديل أخلاقى لها، رغم كل التفاوت فى الدخول وفى فرص الحياة سواء بين الطبقات الداخل المجتمع الواحد أو بين المجتعمات وبعضها البعض، أم إن هناك بدائل أخرى أكثر جدلية بين الانفتاح العالمى والانغلاق القومى، تحقق قدرا معولا من العدالة وتتسم بقدر أكبر من الإنسانية ؟.
ومن ثم يرفض جاك ماريتان، الفيلسوف الوجودى الكاثوليكي، النزعة الليبرالية المتطرفة، مؤكدا أن أحد أخطاء التفاؤل بالفردية يكمن فى الاعتقاد بأن (الحق) في المجتمع الحر إنما يصدر تلقائياً عن التنازع بين القوى والآراء الفردية التي يُفترض فيها الحصانة ضد أي اتجاه لا يطابق العقل، أو أى ضغط يؤدي إلى التفكك. وموضع الخطأ هنا هو تصور المجتمع الحر شبيهاً بحلقة الملاكمة التي يتوافر فيها (الحياد) التام، فيكون حلقة تلتقي فيها كل الآراء الممكنة عن المجتمع وقواعد الحياة الاجتماعية، وتتصارع في سبيل الفوز، دون أن تقوم السلطة السياسية برعاية أي ظروف مشتركة أو وحي عام. وهو أمر يفقد المجتمع الديمقراطي (الصورة الذهنية) الخاصة به، ويجعل الحرية نفسها مشلولة أمام هجوم أعدائها؛ الذين حاولوا بكل الوسائل أن يثيروا في الناس رغبة دنيئة في التحرر منها.
وإذا كان طرح تلك الأسئلة انطلاقا من اعتبارات عملية: اقتصادية، ومالية، وتجارية، أمرا واجبا، فالواجب الأكبر يقع على عاتق الأديان فى طرح أسئلتها الخاصة جدا ولكن الإنسانية تماما، حول العلاقة بين الثروة والأخلاق، وبين التقدم والأخلاق، وبين السعادة والأخلاق، لإضافة آفاق جديدة وأبعاد روحية للمسيرة الإنسانية، التى لا يكفى لسلامتها واستقرارها التزامها بالآفاق العملية والأبعاد المادية وحدها؛ ذلك أن الشراكة الإنسانية لم تكن من الوضوح فى زمن من الأزمان قدر وضوحها اليوم، حيث استحال العالم قرية كونية بحق، يتشارك الجميع مسئولية إدارتها والحفاظ على سلامتها من الأنواء العاصفة والمطامع الهدامة. ورغم أن مثل هذا الخطاب المؤنسن قد انطلق بالفعل تحت لافتات مختلفة لعل آخرها الفلسفات البيئية، التى يعقد فى ظلها قمة مثل المناخ مثلا؛ باعتبار أن البيئة هى المشترك الأهم بين سكان الكوكب- فإن إسهام الأديان، بما لها من تأثير نافذ عميق، فى بلورة مدونة أخلاقية مشتركة ترسخ معنى الاستخلاف الإلهي للإنسان، لا يمثل فقط إضافة كمية لهذه الخطابات، بل إضافة نوعية شديدة العمق والفعالية، تثرى مسيرة الإنسانية نحو الخير الكونى، وتنمو فى سياقها قدرة الدين نفسه على تلبية حاجات العصر.