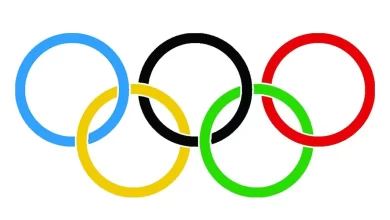فرضية تاريخية:
من المؤكد تاريخيًّا أنَّ الحركات (الأدبية والفنية والفكرية) الكبرى، دائمًا ما كانت تترتب على أحداث كارثية ضخمة مثل الحروب الجزئية بين بلد وبلد آخر، أو كونية مثلما حدث في الحرب العالمية الأولى ( 1914 – 1918) م، والحرب العالمية الثانية (1939 – 1945) م، أو حرب الإبادة مثلما حدث مع (الأرمن) في تركيا، أو مع (الأكراد) في العراق، كذلك كافة أنواع الوباء التي تتفشى في المجتمعات كلها، وأشهرها (الكوليرا والطاعون)، ساعتئذٍ – يشعر الفرد والجماعة في وقتٍ واحد، أنَّ العالم يضيق وتختلف علاقات الناس ببعضهم البعض، ويلعب الحذر أدوارًا كثيرة، ذلك الحذر الذي يتحول إلى وباء آخر، فتتغير كل الخطط والاحتياطات وأشكال الخوف، وأشكال الوقاية، والأوقات التي يظهر فيها الناس ويختفون ولا أريد أن أستدعي نصوصًا أدبية جاءت من مساحة التأثر بالوباء، ولكنني أستدعي بعضًا من ذلك الفزع الذي يصيب كثيرًا من الناس في تلك الحالات الكارثية من أثر الوباء، بعيدًا عن الروايات الكبرى التي كتبها مبدعون عالميون من طراز (ألبير كامي) في (الطاعون)، أو (الحب في زمن الكوليرا) لـ(جارثيا ماركيز)، أو (اليوم السادس) لـ(أندريه شديد)… وغيرهم، ولكن هناك بعض القصص القصيرة والقصائد استطاعت أن ترصد ذلك الأثر الإنساني الذي يسببه الوباء، ولكن الأدهى من ذلك أنَّ النصوص الأدبية التي يكتبها مبدعون، تصبح علامة في
تاريخ الجنس الأدبي الذي يخوض غمار الإبداع متأثرًا بالوباء، أى أنَّ الوباء يُحدث حالة من التغيير الجذري أو النسبي الملحوظ في تغيير وتجديد مسار الكُتَّاب، أي أنَّ هناك ارتباطات شبه شرطية بين النصوص التي تكتب بعد حدوث الوباء، وبين التجديد والتغيير والتحديث الذي يصل إلى حد الانقلاب.
ونستطيع أن ندرك ذلك بقوة في قصيدة (الكوليرا)، التي كتبتها الشاعرة العراقية (نازك الملائكة) بعدما ضرب الوباء القاهرة وكافة أنحاء مصر عام 1947 م، ونشرت نازك القصيدة في الوقت نفسه، ورصدت فيها بشكلٍ شعري جديد تمامًا على مسار الشعر العربي، كما أنَّها جسَّدت المأساة في حيز فني ولغوي وأدبي بسيط، تقول نازك:
“سكن الليل
اصغ إلى وَقْع صَدَى الأنَّات،
فى عُمْق الظلمةِ، تحت الصمتِ، على الأموات
صرخاتٌ تعلو، تضطربُ
حزنٌ يتدفقُ، يلتهبُ
يتعثَّر فيه صَدى الآهات
فى كل فؤاد غليان
فى الكوخِ الساكنِ أحزانُ
فى كل مكانٍ روحٌ تصرخ في الظلمات
فى كل مكان يبكي صوت
هذا ما قد مزّقه الموت
الموت الموت الموت”([1])
من ثَمَّ، فإنَّ التجديد في (الأدب، أو الفكر، أو الفن)، له علاقة قوية بأحداث كبرى، وكثيرًا ما تكون الأحداث مقرونة بالكارثية أو التعاسة؛ لأن الكارثة تضرب المجتمعات والإنسان عمومًا، أكثر مما تؤثر فيه الانتصارات الكبرى، حتى الانتصارات نفسها، تأتي بعد سلسلة من الكوارث والإحباطات الكبيرة، مثل الثورة الفرنسية في (أواخر القرن الثامن عشر)، أو الثورة الروسية عام 1917 م، والتي جاءت بعد مجموعة أحداث كارثية كبيرة، وكانت ثورة 1905 م ، دليلًا على أنَّ الانتصار مازال بعيدًا.
نأتي بنموذج آخر ارتبط كذلك بالتغيير والتجديد والإحداثات الفنية النوعية، هذا النموذج يتجسد في قصة (الوباء) للكاتب القصصي (يوسف الشاروني)، تلك القصة التي كتبت بالتأثر من وباء (الكوليرا) أيضًا، والذي ضرب مصر عام 1947 م – كما أسلفنا- ونشرت القصة في مجموعته الأولى في (أغسطس عام 1954)، وفي القصة يرصد (الشاروني) كافة الإجراءات الطارئة التي بدأت تتخذ من المسؤولين في الدولة، أو من الناس عمومًا، وفي الصباح قيل لتلاميذ المدارس أن يعودوا إلى منازلهم.. وصدر أمر بإغلاق الأسواق، فحملت كل فلاحة دجاجاتها، وشدَّ الفلاحون رباط بهائمهم الهزيلة المعروضة للبيع، وأقفل الجميع إلى قراهم، وكف المثقفون عن جدالهم حول معنى الحياة وعدلوا عن رغبتهم في الموت، وتملكهم تشبث مجنون بالأرض، وانفضَّت الموالد، وسارعت الحكومة إلى منع الاجتماعات العامة، وخلت دور السينما من روادها، وأقفلت المطاعم والمقاهي، وأغلقت الحمامات ومحال بيع البوظة، وأصبح كل فرد ما بين يأسٍ وأمل، يأسْ (أن يصيبه المرض هو دون باقي الناس)، وأمل (أن يصيب الباقي دونه)، ورأى بعض المتدينين أنَّه: ” أمر أعمار في لوح القدر..ليس الوباء سوى وسيلة إليها” ([2]).
وكما حدث لقصيدة (الكوليرا)، التي تركت أثرًا بالغًا في شكل التعبير الشعري فيما بعد، حدث لقصة (الوباء) لـ(يوسف الشاروني)، أنَّ مسار القصة فيما بعد تأثَّر كثيرًا بالشكل التعبيري الذي أتى به (يوسف الشاروني)، إذ كانت القصة فيما قبل – أو في الغالب – تهتم (بالعام والمجازي) دون التفاصيل، ونجد أنَّ (الشاروني) في هذه القصة – على وجه الخصوص – يتقصّى التفاصيل بشكلٍ لم يكن معمولًا به فنيًّا من قبل، فضلًا عن سرعة إيقاع القصة ذاتها؛ وذلك لأنَّ تسارُع الأحداث وغزارتها تم فرضهما على أجواء السرد كلها، وهناك مايُقال ويُحكى ويبلغ عنه، لا مجال لأي لغة (مقعَّرة أو رومانتيكية أو مخملية)، القاصُّ منذ ذلك الوقت بدأ ينتبه لذلك الإيقاع السريع والموحي والحاد في وضوحه – دون أي لف أو دوران – أو دون أي تنميق، الكاتب مجبر على رصد التفاصيل كما تَحدث. الأحداث المتسارعة لا تترك أي مجال لافتراضات متخيلة، فالأحداث وسرعة إيقاعها هي سيدة الموقف.
وإذا كان هذا هو الجانب الفني الذي أتت به قصة (الشاروني)، فهناك ذكاء إبداعي آخر برز في تلك القصة، حيث أنَّ الكاتب وصف الجوّ الذي نشب أظافره في قطاع واسع من البشر، يكاد يكون هذا الجوّ هو الذي يحدث دومًا عندما تبدأ خُطى الوباء الثقيلة تدبُّ في قلب الحياة، (إغلاق كل المعالم القديمة، واتخاذ احتياطات أخرى بديلة)، وتبدأ الحياة في إنتاج شكل علاقات جديدة تمامًا (لا مدارس، ولا مطاعم، ولا اجتماعات في النوادي)، انتهت تمامًا حياة الترف وعلى الجميع أن ينتبه، دقّات الخطر تُعلن عن حياة أخرى كانت مختبئة، والمتدينون تَخرج فتاواهم المتفاوتة في فحواها، هناك من يعتبر ماحدث أنَّه نقمة من الله؛ لأن الناس ابتعدوا عنه، وبدأوا في ترك الصلاة والصوم وبقية أنواع العبادة، ولا حل إلَّا الرجوع إلى الله، واتباع تعليمات كتابه المقدس.
أزعم أنَّ ذلك الذي أتى به (الشاروني) في قصته القصيرة، ما هو إلَّا التلخيص المكثف لما حدث، ولما يحدث في أي زمان ومكان، مع اختلاف التفاصيل بين بيئة وأخرى، وبين زمنٍ وزمن مختلف.
وإذا كانت (نازك الملائكة)، و(يوسف الشاروني)، قد وصفا الجو المرعب الذي ساد البلاد في ذلك الوقت، لكن هناك دائمًا الشباب الذي يتطوع لمواجهة ذلك الرعب، ومحاولة تنظيم الحياة وفقًا لما يحدث، وتخفيفًا من الأعباء التي تقع على مصائر الناس، وهناك أغراض مختلفة تكون الدافع الأساسي لتطوع هؤلاء الشباب، من الممكن أن يكون الدافع دينيًا، كمحاولة لهداية الناس، وإقناعهم أنَّ العودة إلى الله هي الحل الوحيد للقضاء على الوباء، ومن المؤكد أنَّ نزوع فئة من الناس لفعل الخير قد تكمن في الدوافع الرئيسية لشبابٍ كثيرين، وهناك كذلك بعض الدوافع السياسية التي تدفع شبابًا كثيرين لاستقطاب الناس كمؤيدين لهم ولتياراتهم السياسية، ومن ثَمَّ نقرأ في سيرة د. (فخرى لبيب اليساري)، يقول في سيرته الذاتية عن ماحدث في (سبتمبر 1947 م)، وماقام به الشباب للمواجهة: ” نشرت مجلة الجماهير الإرشادات الواجب اتباعها للوقاية من المرض، كان الزملاء الأطباء قد أمدّونا بالإجراءات اللازمة عند دخول منازل المصابين، وطلب الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات وتطهير المكان، وتزويد باقي الأهل بضرورات الوقاية، غسل كل ما يدخل الجوف بمحلول (برمنجنات البوتاسيوم) واستخدام الليمون، والغسيل المتواصل تحت الصنبور، وغلي الأكل وتسخين الخبز على النار، وحثّ الناس على ضرورة التطعيم”.([3])
في النصوص الثلاث التي اقتبسنا منها بعض الفقرات، نُدرك أنَّ ثمة تغيرات جوهرية قد أصابت الناس فعلًا، وتبدلت الخطط والتدابير والمحاذير والإجراءات بشكلٍ شبه كامل. الناس دائما هم الناس، لا يتغيرون، حتى في إدراكهم المتدرج للوباء هم شبه متشابهين، فلا يتم اكتشاف الوباء ومقاومته واتخاذ كافة التدابير الوقائية والعلاجية، إلَّا بعد فترة (تطول أو تقصر) من تغلغل الوباء، وبالطبع لم يكن وباء الكورونا مختلفًا عن ذلك، إلَّا في توسعه وانتشاره بشكلٍ كوني، وشديد الوطأة، مع تعقد المجتمعات، واختلاط كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بعضها ببعض.
كوفيد – 19:
ومنذ أن تمكن فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وفرض هيمنته على البشرية رويدًا رويدًا، وأعلن حربًا حقيقية – لا هوادة فيها- وشبه منظمة في كافة أركان المعمورة، أخذ الفزع كذلك ينمو رويدًا رويدًا، وكانت بلادنا العربية على وجه الخصوص تتعامل مع الفيروس بقدرٍ واضحٍ من الخفَّة والتفكه بدرجات متفاوتة، وكانت هذه الخفَّة تتبدَّى في النكات المتداولة، و (الإفيهات) التي انتشرت وشاعت بين الناس، وصُودِف أنَّ نوعًا من (الشيكولا) كان يحمل اسم (كورونا)، ولهذا التشابه كان البعض يتفكه بقول “إحنا إللى أكلنا الكورونا”، و”الكورونا جاءت هنا وانتحرت”، كما أنَّ كثيرًا من بعض الفنانين المغمورين راحوا ينشرون فيديوهات تحمل أغنيات من طراز (يابا يابا ع الكورونا .. يابا يابا ع الكورونا)، وانتشرت هذه الأغنية الشعبية البسيطة، والتي كانت تتقاطع مع لحن معروف لأغنية شعبية مشهورة، كهذه النماذج وغيرها كانت نوعًا عشوائيًّا من التعبير، ونوعًا من المواجهة البدائية، وساعدت مواقع التواصل الاجتماعي في نشر كثيرٍ من تلك الفيديوهات، فضلًا عن تلك الفيديوهات التي كانت تتحدث باسم الفيروس نفسه، كل هذه الأشكال التعبيرية الأولية، لم تكن إلَّا النماذج الأولى من المقاومة، والتي اتخذ بعضها نوعًا من التحذيرات التي انتشرت بشكلٍ ما، وذلك بعدما انتشر شعار (خليك في البيت)، وتمَّ التنويع والعزف على ذلك الشعار بأشكالٍ مختلفة، وجدير بالذكر أنَّ هذا الشعار كان يتحول إلى قصص وقصائد بدائية، تستند إلى روح تهكمية أحيانًا، وتتكئ على روح فكاهية في أحيانٍ أخرى، كل ذلك قبل أن يتخذ الفيروس طريقًا شرسًا جديدًا وضع البشرية كلها أمام تحديات جد جديدة وقوية، وهذا الوضع لخَّصه (شيكسبير) في صرخته القديمة حول أحداث أخرى (نكون أو لا نكون).
وبالتالي كانت هذه هي التجليات الفنيّة الأولى في بلادنا خفيفة الظل، والتي راحت تنتشر رويدًا رويدًا بين الناس، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكانت تحمل بعضًا من اتخاذ مسارات أخرى من السلوك والعلاقات، بعد أن صك مصطلح (التباعد الاجتماعي)، رغم أنَّ البعض اعترض على دقة المصطلح، وقيل أنَّ البشرية تحتاج إلى تقارب اجتماعي، وليس تباعدًا اجتماعيًّا، ولكن التعبير الأدق أن نقول (التباعد الجسدي)، وهذا ماحدث بالفعل، أي أنَّ التعاطف والتكاتف الذي نشأ بين الناس في تلك الآونة، ماهو إلَّا التطبيق الحرفي الأقصى لذلك التقارب الاجتماعي الذي كان مفقودًا، خاصةً أنَّ الشعب الإيطالي الذي تجرَّع الكأس المريرة الأولى في العالم، كان المصابون منه يرسلون أغانيهم من النوافذ عن بعد، كانوا يبدعون ما لم يبدعوه من قبل. أعتقد أنَّ البشرية قد تعلَّمت ألحانًا جديدة، ولم تعزف من قبل بهذه الكثافة وبذلك التكاتف، وبالتأكيد أنَّ هناك قصصًا كثيرة لم يكتبها الأدباء بعد، قد حدثت في ذلك الوقت الذي كان فيروس (الكورونا) ينصب الفخاخ الكارثية للبشرية، فخًّا بعد آخر، وكان البشر في جميع (طبقاتهم وفئاتهم وأعمارهم ووظائفهم وأماكنهم وأجناسهم)، يقاومون بأسلحة مختلفة، وبقدر من المعارف المتنوعة، وكان رجال الدين بدورهم يرسلون مواعظهم عبر كل أشكال التواصل المختلفة.
مؤتمرات وندوات إلكترونية:
منذ أن اشتد صراخ كورونا في (مارس 2020 م)، راحت المؤسسات الثقافية والفكرية والسياسية تغلق أبوابها واحدًا بعد الآخر، وإن كانت الحكومات قد تأخرت نسبيًّا في فرض ذلك الإغلاق، راحت تلك المؤسسات من تلقاء نفسها تغلق أبوابها، وتعلَّق أنشطتها، ولذلك بدأت ظاهرة جديدة تنشأ وتنتشر وتنمو بشكلٍ فعَّال، وهي ندوات ومؤتمرات (الزوم والأونلاين)، وربما انبثقت هذه الظاهرة؛ بسبب تفشي فيروس (الكورونا)، رغم أن ضرورة هذا النوع من المؤتمرات والندوات كانت ملّحة من قبل اجتياح (الكورونا) عالمنا، ولكن وجود (الكورونا) عمل على التعجيل بصناعة تلك المؤتمرات والندوات والملتقيات الإلكترونية على مستويات عديدة، وفي مجالات كثيرة، مجالات سياسية وفنية وثقافية واقتصادية وخلافه، مؤتمرات تبدأ من رؤساء دول، ورؤساء وزارات، إلى شعراء ونقاد وكُتَّاب قصة، وأصبحت سمة العلاقات الافتراضية الإلكترونية هى الأكثر فعالية، حتى لجان التحكيم في النصوص الفكرية والأدبية والفنية أصبحت إلكترونية، كما أنَّ المؤسسات الثقافية بدأت تمارس أنشطتها عبر الوسيط الإلكتروني، وراح الأدباء والشعراء والمفكرون والباحثون يسجّلون نصوصهم، ويقرأونها بأصواتهم، ويرسلونها إلى المختصين في تلك المؤسسات، حتى يعاد بثها عبر مواعيد أصبحت معروفة ومعتادة لدى المتلقين، حدث هذا في جميع أنحاء العالم؛ ليصبح وسيلة وحلًّا حتى تنزاح تلك الغمة، وربما تستمر هذه الوسائل حتى بعد زوال خطر (الكورونا)، وبعد الطرق الاحترافية التي تعرَّفت عليها البشرية، وأبدعت في تطويرها.
الصالونات الأدبية والثقافية:
ومما لا شك فيه، أنَّ ظاهرة الندوات والمؤتمرات الإلكترونية التي أسّست لها المؤسسات الثقافية الرسمية الكبرى في العالم، لم تستطع أن تشمل كافة أغراض وأهداف وأذواق وتوجهات المثقفين عمومًا، فبالطبع أنَّ المؤسسات لن تتخلى عن توجهاتها المؤسساتية حتى لو تغيَّرت وسيلة الإرسال والبث والتثقيف، هنا نستطيع أن نقول بأنَّ الشكل هو الذي اختلف، ولكن الجوهر والمضمون مازالا قائمين، لذلك راح كثير من المثقفين المرموقين وغير المرموقين – والذين كانوا فاعلين منهم أو غير فاعلين – في تأسيس صالونات ثقافية وفكرية وأدبية وفنيّة، وراح كل صالون ينفّذ أفكاره وخططه الخاصة به على أكمل وجه، وبالطبع فهذه الطريقة من الممكن ألَّا تتسق مع روح كافة المثقفين، ولكنها طريقة أخذت في الانتشار، وستظل مستمرة – كما أعتُقد- بعد زوال خطر الوباء، وهذا الاستمرار له أسبابه البسيطة والتي لا تحتاج لأي جهد في اكتشافها، وهي ببساطة توفّر المجهود الذي كان يبذله المؤتمرون المشاركون في الفعاليات، كذلك لن يتكبد المتابعون مشقة الذهاب والإياب إلى أماكن من الممكن أن تكون بعيدة، ومكلفة من زوايا عديدة، فضلًا عن التجهيزات المؤتمرية التي تبذلها المؤسسات والأفراد المكلفة، لذلك فإنَّ الصالونات التي تم تأسيسها عبر أفراد سوف تواصل عملها بعد زوال خطر الفيروس، خاصةً أنَّ عددًا لا بأس به من تلك الصالونات، بدأ يحقق نسبة مشاهدات عالية، ونسبة متابعين كبيرة، وربما في المستقبل القريب نقرأ تغطيات صحفية لفعاليات تلك الصالونات.
ولا أستطيع أن أؤكد بأنَّ تلك المؤتمرات والصالونات والملتقيات الإلكترونية، قد حلّت تماما محلّ المؤتمرات بشكلها القديم؛ لأنَّ هذا الشكل الجديد من الفعاليات، والذي فرضه وضع كارثي بدا مؤقتًا، يفتقد إلى الحميمية والحوارات الحيَّة التي كانت تحدث في المؤتمرات، ويظلّ الأمر معروضًا على الشاشة – كما كان يحدث على شاشات التلفزيون. المؤتمرات في شكلها قبل (الكورونا) كانت أكثر فعالية، هناك منصَّات وهناك حضور يريد أن يشتبك، ويطرح أفكاره واعتراضاته وجهًا لوجه، وهذا ما لم يتوفر في تلك الفعاليات الإلكترونية، ولا أستبعد في أنَّ هذا الشكل من الفعاليات، سوف يؤثر في توجهات الأفكار نفسها، مثلما حدث مع الصحافة فيما قبل.
خسارات الناشرين:
حتى الآن لم تفصح اتحادات الناشرين على مستوى العالم بالأرقام الفعلية لأعداد الكتب التي نُشرت في العام الذي انصرم، ولكن ركود الحياة في كافة مناحيها (الثقافية والفكرية والأدبية)، جعل كذلك الكُتَّاب كسلعة شبه راكدة، وبالتالي انخفضت مستويات النشر بشكلٍ مذهل، كما أنَّ إلغاء المعارض وتأجيلها أو إقامتها تحت شروط قاسية، دفع الناشرين لتقليص عمليات النشر بشكلٍ كبير، فالنشر أصبح موضوعًا لمغامرة ليست مجهولة العواقب، ولكنها مغامرة خاسرة بكل تأكيد، فلا بيع ولا شراء ولا معارض ولا إقامة أي أسواق للكتب، من ثَمَّ خسر الناشر والمؤلف والقارئ على حدٍ سواء، وأصبحت نسبة ضئيلة جدًا من الكتب هي التي تنشر، تلك الكتب التي تلبي حاجات أكيدة لدى القراء، أي مضمونة البيع، وبالتالي لن يغامر الناشر الخاص مع أي مؤلفين جدد، أو مع مؤلفين ليسوا منتشرين، وليسوا مضمونين في رواج كتبهم، وأصبح الناشرون ينتظرون فتح المعارض لتسويق كتبهم، وتسيير تلك الحركة التي أصابها ركود كبيرعلى مستوى العالم، في ظل تعوّد القارئ الجديد – والذي تجددت صناعته بعد (الكورونا) – على قراءة الكتب إلكترونيًّا، مما يجعل مهنة النشر مهددة بالزوال في المستقبل القريب.
مستقبل الكتابة:
هذه هى أحوال الثقافة والأدب والفكر والفن باختصار وتكثيف شديد، وإن كان الأمر كان يحتاج إلى مسار آخر في نوع الكتابات الأدبية والفكرية والثقافية، التي تم إبداعها، أو مازالت قيد مدونات مؤجلة، هل أصابت تلك الكتابة حالات من الحزن والتشاؤم، أو سوف تنتابها حالات من التفاؤل بعد زوال خطر (الكورونا)؟، هل ستكون الكتابة سهلة على الجميع، أم ستظل حكرًا على عدد محدود من الناس يسمّون (أدباء)، أو (أهل الفكر والثقافة)؟.
أعتقد أنَّ انفتاح الأفق ، وأصبح جميع الناس مشاركين في الألم ، فبالتالي سيكون الجميع أيضًا مشاركين في شكل ووسائل التعبير، خاصةً مع توافر أدوات النشر الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك فالبشرية مقبلة على سيل من الكتابات المفتوحة على تجارب جد واسعة، خاصةً أنَّ بعضًا من هذه الكتابات راح يحقق رواجًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، ولا تكهنات تصلح الآن إلَّا بعد انقشاع تلك الغمة، حتى يستطيع الجميع أن يكتبوا تحت مظلات شبه آمنة، ولا نملك سوى الانتظار.
([1]) نازك الملائكة، ديوان نازك الملائكة، الجزء الأول، المجلس الأعلى للثقافة، 2002 م، ص 204
([2]) يوسف الشاروني، الأعمال الكاملة الإبداعية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1993 م، ص 123
([3]) دكتور فخرى لبيب، المشوار، مكتبة مدبولي، 2008 م، ص318